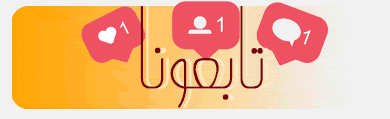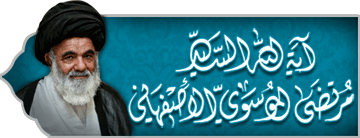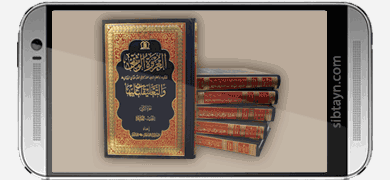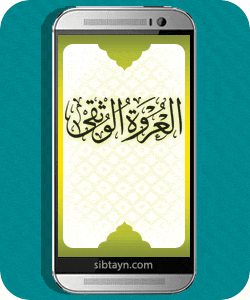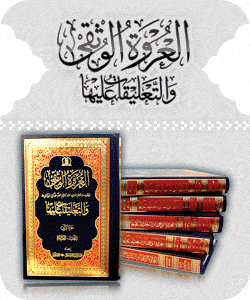الإلزام
بين الإلزام والالتزام
الفرق بين الالزام والالتزام أن الإلزام يكون من سلطة عليا تأمر وتنهى، ولا رادّ لأمرها ونهيها لأنه حق وعدل، وهي أيضاً تمدح وتوبخ، تراقب وتحاسب المنحرفين في سلوكهم عن الصراع القويم، أما الالتزام فهو التقيد والتعبد بهذا الواجب والإلزام حتى ولو خالف ميول الملتزم وتقاليد أهله ومجتمعه، وبكلمة أن الالتزام يشبه إلى حد بعيد السير على قضبان من حديد تُعين للملتزم الطريق الذي يسير عليه تماماً كسير القطار، ومن الإلزام والالتزام يتألف مفهوم النظام، ومن تمرد على الإلزام والواجب فقد خرج عن النظام العادل.
ولا غنى عن مبدأ الإلزام والالتزام لأية أسرة أو جماعة تعيش حياة مشتركة، فهو العهد والميثاق الذي يضمن بقاءها، ويصونها من الفوضى والانحلال، بل هو الأساس الاول للأديان والشرائع والقوانين والمذاهب الأخلاقية وغير الأخلاقية. وقرأت في الصحف من جملة ما قرأت، كلمة تغني عن كتاب في هذا الباب، وهي:
((الشر كل الشر ينبع من اللامبالاة والسلبية، والتخلي عن التبعة، والشعور بالمسئولية. ان جحود الإلزام والالتزام قضاء على وجود الإنسان، بل هو بمثابة الجحود لأصل الوجود)).
والسر الأول والأخير لذلك أن الحياة المشتركة لن تستقيم بحال إلا إذا عاش جميع أفرادها على مستوى واحد في الحقوق والواجبات وإلا اختفى النظام، وشاعت الفوضى والاضطراب والانحلال، وسادت شريعة الغاب والفساد والضلال.
وايضاً قرأت في بعض الصحف أن لصوصاً سطوا واغتنموا، وعند القسمة أجحف رئيسهم واستأثر، فثاروا عليه وطالبوه بالالتزام بالحق والعدل في قسمة الحرام!.. وان دل هذا التناقض على شيء فانه يدل أن واجب الحق والالتزام به يحمل طابع فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل الناس، حتى المعتدين على ما هو الحق والعدل وإلا فبأي شيء نفسر مطالبة اللصوص بقسمة الحرام بالعدل؟. ثم هل من أحد يقبل عن رضا وطيب نفس أن يوصم باللصوصية والخيانة؟ اللهم إلا أن يكون وحشاً ضارياً في جسم إنسان.
بين العقل والوجدان
الدين ـ من حيث هو ـ انقياد والتزام باشياء مفروضة من سلطة عليا، والعقل النظري انتقالٌ من معلوم إلى مجهول، ومن شاهد إلى غائب، أما الضمير الحيّ فهو أن تحب الخير والفضيلة من حيث هما أي حتى من عدوك، وأن تكره الشر والرذيلة حتى من نفسك، وأن تشارك الناس في مشاعرهم وآلامهم، فيخفق قلبك لكل مظلوم وبائس في شرق الأرض وغربها على أن ينبغ هذا الشعور من اعماقك لا من خطبة حماسية أو في غمرة جماهيرية. وبكلمة أن الضمير الخالص
نور فطري يريك الحقيقة مباشرة بلا أقيسة ومقدمات. وكثيراً ما تطلق على الضمير والوجدان كلمة الذات الخلقية والأخلاق الإنسانية أو الأدبية، وقانون القلب وما أشبه.
ولا يعيش الضمير في عزلة عن العقل، بل هناك تشابك عضوي بينهما ولونٌ من الوحدة والاتساق، وبهما معاً تكمل وتتم شخصية الإنسان ويمتاز عن الحيوان وسائر المخلوقات. أجل قد يخفق قلب الحيوان بالعاطفة كالأنثى تحافظ على وليدها، ولكن الحيوان يقف عند هذا الحد، ولا يتجاوزه إلى التراحم والتعاون والمحبة والتسامح، وما إلى ذلك من المثالية والمشاركة الوجدانية.. وإذا كان الإنسان اجتماعياً بالطبع فهو مضطر لأن يكون غيرياً بالطبع لأن المفهوم الاجتماعي لا ينفصل عن الغيرية بحال.
ومما لا شك فيه أن الناس على مستويات مختلفة في العقل ودرجات متفاوتة، ومثله تماماً الوجدان، ويتفاوت بين إنسان وإنسان: هذا يرى الحب والأخوة والعدل والمساواة خيراً وأفضل ما في الوجود، وذاك لا يعرف من الحب والعدل إلا بمقدار ما يتصل بنفسه وذويه، وثالث يحقد على الإنسانية جمعاء، وينبح على كل فاضل وكامل!. وينشأ هذا الحقد والعواء ـ في الغالب ـ عند العاجز عن مواجهة الحياة. وإلى هذه الحقيقة أومأ الإمام أمير المؤمنين(ع) بقوله: ((العجز آفة.. الغيبة جهد العاجز)).
مصدر الإلزام
وبعد التمهيد بما تقدم نشير أن العنصر الأول والأساس من العناصر الخمسة للخير والفضيلة هو الواجب والإلزام بالمعنى الذي أوضحناه في فقرة بين الالزام والالتزام من هذا الفصل، أما المصدر الذي يشتق منه هذا الإلزام فهو عبارة عن منظومة من نداءات ثلاثة(1): نداء العقل الخالص الكلي الذي لا يُنسب إلى أي فرد كان أو أية جماعة تكون لأن هذا العقل يتلون ويتأثر بما يحيط به والمراد العقل الكلي كما خلقه الله، وخاطبه بقوله: ما خلقت خلقاً أشرف منك(2)، نداء الفطرة النقية(3)، نداء الوحي الإلهي، فالعقل المتحرر من كل ضغط وقيد يميز بين الخير والشر، ويوجه إلى الإنسان أوامره بأن يفعل أو لا يفعل، والفطرة الإنسانية بما هي وكما خلقها الله سبحانه تحب الخير وتأمر به، وتكره الشر وتنهى عنه، وكثيراً ما يعبر عنها بالضمير الوازع الذي يردع الإنسان عن ممارسة السوء، وبأسلوب آخر أن الفطرة هي التي تصدر عنها ميول إنسانية محض منزهة عن كل شائبة ومنفعة ومجردة عن كل تأثير وتقليد بحيث لا يمكن تعليل هذه الميول إلا بالوجدان الخالص والفطرة الصافية، ومثاله أن يسمع الإنسان كلاماً فيتجاوب معه بقلبه ونفسه وعقله.
أما دين الله القيم فأحكامه وبيانه لطف ورفق بعباده، وتأييد وتسديد لمنطق العقل ومحكمة الضمير، ومعنى هذا أنه بحكم العقل والضمير يُستدل على حكم الوحي، وبحكم الوحي يستدل على حكم العقل والضمير.
وكل هذه القوى الهادية الكامنة في داخل الإنسان من العقل والضمير والإيمان تزيد من احساسه بالخير والعدل وشتى انواع الفضيلة، وتنمي فيه روح الاستقامة على النهج القويم، وتدفع به إلى العمل لدُنياً أفضل حتى كأنه يعيش أبداً ولآخرة أكمل كأنه يموت غداً.
وبعد، فان تركيز الواجب الإلهي الإنساني والإلزام الأدبي الخلقي على هذه الأثافي الثلاث نداء الله والعقل والضمير(1) هو تمكين وتأصيل لحياة وادعة عادلة ومعيشة راضية عالية دنيا وآخرة.. ولا أدري هل عرفت الإنسانية ديناً أو شرعاً أو نظاماً ـ غير الإسلام ـ جمع بين هذه الدعائم الثلاث كأصل وأساس لكل قاعدة أخلاقية وحكمة واعظة نافعة؟. ومن المؤلم والمؤسف أن يجهل الكثير منا هذا الجانب من عظمة الإسلام في منهجه وشريعته وشتى تعاليمه.
ولو أن جماعة من أهل الفكر والاختصاص قارنوا بين ما عليه المسلمون اليوم وبين جوهر الاسلام وأهدافه ـ لنصحوا وقرروا أن نعتنق الإسلام من جديد.. وكفى دليلاً على هذه الحقيقة قوله تعالى: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) (47 ـ الروم) وقوله: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (8 ـ المنافقون). ومن المعلوم بالعيان والبديهة أنه لا عز ولا نصر اليوم للمسلمين في أية بقعة من هذا الكوكب، ولو كانوا مؤمنين حقاً وصدقاً لوفى سبحانه بعهده ووعده تماماً كما فعل من قبل مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات: (ومن أوفى بعهده من الله) (111 ـ التوبة).
الإلزام وسيلة لا غاية
ولا بد من الإشارة إلى أن نظرية الإلزام هي معيار مطلق يعم ويشمل الالزام بكل خير دون استثناء، ويخاطب جميع الناس في كل زمان ومكان، وعليه فمن يفعل الخير لوجه الخير بفطرته دون أن يتنبه إلى هذا الالزام ـ فقد أدى إليه طاعته، لأن الإلزام هنا وسيلة للعمل وليس غاية في نفسه. وتوصلي لا تعبدي على حد قول الفقهاء وعلماء الأصول. وبكلام آخر أن الإلزام قانون، ومن شأن القانون أن يضع القيود، ويرسم الحدود، فإذا التزم الإنسان تلقائياً بكل حد وقيد مع جهله أو غفلته عن القانون، فقد خرج عن العهدة والمسئولية، بل هو الأفضل والأكمل لأنه قد وضع القيود والحدود بنفسه لنفسه.
الإلزام الخلقي قانون طبيعي
في فقرة (بين علم الطبيعة وعلم الأخلاق) من فصل حول الأخلاق، أشرنا إلى التفرقة بين العلمين، ونشير هنا أولاً إلى التفرقة بين المراد بكلمة القوانين الطبيعية المادية وبين المراد بكلمة القانون الطبيعي بصورة عامة، ثم نشير إلى التفرقة بين هذا القانون والقانون الوضعي، ونثبت أن الإلزام الخلقي قانون طبيعي لا وضعي، والمراد بقوانين الطبيعة والمادة النظريات التي تُقرر وتُعبر عن شيء مرئي يمكن أن يكال أو يوزن أو يقاس بالشبر والمتر، وتناله يد الخبرة والتحليل في المختبرات، ويد الصناعة والزراعة في الحقول والمصانع.
أما القانون الطبيعي فيعم ويشمل كل ما هو حتمي الوجود ولا غنى عنه بحال مادياً كان كالطعام والشراب أم معنوياً كالحرية والعدالة وغيرهما مما تفرضه جبلة الإنسان وطبيعة العيش والحياة، وعليه فكل قانون ينطق بالعدل ويأمر به فهو قانون طبيعي(2) وإلهى وعقلي في آن واحد، هو طبيعي لأن العدل ثابت في ذاته وموجود في عالمه، ولا غنى عنه. قال أرسطو: العدل يشمل الفضائل بكاملها لأنه الخير العام للمجموع، والخير الخاص لكل فرد، وقال الإمام أمير المؤمنين(ع): ((العدل يضع الأمور موضعها، وهو سائس عام)) أي لا يستقيم شيء من الحياة إلا به، بل لا يستقيم الكون بما فيه ومن فيه إلا بالعدالة الإلهية.
وهو (أي القانون العادل) عقلي لأن العقل الخالص من العواطف والضغوط والمآرب، يأمر بالعدل والإحسان، وهو إلهي لأن الله سبحانه هو الحق والعدل وخالق الطبيعة والوجدان والعقل.
أما القانون الوضعي فهو الذي يصدر عن إرادة إنسانية سواء أكانت إرادة فرد واحد أم هيئة عامة أم سلطة دولية أم أهل الأرض كلهم أجمعين، أجل إذا كان الحكم الوضعي مستوحى من العدل وخاضعاً له ساغ أن نسميه عقلياً وشرعياً وإلا فهو بدعة وضلالة لأنه ضد الوحي والعقل والطبيعة والوجدان. ومما تقدم يتبين لنا أن الواجب الإنساني والالزام الخلقي هو قانون تكويني طبيعي يهيب بالإنسان إلى علم الخير، ومبدأ إلهي عقلي يُنذر ويحذر من الأنحراف إلى الشر.. وما أنكر من أنكر هذا الإلزام إلا لكي يتحرر من الخير والفضيلة، ويفلت من القيود والحدود وإلاّ رغبةً في الضياع والفوضى واشباع الغرائز الحيوانية.
ولكن الشيء الذي يُذهل ويحير: هل على وجه الأرض عاقل واحد لا يعير اهتماماً للصدق والأخلاص والعدل والمحبة والجود والأمانة والتعاطف والتراحم؟ وهل من إنسان بمعنى الكلمة لا يخفق قلبه لأنين الملهوفين ودموع المظلومين؟ وإذا كان كل ذلك وما إليه عبثاً وحماقة فبأي شيء نفسر خلجات النفس الإنسانية من أجل المستضعفين. والمشاريع الخيرية، والثورات ضد الظلم طلباً للعدل والحرية؟.
واخيراً هل كل إنسان يميل بفطرته إلى إطلاق العنان لأهوائه وفي سلوكه دون أي اهتمام واكتراث بالآخرين ودون أن يتحمل ما تجنيه يداه؟ وإذن ما الفرق بين الإنسان العاقل ووحش الغاب؟.
الدين والمرض النفسي
نشرت مجلة العربي الكويتية عدد آب 1974 مقالاً بعنوان المرض النفسي جاء فيه أن جماعة من كبار العلماء الغربيين وأهل الاختصاص بعلم النفس، درسوا ما ورد في الرسالات السماوية من حقائق وأفكار عن طبيعة الإنسان وتحليلها، فوجدوا فئة من الناس قد مات فيها الاحساس الإنساني والضمير الخلقي، فلا تشعر بذنب، ولا تؤوب إلى رشد مهما اقترفت من كبائر وجرائم، وفئة ثانية لديها ضمير خلقي، ولكنه ضعيف مريض لا يقوى على مقاومة الرذيلة والارتداع عنها في صورة ناجحة مثمرة، فيرتكب صاحبه الخطيئة، ثم يندم، وقد يكفّر عن جرمه وجريرته ببعض الصالحات.
وانتهى هؤلاء العلماء إلى أن الدين هو العلاج الشافي لأمراض النفس لأنه الطريق الوحيد إلى القلب والعقل، وأنه يحدث نوعاً من غسل الدماغ للفرد (فقد ساعد الدين مدى العصور والأزمنة على مواجهة قوى الظلم والاستبداد، ومن أجل ذلك ظهرت محاولات عدة لصياغة الكثير من القواعد الدينية في قوالب نظريات في علم النفس، ونستطيع ان نعبر عن ذلك بالعبارة المشهورة التي ذكرها (مورر): إن هذه المحاولات النفسية ذات الأصول الدينية سوف تنقذ البشرية في وقت قريب).
بين العقل والوجدان
- الزيارات: 9795