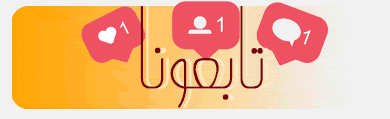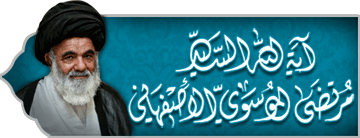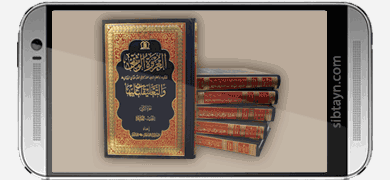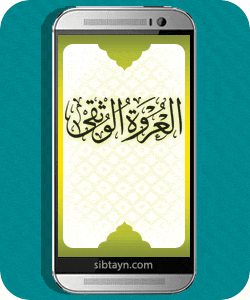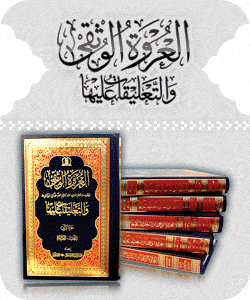الفصل التاسع
أنواع من المعرفة والعارفين
المعرفة الحقيقية والمعرفة الشكلية
الصحيفة السجادية:2/108
... عن ثابت البناني قال: كنت حاجاً وجماعة عباد البصرة مثل أيوب السجستاني، وصالح المري ، وعتبة الغلام ، وحبيب الفارسي ، ومالك بن دينار ، فلما أن دخلنا مكة رأينا الماء ضيقاً ، وقد اشتد بالناس العطش لقلة الغيث ، ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألوننا أن نستسقي لهم ، فأتينا الكعبة وطفنا بها، ثم سألنا الله خاضعين متضرعين بها ، فمنعنا الإجابة. فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل وقد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه ، فطاف بالكعبة أشواطاً ، ثم أقبل علينا ، فقال: يا مالك بن دينار ويا ثابت البناني ويا صالح المري ويا عتبة الغلام ويا حبيب الفارسي ويا سعد ويا عمر ويا صالح الأعمى ويا رابعة ويا سعدانة ويا جعفر بن سليمان ، فقلنا: لبيك وسعديك يا فتى. فقال: أما فيكم أحد يحبه الرحمن ؟ فقلنا: يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة ، فقال: أبعدوا عن الكعبة فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه!
ثم أتى الكعبة فخر ساجداً ، فسمعته يقول في سجوده: سيدي بحبك لي إلا سقيتهم الغيث. قال: فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب. فقلت: يا فتى من أين علمت أنه يحبك ؟ قال: لو لم يحبني لم يستزرني ، فلما استزارني علمت أنه يحبني ، فسألته بحبه لي فأجابني. ثم ولى عنا وأنشأ يقول:
من عرف الرب فلم تُغْنِهِ معرفة الرب فذاك الشقِي
ما ضر ذو الطاعة ما ناله في طاعة الله وما ذا لقِي
ما يصنع العبد بغير التقى والعز كـل العز للمتقِي
فقلت يا أهل مكة من هذا الفتى ؟ قالوا: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ورواه في مستدرك الوسائل:6/209
تحير المتصوفة في دور العقل في المعرفة
التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي/63-67 (تحقيق د. عبد الحليم محمود طبع عيسى الحلبي مصر 1960 )
قولهم في معرفة الله تعالى:
أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده ، وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل في حاجته إلى الدليل لأنه محدث ، والمحدث لا يدل إلا على مثله. وقال رجل للنوري: ما الدليل على الله ؟ قال: الله. قال فما العقل ؟ قال العقل عاجز ، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله !
وقال ابن عطاء: العقل آلة للعبودية لا للأشراف على الربوبية. وقال غيره: العقل يجول حول الكون ، فإذا نظر إلى المكون ذاب. وقال أبوبكر القحطبي: من لحقته العقول فهوت مقهورة إلا من جهة الإثبات ، ولولا أنه تعرف إليها بالألطاف لما أدركته من جهة الإثبات . وأنشدونا لبعض الكبار:
من رامه بالعقل مسترشداً سرحه في حيرة يلهو
وشاب بالتلبيس أسراره يقول من حيرته هل هو
وقال بعض الكبار من المشايخ: البادي من المكونات معروف بنفسه لهجوم العقل عليه ، والحق أعز من أن تهجم العقول عليه وإنه عرفنا نفسه أنه ربنا فقال: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ ولم يقل: من أنا ؟ فتهجم العقول عليه حين بدأ معرفاً ، فلذلك انفرد عن العقول ، وتنزه عن التحصل غير الإثبات .
وأجمعوا أنه لا يعرفه إلا ذو عقل ، لأن العقل آلة للعبد يعرف به ما عرف ، وهو بنفسه لا يعرف الله تعالى .
وقال أبوبكر السباك: لما خلق الله العقل قال له: من أنا ؟ فسكت فكحله بنور الوحدانية ففتح عينيه فقال: أنت الله لا إله إلا أنت. فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا الله .
تحيرهم في الفرق بين العلم والمعرفة
ثم اختلفوا في المعرفة نفسها: ما هي ؟ والفرق بينها وبين العلم .
فقال الجنيد: المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه. قيل له زدنا ، قال: هو العارف وهو المعروف. معناه: إنك جاهل به من حيث أنت ، وإنما عرفته من حيث هو ، وهو كما قال سهل: المعرفة هي المعرفة بالجهل .
وقال سهل: العلم يثبت بالمعرفة ، والعقل يثبت بالعلم ، وأما المعرفة فإنها تثبت بذاتها. معناه: إن الله إذا عرف عبداً نفسه فعرف الله تعالى بتعرفه إليه ، أحدث له بعد ذلك علماً ، فأدرك العلم بالمعرفة وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدثه فيه .
وقال غيره: تبين الأشياء على الظاهر علم ، وتبينها على استكشاف بواطنها معرفة. وقال غيره: أباح العلم للعامة وخص أولياءه بالمعرفة .
وقال أبوبكر الوراق: المعرفة معرفة الأشياء بصورها وسماتها ، والعلم علم الأشياء بحقائقها .
وقال أبو سعيد الخراز: المعرفة بالله هي علم الطلب لله من قبل الوجود له ، والعلم بالله هو بعد الوجود ، فالعلم بالله أخفى وأدق من المعرفة بالله .
وقال فارس: المعرفة هي المستوفية في كنه المعروف .
وقال غيره: المعرفة هي حقر الأقدار إلا قدر الله ، وأن لا يشهد مع قدر الله قدراً .
وقيل لذي النون: بم عرفت ربك ؟ قال: ما هممت بمعصية فذكرت جلال الله إلا استحييت منه. جعل معرفته بقرب الله منه دلالة المعرفة له .
وقيل لعليان: كيف حالك مع المولى ؟ قال: ما جفوته منذ عرفته. قيل له: متى عرفته ؟ قال: منذ سموني مجنوناً. جعل دلالة معرفة له تعظيم قدره عنده .
قال سهل: سبحان من لم يدرك العباد من معرفته إلا عجزاً عن معرفته .
تصوراتهم عن العارف بالله تعالى
التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي/136-138
سئل الحسن بن علي بن يزدانيار: متى يكون العارف بمشهد الحق ؟ قال: إذا بدا الشاهد ، وفني الشواهد ، وذهب الحواس ، واضمحل الإخلاص .
معنى بدا الشاهد: يعني شاهد الحق ، وهو أفعاله بك مما سبق منه إليك من بره لك ، وإكرامه إياك بمعرفته ، وتوحيده ، والإيمان به ، تفنى رؤية ذلك منك رؤية أفعالك وبرك وطاعتك ، فترى كثير ما منك مستغرقاً في قليل ما منه ، وإن كان ما منه ليس بقليل ، وما منك ليس بكثير .
وفناء الشواهد: بسقوط رؤية الخلق عنك ، بمعنى الضر والنفع والذم والمدح .
وذهاب الحواس هو معنى قوله: فبي ينطق وبي يبصر ، الحديث.
ومعنى اضمحل الإخلاص: أن لا يراك مخلصاً ، وما خلص من أفعالك خلص ، ولن يخلص أبداً إذا رأيت صفتك ، فإن أوصافك معلولة مثلك .
سئل ذوالنون ، عن نهاية العارف ، فقال: إذا كان كما كان حيث كان قبل أن يكون ، معناه: أن يشاهد الله وأفعاله دون شاهده وأفعاله .
قال بعضهم: أعرف الخلق بالله أشدهم تحيراً فيه .
قيل لذي النون: ما أول درجة يرقاها العارف ؟
فقال: التحير ، ثم الافتقار ، ثم الإتصال ، ثم التحير .
الحيرة الأولى في أفعاله به ونعمه عنده ، فلا يرى شكره يوازي نعمه ، وهو يعلم أنه مطالب بشكرها ، وإن شكر كان شكره نعمة يجب عليه شكرها ، ولا يرى أفعاله أهلاً أن يقابله بها استحقاراً لها ، ويراها واجبة عليه ، لا يجوز له التخلف عنها .
وقيل قام الشبلي يوماً يصلي فبقى طويلاً ثم صلى ، فلما انفتل عن صلاته قال: يا ويلاه إن صليت جحدت ، وإن لم أصل كفرت .
أي جحدت عظم النعمة وكمال الفضل حيث قابلت ذلك بفعلي شكراً له مع حقارته. ثم أنشد:
الحمـد لله علـى أننـي كضفدع يسكن في اليم
إن هي فاهت ملات فمها أو سكتت ماتت من الغم
والحيرة الأخيرة: أن يتحير في متاهات التوحيد ، فيضل فهمه ويخنس عقله في عظم قدرة الله تعالى وهيبته وجلاله. وقد قيل: دون التوحيد متاهات تضل فيها الأفكار .
سأل أبو السوداء بعض الكبار فقال: هل للعارف وقت ؟ قال: لا. فقال: لم ؟ قال: لأن الوقت فرجة تنفس عن الكربة ، والمعرفة أمواج تغط ، وترفع وتحط ، فالعارف وقته أسود مظلم. ثم قال:
شرط المعارف محو الكل منك إذا بدا المريد بلحظ غير مطلع
قال فارس العارف: من كان علمه حالة ، وكانت حركاته غلبة عليه .
سئل الجنيد عن العارف فقال: لون الماء لون الإناء. يعني أنه يكون في كل حال بما هو أولى فتختلف أحواله ، ولذلك قيل: هو ابن وقته .
سئل ذو النون عن العارف ، فقال: كان هاهنا فذهب. يعني أنك لا تراه في وقتين بحالة واحدة ، لأن مصرفه غيره. وأنشدونا لابن عطاء:
ولو نطقت في السن الدهر خبرت بأني في ثوب الصبابة أرفل
وما أن لها علم بقدري وموضعي وما ذاك موهوم لاني أنقل
وقال سهل بن عبدالله: أول مقام في المعرفة أن يعطى العبد يقيناً في سره تسكن به جوارحه، وتوكلاً في جوارحه يسلم به في دنياه، وحياة في قلبه يفوز بها في عقباه .
قلنا: العارف هو الذي بذل مجهوده فيما لله ، وتحقق معرفته بما من الله ، وصح رجوعه من الأشياء إلى الله. قال الله تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق .
المؤلفة قلوبهم بالمال لكي يعرفوا
اجتهد الخليفة عمر بن الخطاب في آية المؤلفة قلوبهم فأسقط سهمهم رغم نص الآية عليه ، وقد خالفه في ذلك علي والأئمة من أهل البيت((عليهم السلام)وعدد من الصحابة لأن الآية نصت على ذلك ولا يجوز نسخها بالإجتهاد !
الكافي:2/412
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن رجل قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم ، وهم قوم وحدوا الله وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمد رسول الله(ص) قلوبهم وما جاء به ، فتألفهم رسول الله(ص)وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله(ص) لكي ما يعرفوا .
مجمع الفائدة والبرهان:4/158
الرابع: المؤلفة قلوبهم ، قال المصنف في المنتهى: أجمع علمائنا على أن من المشركين قوم مؤلفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين ، ونقل في التهذيب من تفسير علي بن إبراهيم ، عن العالم(عليه السلام)أنه قال: والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمداً رسول الله(ص)، فكان رسول الله(ص)يتألفهم يعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا .
راجع أيضاً: الحدائق الناضرة:12/175 ، وذخيرة المعاد/454 ، ومستند الشيعة:2/46 ، وجواهر الكلام:15/339 ، وفقه السيد الخوئي:23/247 ، ومصباح الفقية:3/95 ، وغيرها من مصادر الحديث والفقه والتفسير .
دعوة العدو في الجهاد إلى معرفة الله تعالى
الكافي:5/36
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال: دخل رجال من قريش على علي بن الحسين صلوات الله عليهما ، فسألوه كيف الدعوة إلى الدين ؟ قال: تقول: بسم الله الرحمن الرحيم أدعوكم إلى الله عز وجل وإلى دينه ، وجماعه أمران: أحدهما معرفة الله عز وجل ، والآخر العمل برضوانه ، وأن معرفة الله عز وجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شئ وأنه النافع الضار ، القاهر لكل شئ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل ، وما سواه هو الباطل ، فإذا أجابوا ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لما وجهني رسول الله(ص)إلى اليمن قال:يا علي لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام ، وأيم الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه. انتهى. وروى نحو الحديث الأول في تهذيب الأحكام:6/141
معرفة أهل الآخرة بديهية لا كسبية
رسائل الشريف المرتضى:2/133
قال المرتضى (رض): سألت بيان أحكام أهل الآخرة في معارفهم وأحوالهم ، وأنا ذاكر من ذلك جملة وجيزة: إعلم أن لأهل الآخرة ثلاث أحوال: حال ثواب ، وحال عقاب ، وحال أخرى للمحاسبة. ويعمهم في هذه الأحوال الثلاث سقوط التكليف عنهم ، وأن معارفهم ضرورية ، وأنهم ملجؤون إلى الإمتناع من القبيح وإن كانوا مختارين لأفعالهم مؤثرين لها، وهذا هو الصحيح دون ما ذهب إليه من خالف هذه الجملة... .
وأما الذي يدل على أن أهل الآخرة لابد أن يكونوا عارفين بالله تعالى وأحواله ، فهو أن المثاب متى لم يعرفه تعالى ، لم يصح منه معرفة كون الثواب ثواباً وواصلاً إليه على الوجه الذي يستحقه ، وأنه دائم غير منقطع ، وإذا كانت هذه المعارف واجبة فما لا يتم هذه المعرفة إلا به ـ من معرفة الله تعالى وإكمال العقل وغيرهما ـ لابد من حصوله .
بحث للشيخ الطوسي في تعريف الإيمان والكفر
الاقتصاد/140
الإيمان هو التصديق بالقلب، ولا إعتبار بما يجرى على اللسان، وكل من كان عارفاً بالله وبنبيه وبكل ما أوجب الله عليه معرفته مقراً بذلك مصدقاً به فهو مؤمن. والكفر نقيض ذلك ، وهو الجحود بالقلب دون اللسان مما أوجب الله تعالى عليه المعرفة به ، ويعلم بدليل شرعي أنه يستحق العقاب الدائم الكثير .
وفي المرجئة من قال: الإيمان هو التصديق باللسان خاصة وكذلك الكفر هو الجحود باللسان ، والفسق هو كل ما خرج به عن طاعة الله تعالى إلى معصيته ، سواء كان صغيراً أو كبيراً. وفيهم من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً ، والكفر هو الجحود بهما .
وفي أصحابنا من قال: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان والعمل بالجوارح ، وعليه دلت كثير من الأخبار المروية عن الائمة((عليهم السلام).
وقالت المعتزلة: الإيمان إسم للطاعات ، ومنهم من جعل النوافل والفرائض من الإيمان ، ومنهم من قال النوافل خارجة عن الإيمان. والإسلام والدين عندهم شئ واحد ، والفسق عندهم عبارة عن كل معصية يستحق بها العقاب ، والصغائر التي تقع عندهم مكفرة لا تسمى فسقاً. والكفر عندهم هو ما يستحق به عقاب عظيم ، وأجريت على فاعله أحكام مخصوصة ، فمرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر بل هو فاسق .
وقالت الخوارج قريباً من قول المعتزلة إلا أنهم لا يسمون الكبائر كلها كفراً ، وفيهم من يسميها شركاً .
والفضيلية منهم تسمي كل معصية كفراً صغيرة كانت أو كبيرة .
والزيدية من كان منهم على مذهب الناصر يسمون الكبائر كفر نعمة ، والباقون يذهبون مذهب المعتزلة .
والذي يدل على ما قلناه: أولاً ، هو أن الإيمان في اللغة هو التصديق ، ولا يسمون أفعال الجوارح إيماناً ، ولا خلاف بينهم فيه .
ويدل عليه أيضاً قولهم: فلان يؤمن بكذا وكذا وفلان لا يؤمن بكذا. وقال تعالى: يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. وقال: وما أنت بمؤمن لنا ، أي بمصدق ، وإذا كان فائدة هذه اللفظة في اللغة ما قلناه وجب إطلاق ذلك عليها إلا أن يمنع مانع ، ومن ادعى الانتقال فعليه الدلالة ، وقد قال الله تعالى: بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُبِينٍ. وقال: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. وقال: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. وكل ذلك يقتضي حمل هذه اللفظة على مقتضى اللغة. وليس إذا كان هاهنا ألفاظ منتقلة وجب أن يحكم في جميع الألفاظ بذلك ، وإنما ينتقل عما ينتقل بدليل يوجب ذلك. وإن كان في المرجئة من قال ليس هاهنا لفظ منتقل ولا يحتاج إلى ذلك .
ولا يلزمنا أن نسمي كل مصدق مؤمنا لأنا إنما نطلق ذلك على من صدق بجميع ما أوجبه الله عليه. والإجماع مانع من تسمية من صدق بالجبت والطاغوت مؤمناً ، فمنعنا ذلك بدليل وخصصنا موجب اللغة ، وجرى ذلك مجرى تخصيص العرف لفظ الدابة ببهيمة مخصوصة ، وإن كان موجب اللغة يقتضي تسمية كل ما دب دابة ، ويكون ذلك تخصيصاً لا نقلاً. فعلى موجب هذا ، يلزم من ادعى انتقال هذه اللفظة إلى أفعال الجوارح أن يدل عليه .
وليس لأحد أن يقول: إن العرف لا يعرف التصديق فيه إلا بالقول ، فكيف حملتموه على ما يختص القلب ؟
قلنا: العرف يعرف بالتصديق باللسان والقلب ، لانهم يصفون الاخرس بأنه مؤمن وكذلك الساكت، ويقولون: فلان يصدق بكذا وكذا وفلان لا يصدق ، ويريدون ما يرجع إلى القلب ، فلم يخرج بما قلناه عن موجب اللغة .
وإنما منعنا إطلاقه في المصدق باللسان لأنه لو جاز ذلك لوجب تسميته بالإيمان وإن علم جحوده بالقلب ، والإجماع مانع من ذلك .
... وأما الكفر فقد قلنا إنه عند المرجئة من أفعال القلوب ، وهو جحد ما أوجب الله تعالى معرفته مما عليه دليل قاطع كالتوحيد والعدل والنبوة وغير ذلك ، وأما في اللغة فهو الستر والجحود ، وفي الشرع عبارة عما يستحق به العقاب الدائم الكثير ، ويلحق بفاعله أحكام شرعية كمنع التوارث والتناكح .
والعلم بكون المعصية كفراً طريقه السمع لا مجال للعقل فيه ، لأن مقادير العقاب لا تعلم عقلاً ، وقد أجمعت الأمة على أن الإخلال بمعرفة الله تعالى و توحيده وعدله وجحد نبوة رسله كفر ، لا يخالف فيه إلا أصحاب المعارف الذين بينا فساد قولهم .
ولا فرق بين أن يكون شاكاً في هذه الأشياء أو يكون معتقداً لما يقدح في حصولها ، لأن الاخلال بالواجب يعم الكل .
فعلى هذا ، المجبرة والمشبهة كفار ، وكذلك من قال بالصفات القديمة لأن اعتقادهم الفاسد في هذه الأشياء ينافي الإعتقاد الصحيح من المعرفة بالله تعالى وعدله وحكمته .
بحث للشهيد الثاني في تعريف الإيمان والكفر
رسائل الشهيد الثاني:2/50
في تعريف الإيمان لغة وشرعاً ، فاعلم أن الإيمان لغةً: التصديق ، كما نص عليه أهلها ، وهو إفعال من الأمن ، بمعنى سكون النفس واطمئنانها لعدم ما يوجب الخوف لها ، وحينئذ فكان حقيقة آمن به سكنت نفسه واطمأنت بسبب قبول قوله وامتثال أمره ، فتكون الباء للسببية. ويحتمل أن يكون بمعنى آمنه التكذيب والمخالفة ، كما ذكره بعضهم فتكون الباء فيه زائدة ، والأول أولى كما لا يخفى وأوفق لمعنى التصديق ، وهو يتعدى باللام كقوله تعالى: وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ، فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ . وبالباء كقوله تعالى: آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ .
وأما التصديق: فقد قيل أنه القبول والإذعان بالقلب ، كما ذكره أهل الميزان .
ويمكن أن يقال: معناه قبول الخبر أعم من أن يكون بالجنان أو باللسان ، ويدل عليه قوله تعالى: قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا. فأخبروا عن أنفسهم بالإيمان وهم من أهل اللسان ، مع أن الواقع منهم هو الإعتراف باللسان دون الجنان ، لنفيه عنهم بقوله تعالى: قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا . وإثبات الإعتراف بقوله تعالى: وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ، الدال على كونه إقراراً بالشهادتين ، وقد سموه إيماناً بحسب عرفهم ، والذي نفاه الله عنهم إنما هو الإيمان في عرف الشرع .
إن قلت: يحتمل أن يكون ما ادعوه من الإيمان هو الشرعي ، حيث سمعوا الشارع كلفهم بالإيمان ، فيكون المنفي عنهم هو ما ادعوا ثبوته لهم ، فلم يبق في الآية دلالة على أنهم أرادوا اللغوي .
قلت: الظاهر أنه في ذلك الوقت لم تكن الحقائق الشرعية متقررة عندهم ، لبعدهم عن مدارك الشرعيات، فلا يكون المخبر عنه إلا ما يسمونه إيماناً عندهم.
وقوله تعالى: آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ، وقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .
وجه الدلالة في هذه الآيات أن الإيمان في اللغة التصديق ، وقد وقع في الأخبار عنهم أنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم ، فيلزم صحة إطلاق التصديق على الإقرار باللسان وإن لم يوافقه الجنان. وعلى هذا فيكون المنفي هو الإيمان الشرعي أعني القلبي ، جمعاً بين صحة النفي والإثبات في هذه الآيات .
لا يقال: هذا الإطلاق مجاز ، وإلا لزم الإشتراك ، والمجاز خير منه .
لانا نقول: هو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي ، ومعناه قبول الخبر أعم من أن يكون باللسان أو بالجنان ، واستعمال اللفظ الكلي في أحد أفراد معناه باعتبار تحقق الكلي في ضمنه حقيقة لا مجازاً ، كما هو المقرر في بحث الالفاظ .
فإن قلت: إن المتبادر من معنى الإيمان هو التصديق القلبي عند الإطلاق، وأيضاً يصح سلب الإيمان عمن أنكر بقلبه وإن أقر بلسانه ، والأول علامة الحقيقة والثاني علامة المجاز .
قلت: الجواب عن الأول أن التبادر لا يدل على أكثر من كون المتبادر هو الحقيقي لا المجازي ، لكن لا يدل على كون الحقيقة لغوية أو عرفية ، وحينئذ فلا يتعين أن اللغوي هو التصديق القلبي ، فلعله العرفي الشرعي .
إن قلت: الأصل عدم النقل ، فيتعين اللغوي .
قلت: لا ريب أن المعنى اللغوي الذي هو مطلق التصديق لم يبق على إطلاقه بل أخرج عنه إما بالتخصيص عند بعض أو النقل عند آخرين. ومما يدل على ذلك أن الإيمان الشرعي هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله ، وبنبوة نبينا محمد (ص)وبما علم بالضرورة مجيئه به لا ما وقع فيه الخلاف وعلى هذا أكثر المسلمين. وزاد الإمامية التصديق بإمامة إمام الزمان ، لأنه من ضروريات مذهبهم أيضاً أنه مما جاء به النبي(ص) وقد عرفت أن الإيمان في اللغة التصديق مطلقاً ، وهذا أخص منه .
ويؤيد ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ. أخبر عنهم تعالى بالإيمان ، ثم أمرهم بإنشائه فلابد أن يكون الثاني غير الأول ، وإلا لكان أمراً بتحصيل الحاصل. وإذا حصلت المغايرة كان الثاني المأمور به هو الشرعي ، حيث لم يكن حاصلاً لهم ، إذ لا محتمل غيره إلا التأكيد ، والتأسيس خير منه. وعن الثاني بالمنع من كون ما صح سلبه هو الإيمان اللغوي بل الشرعي ، وليس النزاع فيه .
إن قلت: ما ذكرته معارض بما ذكره أهل الميزان في تقسيم العلم إلى التصور والتصديق ، من أن المراد بالتصديق الإذعان القلبي ، فيكون في اللغة كذلك لأن الأصل عدم النقل .
قلت: قد بينا سابقاً أن الخروج عن هذا الأصل ولو سلم فلا دلالة في ذلك على حصر معنى التصديق مطلقاً في الإذعان القلبي ، بل التصديق الذي هو قسم من العلم وليس محل النزاع .
على أنا نقول: لو سلمنا صحة الإطلاق مجازاً ثبت مطلوبنا أيضاً ، لانا لم ندع إلا أن معناه قبول الخبر مطلقاً ، ولا ريب أن الألفاظ المستعملة لغة في معنى من المعاني حقيقة أو مجازاً تعد من اللغة ، وهذا ظاهر .
واما الإيمان الشرعي: فقد اختلفت في بيان حقيقته العبارات بحسب اختلاف الإعتبارات. وبيان ذلك: إن الإيمان شرعاً: إما أن يكون من أفعال القلوب فقط ، أو من أفعال الجوارح فقط ، أو منهما معاً. فإن كان الأول فهو التصديق بالقلب فقط ، وهو مذهب الأشاعرة وجمع من متقدمي الإمامية ومتأخريهم ، ومنهم المحقق الطوسي&في فصوله ، لكن اختلفوا في معنى التصديق فقال أصحابنا: هو العلم. وقال الأشعرية: هو التصديق النفساني ، وعنوا به أنه عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر ، فهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق ، ولذا يثاب عليه بخلاف العلم والمعرفة ، فإنها ربما تحصل بلا كسب ، كما في الضرويات .
وقد ذكر حاصل ذلك بعض المحققين ، فقال: التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق للمخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاً وإن كان معرفة ، وسنبين إن شاء الله تعالى ] قصور [ ذلك .
وإن كان الثاني ، فإما أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتين فقط ، وهو مذهب الكرامية. أوعن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرها فرضاً ونفلاً ، وهو مذهب الخوارج وقدماء المعتزلة والغلاة والقاضي عبدالجبار. أو عن جميعها من الواجبات وترك المحظورات دون النوافل ، وهو مذهب أبي على الجبائي وابنه هاشم وأكثر معتزلة البصرة .
وإن كان الثالث ، فهو إما أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من الطاعات ، وهو قول المحدثين وجمع من السلف كابن مجاهد وغيره ، فإنهم قالوا: إن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان .
وإما أن يكون عبارة عن التصديق مع كلمتي الشهادة ، ونسب إلى طائفة ، منهم أبوحنيفة .
أو يكون عبارة عن التصديق بالقلب مع الإقرار باللسان ، وهو مذهب المحقق نصير الدين الطوسي&في تجريده ، فهذه سبعة مذاهب ذكرت في الشرح الجديد للتجريد وغيره .
واعلم أن مفهوم الإيمان على المذهب الأول يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي ، وأما على المذاهب الباقية فهومنقول ، والتخصيص خير من النقل .
وهنا بحث وهو أن القائلين بأن الإيمان عبارة عن فعل الطاعات ، كقدماء المعتزلة والعلاف والخوارج ، لا ريب أنهم يوجبون اعتقاد مسائل الأصول ، وحينئذ فما الفرق بينهم وبين القائلين بأنه عبارة عن أفعال القلوب والجوارح ؟
ويمكن الجواب ، بأن اعتقاد المعارف شرط عند الأولين وشطر عند الاخرين...
إعلم أن المحقق الطوسي&ذكر في قواعد العقائد أن أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته تعالى ، والعدل في أفعاله ، والتصديق بنبوة الأنبياء(عليهم السلام)والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء (عليهم السلام).
وقال أهل السنة: إن الإيمان هو التصديق بالله تعالى ، وبكون النبي(ص)صادقاً ، والتصديق بالأحكام التي يعلم يقيناً أنه(ص)حكم بها دون ما فيه اختلاف واشتباه .
والكفر يقابل الإيمان ، والذنب يقابل العمل الصالح، وينقسم إلى كبائر وصغائر .
ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود في الجنة ، ويستحق الكافر الخلود في العقاب. انتهى .
وذكر في الشرح الجديد للتجريد أن الإيمان في الشرع عند الأشاعرة هو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة ، فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً ، وإجمالاً فيما علم إجمالاً ، فهو في الشرع تصديق خاص. انتهى .
فهؤلاء اتفقوا على أن حقيقة الإيمان هي التصديق فقط ، وإن اختلفوا في المقدار المصدق به. والكلام هاهنا في مقامين:
الأول: في أن التصديق الذي هو الإيمان المراد به اليقين الجازم الثابت ، كما يظهر من كلام من حكينا عنه .
الثاني: في أن الأعمال ليست جزء من حقيقة الإيمان الحقيقي ، بل هي جزء من الإيمان الكمالي. أما الدليل على الأول فآيات بينات:
منها قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. والإيمان حق للنص والإجماع ، فلا يكفى في حصوله وتحققه الظن .
ومنها: إن يتبعون إلا الظن ، إن هم إلا يظنون ، إن بعض الظن إثم. فهذه قد اشتركت في التوبيخ على اتباع الظن ، والإيمان لا يوبخ من حصل له بالإجماع ، فلا يكون ظناً .
ومنها قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فنفى عنهم الريب ، فيكون الثابت هو اليقين .
إن قلت: هذه الآية الكريمة لا تدل على المدعى بل على خلافه ، وهو عدم اعتبار اليقين في الإيمان ، وذلك أنها إنما دلت على حصر الإيمان فيما عدا الشك ، فيصدق الإيمان على الظن .
قلت: الظن في معرض الريب ، لأن النقيض مجوز فيه ويقوى بأدنى تشكيك ، فصاحبه لا يخلو من ريب حيث أنه دائماً يجوز النقيض ، على أن الريب قد يطلق على ما هو أعم من الشك ، يقال: لا أرتاب في كذا. ويريد أنه منه على يقين ، وهذا شائع ذائع .
ومن السنة المطهرة قوله (عليه السلام): يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، فلو لم يكن ثبات القلب شرطاً في الإيمان لما طلبه(عليه السلام)، والثبات هو الجزم والمطابقة ، والظن لإثبات فيه ، إذ يجوز ارتفاعه .
وفيه ، منع كون الثبات شرطاً في تحقيق الإيمان ، ويجوز أن يكون(عليه السلام)طلبه لكونه الفرد الأكمل ، وهو لا نزاع فيه .
ومن جملة الدلائل على ذلك أيضاً الإجماع ، حيث ادعى بعضهم أنه يجب معرفة الله تعالى التي لا يتحقق الإيمان بها إلا بالدليل إجماعاً من العلماء كافة ، والدليل ما أفاد العلم ، والظن لا يفيده .
وفي صحة دعوى الإجماع بحث ، لوقوع الخلاف في جواز التقليد في المعارف الأصولية ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .
واعلم أن جميع ما ذكرناه من الأدلة لا يفيد شئ منه العلم بأن الجزم والثبات معتبر في التصديق الذي هو الإيمان إنما يفيد الظن باعتبارهما ، لأن الآيات قابلة للتأويل وغيرها كذلك ، مع كونها من الاحاد .
ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ . واعترض على هذا الدليل بأنه أخص من المدعى ، فإنه إنما يدل على اعتبار اليقين في بعض المعارف ، وهو التوحيد دون غيره ، والمدعى اعتبار اليقين في كل ما التصديق به شرط في تحقق الإيمان ، كالعدل والنبوة والمعاد وغيرها .
وأجيب بأنه لا قائل بالفرق ، فإن كل من اعتبر اليقين اعتبره في الجميع ، ومن لم يعتبره لم يعتبره في شئ منها. واعلم أن ما ذكرناه على ما تقدم وارد هاهنا أيضاً .
واعترض أيضاً بأن الآية الكريمة خطاب للرسول(ص) ، فهي إنما تدل على وجوب العلم عليه وحده دون غيره .
وأجيب بأن ذلك ليس من خصوصياته(ص)بالإجماع ، وقد دل دليل وجوب التأسي به على وجوب اتباعه ، فيجب على باقي المكلفين تحصيل العلم بالعقائد الأصولية .
وأيضاً أورد أنه إنما يفيد الوجوب لو ثبت أن الأمر للوجوب ، وفيه منع لاحتماله غيره ، وكذا يتوقف على كون المراد من العلم هاهنا القطعي ، وهو غير معلوم ، إذ يحتمل أن يراد به الظن الغالب، وهو يحصل بالتقليد. وبالجملة فهو دليل ظني.
وأما المقالة الثانية وهو أن الأعمال ليست جزء من الإيمان ولا نفسه فالدليل عليه من الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، والإجماع .
أما الكتاب ، فمنه قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، فإن العطف يقتضي المغايرة ، وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه ، فلو كان عمل الصالحات جزء من الإيمان أو نفسه لزم خلو العطف عن الفائدة لكونه تكراراً .
وَرُدَّ ذلك بأن الصالحات جمع معرف يشمل الفرض والنفل ، والقائل بكون الطاعات جزء من الإيمان يريد بها فعل الواجبات واجتناب المحرمات ، وحينئذ فيصح العطف لحصول المغايرة المفيدة لعموم المعطوف ، فلم يدخل كله في المعطوف عليه، نعم ذلك يصلح دليلاً على إبطال مذهب القائلين بكون المندوب داخلاً في حقيقة الإيمان كالخوارج .
ومنه قوله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، أي حالة إيمانه ، فإن عمل الصالحات في حالة الإيمان يقتضي المغايرة لما أضيف إلى تلك الحالة وقارنه فيها ، وإلا لصار المعنى: ومن يعمل بعض الإيمان حال حصول ذلك البعض ، أو ومن يعمل من الإيمان حال حصوله ، وحينئذ فيلزم تقدم الشئ على نفسه وتحصيل الحاصل .
إن قلت: الآية الكريمة إنما تدل على المغايرة في الجملة ، لكن لا يلزم من ذلك أن لا تكون الأعمال جزءاً ، فإن المعنى والله أعلم: ومن يعمل من الصالحات حال إيمانه ، أي تصديقه بالمعارف الإلهية ، وحينئذ فيجوز أن يكون الإيمان الشرعي بمجموع الجزئين ، أي عمل الصالحات والتصديق المذكور ، فالمغايرة إنما هي بين جزئي الإيمان ولا محذور فيه ، بل لابد منه وإلا لما تحقق الكل ، بل لابد لنفي ذلك من دليل.
قلت: من المعلوم أن الإيمان قد غير عن معناه لغة ، فأما التصديق بالمعارف فقط فيكون تخصيصاً ، أو مع الأعمال فيكون نقلاً ، لكن الأول أولى ، لأن التخصيص خير من النقل .
ووجه الإستدلال بالآية أيضاً بأن ظاهرها كون الإيمان الشرعي شرطاً لصحة الأعمال ، حيث جعل سعيه مقبولاً إذا وقع حال الإيمان ، فلابد أن يكون الإيمان غير الأعمال ، وإلا لزم إشتراط الشئ بنفسه .
ويرد على هذا ما ورد على الأول بعينه ، نعم اللازم هنا أن يكون أحد جزئي المركب شرطاً لصحة الآخر ولا محذور فيه .
والجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك فتأمل .
ومنه قوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا... فإنه أثبت الإيمان لمن ارتكب بعض المعاصي ، فلو كان ترك المنهيات جزء من الإيمان لزم تحقق الإيمان وعدم تحققه في موضع واحد في حالة واحدة وهو محال .
ولهم أن يجيبوا عن ذلك بمنع تحقق الإيمان حالة ارتكاب المنهي ، وكون تسميتهم بالمؤمنين باعتبار ما كانوا عليه وخصوصاً على مذهب المعتزلة ، فإنهم لا يشترطون في صدق المشتق على حقيقة بقاء المعنى المشتق منه .
ويمكن دفعه بأن الشارع قد منع من جواز إطلاق المؤمن على من تحقق كفره وعكسه ، والكلام في خطاب الشارع ، فلا نسلم لهم الجواب .
ومنه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، فإن أمرهم بالتقوى التي لا تحصل إلا بفعل الطاعات والإنزجار عن المنهيات مع وصفهم بالإيمان ، يدل على عدم حصول التقوى لهم ، وإلا لما أمروا بها مع حصول الإيمان لو صفهم به ، فلا تكون الأعمال نفس الإيمان ولا جزء منه ، وإلا لكان أمراً بتحصيل الحاصل .
ويرد عليه ، جواز أن يراد من الإيمان الذي وصفوا به اللغوي ، ويكون المأمور به هو الشرعي وهو الطاعات ، أو جزؤه عند من يقول بالجزئية. ويجاب عنه بنحو ما أجيب عما أورد على الدليل الثاني ، فليتأمل .
ومنه أيضاً الآيات الدالة على كون القلب محلاً للايمان من دون ضميمة شئآخر ، كقوله تعالى: أُولَئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ . أي جمعه وأثبته فيها والله أعلم .
ولو كان الإقرار غيره من الأعمال نفس الإيمان أو جزءه ، لما كان القلب محل جمعه ، بل هو مع اللسان وحده ، أو مع بقية الجوارح على اختلاف الآراء .
وقوله تعالى: وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ . ولو كان غير القلب من أعمال الجوارح نفس الإيمان أو جزءه ، لما جعل كله محل القلب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة .
وقوله تعالى: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ. فإن إطمئنانه بالإيمان يقتضي تعلقه كله به ، وإلا لكان مطمئناً ببعضه لا كله .
أقول: يرد على الأخير أنه لا يلزم من اطمئنانه بالإيمان كونه محلاً له ، إذ من الجائز كونه عبارة عن الطاعات وحدها ، أو مع شئ آخر واطمئنان القلب لإطلاعه على حصول ذلك ، فإن القلب يطلع على الأعمال .
ويرد على الأولين أن الإيمان المكتوب والداخل في القلب إنما هو العقائد الأصولية ، ولا يدل على حصر الإيمان في ذلك ، ونحن لا نمنع ذلك بل نقول بإعتبار ذلك في الإيمان إما على طريق الشرطية لصحته ، أو الجزئية له ، إذ من يزعم أنه الطاعات فقط لابد من حصول ذلك التصديق عنده أيضاً لتصح تلك الأعمال ، غاية الأمر أنه شرط للإيمان أو جزؤه لا نفسه ، كما تقدمت الاشارة إليه .
نعم هما يدلان على بطلان مذهب الكرامية ، حيث يكتفون في تحققه بلفظ الشهادتين من غير شئ آخر أصلاً لا شرطاً ولا جزءاً .
قيل: وكذا آيات الطبع والختم تشعر بأن محل الإيمان القلب ، كقوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ . . . فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . . . وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ . وفيه ما تقدم .
وأما السنة المطهرة ، فكقوله(عليه السلام): يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ، وجه الدلالة فيه أن المراد من الدين هنا الإيمان ، لأن طلب تثبيت القلب عليه يدل على أنه متعلق بالإعتقاد ، وليس هناك شئ آخر غير الإيمان من الإعتقاد يصلح لثبات القلب عليه بحيث يسمى ديناً ، فتعين أن يكون هو الإيمان، وحيث لم يطلب غيره في حصول الإيمان علم أن الإيمان يتعلق بالقلب لا بغيره .
وكذا ما روي أن جبرئيل(عليه السلام)أتى النبي(ص) فسأله عن الإيمان ؟ فقال: أن تؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر. ومعنى ذلك: أن تصدق بالله ورسله واليوم الآخر ، فلو كان فعل الجوارح أو غيره من الإيمان لذكره له ، حيث سأله الرسول(ص)عما هو الإيمان المطلوب للشارع .
وإن قيل: ظاهر الحديث فيه مناقشة ، وذلك أن الرسول(عليه السلام)سأله عن حقيقة الإيمان ، فكان من حق الجواب في شرح معناه أن يقال: أن تصدق بالله لا أن تؤمن ، لأن أن مع الفعل في تأويل المصدر ، فيصير حاصله الإيمان هو الإيمان بالله ، فيلزم منه تعريف الشئ بنفسه في الجملة ، وذلك لا يليق بنفس الأمر .
والجواب أن المراد من قوله: أن تؤمن بالله ، أن تصدق ، وقد كان التصديق معلوماً له(عليه السلام)لغة ، فلم يكن تعريف الشئ بنفسه ، فهذا إنما يكون بالقياس إلى غيرهما ((ص)) ، وإلا فالسائل والمسؤول غنيان عن معرفة المعاني من الألفاظ .
وأما الإجماع ، فهو أن الأمة أجمعت على أن الإيمان شرط لسائر العبادات ، والشئ لا يكون شرطاً لنفسه ، فلا يكون الإيمان هو العبادات .
أقول: على تقدير تسليم دعوى الإجماع ، فللخصوم أن يقولوا: نحن نقول بكون التصديق بمسائل الأصول شرطاً لصحة العبادات التي هي الإيمان ، ولا يلزمنا بذلك أن يكون تلك المسائل هي الإيمان ، فإن سميتموها إيماناً بالمعنى اللغوي فلا مشاحة في ذلك ، وإن قلتم بل هي الإيمان الشرعي ، فهو محل النزاع ودليلكم لا يدل عليه .
وأجمعت أيضاً على أن فساد العبادات لا يوجب فساد الإيمان ، وذلك يقتضي كون الإيمان غير أعمال الجوارح .
أقول: إن صح نقل الإجماع ، فلا ريب في دلالته على المدعى ، وسلامته عن المطاعن المتقدمة .
هل يمكن أن يصير المؤمن كافراً
... المؤمن هل يجوز أن يكفر بعد إيمانه أم لا ؟ ذهب إلى الأول جماعة من العلماء ، وظاهر القرآن العزيز يدل عليه في آيات كثيرة ، كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ... إلى غير ذلك من الآيات ، ولو كان التصديق بالمعارف الأصولية يعتبر فيه الجزم والثبات لما صح ذلك ، إذ اليقين لا يزول بالأضعف ، ولا ريب أن موجب الكفر أضعف مما يوجب الإيمان .
قلت: لا ريب أن الإيمان من الكيفيات النفسانية ، إذ هو نوع من العلم على ما هو الحق ، فهو عرض، وقبوله للزوال بعروض ضده أو مثله ، عند من يقول الأعراض لا تبقى زمانين كالأشاعرة ظاهر. وكذا على القول بأن الباقي محتاج إلى المؤثر في بقائه أو غير محتاج مع قطع النظر عن بقاء الأعراض زمانين ، لأن الفاعل مختار ، فيصح منه الإيجاد والإعدام في كل وقت. غاية الأمر أن تبديل الإيمان بالكفر لا يجوز أن يكون من فعل الله تعالى على ما تقتضيه قواعد العدلية ، من أن العبد له فعل ، وأن اللطف واجب على الله تعالى ، ولو كان التبديل منه تعالى لنافى اللطف . على أنا نقول : قد يستند الكفر إلى الفعل دون الإعتقاد ، فيجامع الجزم اليقين في المعارف الأصولية ، كما في السجود للصنم وإلقاء المصاحف في القاذورات مع كونه مصدقاً بالمعارف .
إن قلت: فعلى هذا يلزم جواز اجتماع الإيمان والكفر في محل واحد وزمان واحد ، وهو محال ، لأن الكفر عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمناً .
قلت: الإيمان هو التصديق بالأصول المذكورة بشرط عدم السجود وغيره مما يوجب فعله الكفر بدلالة الشارع عليه ، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط .
ثانيها يلزم أن يكون الظان ولو في أحد من الأصول الخمسة كافراً وإن كان عالماً بالباقي ، لأن الظن من أضداد اليقين فلا يجامعه. فيلزم ( القول ) بكفر مستضعفي المسلمين بل كثير من عوامهم ، لعدم التصديق في الأول والثبات في الثاني ، كما نشاهد من تشككهم عند التشكيك ، مع أن الشارع حكم بإسلامهم وأجرى عليهم أحكامه. ومن هاهنا اكتفى بعض العلماء في الإيمان بالتقليد ، كما تقدمت الاشارة إليه .
ويمكن الجواب عن ذلك: بأن من يشترط اليقين يلتزم الحكم بكفرهم لو علم كون اعتقادهم بالمعارف عن ظن ، لكن هذا الإلتزام في المستضعف في غاية البعد والضعف. وأما إجراء الأحكام الشرعية فإنما هو للاكتفاء بالظاهر إذ هو المدار في إجراء الأحكام الشرعية فهو لا ينافي كون المجرى عليه كذلك كافراً في نفس الأمر. وبالجملة ، فالكلام إنما هو في بيان ما يتحقق به كون المكلف مؤمناً عند الله سبحانه ، وأما عندنا فيكفي ما يفيد الظن حصول ذلك له ، كإقراره بالمعارف الأصولية مختاراً غير مستهزي ، لتعذر العلم علينا غالباً بحصول ذلك له.
ثالثها: أنه إذا كان الإيمان هو التصديق الجازم الثابت ، فلا يمكن الحكم بإيمان أحد حتى نعلم يقيناً أن تصديقه بما ذكر يقيني ، وأنى لنا بذلك ، ولا يطلع على الضمائر إلا خالق السرائر .
والجواب عن هذا هو الجواب عن الثاني .
رابعها: انتقاض حد الإيمان والكفر جمعاً ومنعاً بحالة النوم والغفلة وكذا بالصبي لأنه إن كان مصدقاً فهو مؤمن وإلا فكافر ، لعدم الواسطة ، مع أن الشارع لم يحكم عليه بشئ منهما حقيقة بل تبعاً .
وأجيب عن الأولين بأن التصديق باق لم يزل ، والذهول والغفلة إنما هو عن حصوله واتصاف النفس به ، إذ العلم بالعلم وبصفات النفس غير لازم، ولا عدمه ينافي حصولهما .
على أن الشارع جعل الأمر المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده ويزيله في حكم الباقي ، فسمى من اتصف بالإيمان مؤمناً ، سواء كان مستشعراً بإيمان نفسه ، أو غافلاً عن ذلك مع اتصاف نفسه به .
وعن الثالث بأن الكلام في الإيمان الشرعي فهو من أفراد التكليف ، فلا يوصف الصبي بشئ منها حقيقة ، لعدم دخوله في المكلف ، نعم يوصف تبعاً .
هل تزول المعرفة والإيمان بإنكار الضروري ؟
نهاية الافكار:2/190
وحيث انجر الكلام إلى هنا ينبغي عطف الكلام إلى بيان أن كفر منكر الضروري هل هو لمحض إنكاره أو أنه من جهة استتباعه لتكذيب النبي(ص) ، وتظهر الثمرة فيما لو كان منشأ الإنكار الإعتقاد بعدم صدور ما أنكره عن النبي (ص)، أو اشتباه الأمر عليه ، فإنه على الأول
يحكم عليه بالكفر ويرتب عليه آثاره بمحض إنكاره ، بخلاف الثاني حيث لا يحكم عليه بالكفر في الفرض المزبور .
فنقول: إن ظاهر إطلاق كلماتهم في كفر منكر الضروري وإن كان يقتضي الوجه الأول ، ولكن النظر الدقيق فيها يقتضي خلافه ، وذلك لما هو المعلوم من انصراف إطلاق كلماتهم إلى المنكر المنتحل للاسلام المعاشر للمسلمين. ومن الواضح ظهور إنكار مثل هذا الشخص في تكذيبه للنبي(ص)ومع هذا الانصراف لا مجال للأخذ بإطلاق كلامهم في الحكم بكفر منكر الضروري حتى مع العلم بعدم رجوع إنكاره إلى تكذيب النبي(ص)، وبعد عدم دليل في البين على ثبوت الكفر بمحض الإنكار أمكن الإلتزام بعدم الكفر فيمن يحتمل في حقه الشبهة وخفاء الأمر عليه بحسب ظهور حاله كما فيمن هو قريب عهد بالإسلام عاش في البوادي ولم يختلط بالمسلمين ، حيث أن إنكار مثله لا يكون له ظهور في تكذيب النبي(ص)، وبذلك يندفع ما قد يتوهم من اقتضاء البيان المزبور عدم الحكم بالكفر حتى في من نشأ في الإسلام وعاشر المسلمين مع احتمال الشبهة في حقه خصوصاً مع دعواه عدم اعتقاده بصدور ما أنكره عن النبي(ص)وأنه من الموضوعات. إذ نقول إنه كذلك لولا ظهور حال مثله في تكذيب النبي(ص) وعدم خفاء شئ عليه من أساس الدين وضرورياته ، حيث أن العادة قاضية بأن من عاشر المسلمين مدة مديدة من عمره لا يخفى عليه شئ من أساس الدين وضرورياته فضلاً عمن كان مسلماً وكان نشوؤه من صغره بين المسلمين ، فإنكار مثل هذا الشخص يكشف لا محالة بمقتضى ظهور حاله عن تكذيب النبي بحيث لو ادعى جهله بذلك أو اعتقاده بعدم صدور ما أنكره عن النبي لا يسمع منه بل يحكم بكفره .
وهذا بخلاف غيره ممن كان نشوه في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها المسلم فإن ظهور حاله ربما يكون على العكس ، ومن ذلك لا نحكم بكفره بمجرد انكاره لشئ من ضروريات الدين خصوصاً مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادراً عن النبي(ص) .
بل ولعل في جعل مدار الكفر على إنكار الضروري دلالة على ما ذكرنا من طريقية الإنكار للتكذيب بلحاظ بُعد خفاء ما هو أساس الدين وضرورياته على المنتحل للإسلام المعاشر مع المسلمين ، بخلاف غير الضروري حيث لا بُعد في خفائه ، وإلا فلا فرق في استلزام الإنكار للتكذيب بين الضروري وغيره ، وحينئذ فيمكن الجمع بين إطلاق كلامهم في كفر منكر الضروري وبين ما هو الظاهر من طريقية الإنكار للتكذيب بحمل الإطلاقات على المنكر المنتحل للإسلام المعاشر مع المسلمين برهة من عمره .
وقد يستدل على استتباع مجرد الإنكار للكفر بما رواه زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام)من قوله: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا ، ولكن يدفعه ظهور الرواية في الإنكار الناشئ عن العناد إذ الجحد ليس إلا عبارة عن ذلك ومن المعلوم عدم صلاحية مثله للدلالة على ثبوت الكفر بمحض الإنكار ، ومجرد كون الإنكار العنادي موجباً للكفر لا يقتضي تسرية الحكم إلى مطلق الإنكار ، ومن ذلك نقول أن الإنكار العنادي موجب للكفر مطلقاً ولو في غير الضروري .
هذا كله في صورة التمكن من تحصيل العلم والإعتقاد الجزمي ، ولقد عرفت وجوبه عليه فيما يرجع إلى الله جل شأنه وما يرجع إلى أنبيائه ورسله وحججه وأنه مع الإخلال به يكون معاقباً لا محالة .
نعم يبقى الكلام حينئذ في كفره وترتيب آثاره عليه من النجاسة وغيرها مع الإخلال بتحصيل المعرفة ، فنقول:
أما مع عدم إظهاره للشهادتين فلا إشكال في كفره وترتيب آثاره عليه من النجاسة وعدم الارث والمناكحة. وأما مع إظهار الشهادتين ففيه إشكال ينشأ من كفاية مجرد إظهار الشهادتين مع عدم الإنكار في الحكم بالإسلام ، ومن عدم كفايته ولزوم الإعتقاد في الباطن أيضاً .
ولكنه لا ينبغي التأمل في عدم كفايته ، فإن حقيقة الإسلام عبارة عن الإعتقاد بالواجب تعالى والتصديق بالنبي(عليه السلام)بكونه رسولاً من عند الله سبحانه ، وأن الإكتفاء بإظهار الشهادتين من جهة كونه أمارة على الإعتقاد في الباطن كما يظهر ذلك أيضاً من النصوص الكثيرة .
ولا ينافي ذلك ما يترائى في صدر الإسلام من معاملة النبي(ص)مع المنافقين معاملة الإسلام بمجرد إظهارهم الشهادتين مع علمه(ص)بعدم كونهم مؤمنين بالله ولا مصدقين برسوله واقعاً ، وأن إظهارهم الشهادتين كان لمحض الصورة ، إما لاجل خوفهم من القتل ، وإما لبعض المصالح المنظورة لهم كالوصول إلى مقام الرياسة والامال الدنيوية لما سمعوا وعلموا من الكهنة بارتقاء الإسلام وتفوقه على سائر المذاهب والأديان ، مع أنهم لم يؤمنوا بالله طرفة عين كما نطقت به الأخبار والاثار المروية عن الأئمة الأطهار .
إذ نقول إن في معاملة النبي(ص)والوصي مع هؤلاء المنافقين في الصدر الأول معاملة الإسلام بمحض إظهارهم الشهادتين وجوها ومصالح شتى:
منها: تكثير جمعية المسلمين وازديادهم في قبال الكفار وعبدة الأوثان الموجب لازدياد صولة المسلمين في أنظار المشركين .
ومنها: حفظ من في أصلابهم من المؤمنين الذين يوجدون بعد ذلك .
ومنها: تعليم الأمة في الأخذ بما يقتضيه ظاهر القول بالشهادتين في الكشف عن الإعتقاد في الباطن ، فإنه لو فتح مثل هذا الباب في الصدر الأول لقتل كل أحد صاحبه لاجل ما كان بينهم من العداوة في الجاهلية بدعوى أن اعتقاده على خلاف ما يظهره باللسان وأن إظهار الشهادتين كان لأجل الخوف من القتل أو الطمع في الشركة في أخذ الغنيمه ، ومثله لا يزيد المسلمين وشوكتهم إلا ضعفاً كما يشهد لذلك الآية الشريفة: وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ، وقضية أسامة بن زيد في ذلك معروفة .
ومنها: غير ذلك من المصالح التي لاحظها النبي(ص)مع علمه بكونهم حقيقة غير مؤمنين على ما نطق به الكتاب المبين في مواضع عديدة في قوله سبحانه: يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ، وقوله: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ... الخ. وغير ذلك من الآيات الكثيرة .
وأين ذلك وزماننا هذا الذي قد كثر فيه المسلمون كثرة عظيمة ، وحينئذ فلا يمكن الإلتزام بترتيب آثار الإسلام على مجرد إظهار الشهادتين مع العلم بعدم كون إظهارها إلا صورياً محضاً خصوصاً مع ظهور اعتبار القول في كونه لأجل الحكاية والطريقية عن الإعتقاد في الباطن ، بل لابد من ترتيب آثار الكفر عليه في الفرض المزبور .
هل أن الكافر يعرف الله تعالى ؟
مسالك الافهام:2/75
النية معتبرة في الكفارة لأنها عبادة تقع على وجوه مختلفة فلا يتميز المقصد منها بالنية لقوله(ص): إنما الأعمال بالنيات ويعتبر فيها نية القربة لقوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وهذا هو القدر المتفق عليه منها ... .
إذا تقرر ذلك فقد فرع المصنف على اعتبار نية القربة به أنه لا يصح من الكافر كتابياً كان أم غيره ، محتجاً بتعذر نية القربة في حقه ، وفيه نظر ، لأنه إن أراد بنية القربة المتعذرة منه نية إيقاع الفعل طلباً للتقرب إلى الله بواسطه نيل الثواب أو ما جرى مجرى ذلك سواء حصل له ما نواه أم لا، منعنا من تعذر نية القربة من مطلق الكافر ، لأن من اعترف منهم بالله تعالى وكان كفره بجحد نبوة النبي(ص)أو غيره من الأنبياء أو بعض شرايع الإسلام يمكن منه هذا النوع من التقرب ، وإنما يمتنع من الكافر المعطل الذي لا يعترف بوجود الله تعالى كالدهري وبعض عبدة الأصنام ، وإن أراد بها إيقاعه على وجه التقرب إلى الله تعالى بحيث يستحق بها الثواب طالبناه بدليل على اشتراط مثل ذلك وعارضناه بعبارة المخالف من المسلمين وعتقه فإنه لا يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقه ، وفي صحة عبادات غيره بحث فُرِد في محله .
وبالجملة فكلامهم في هذا الباب مختلف غير منقح ، لانهم تارة يحكمون ببطلان عبادة الكافر مطلقاً استناداً إلى تعذر نية القربة منه ، ومقتضى ذلك إرادة المعنى الثاني لأن ذلك هو المتعذر منه لا الأول ، وتارة يجوزون منه بعض العبادات كالعتق وسيأتي تجويز جماعة من الأصحاب له منه ، مع اشتراط القربة فيه نظراً إلى ما ذكرناه من الوجه في الأول .
وقد وقع الخلاف بينهم في وقفه وصدقته وعتقه المتبرع به ونحو ذلك من التصرفات المالية المعتبر فيها القربة ، واتفقوا على عدم صحة العبادات البدنية منه نظراً إلى أن المال يراعي فيه جانب المدفوع إليه ولو بفك الرقبة من الرق فيرجح فيه جانب القربات بخلاف العبادات البدنية ، ومن ثم ذهب بعض العامة إلى عدم اشتراط النية في العتق والإطعام واعتبرها في الصيام ، إلا أن هذا الإعتبار غير منضبط عند الأصحاب كما أشرنا إليه ، وسيأتي له في العتق زيادة بحث .
ثم عد إلى العبارة واعلم أن قوله ذمياً كان الكافر أو حربياً أو مرتداً لا يظهر للتسوية بين هذه الفرق مزية ، لأن الكافر المقر بالله تعالى لا يفرق فيه بين الذمي والحربي ، وإن افترقا في الإقرار بالجزية فإن ذلك أمر خارج عن هذا المطلق ، وإنما حق التسوية بين أصناف الكفار أن يقول سواء كان مقراً بالله كالكتابي أم جاحداً له كالوثني ، لأن ذلك هو موضع الإشكال ومحل الخلاف .
وأما ما قاله بعضهم من أن الكافر مطلقاً لا يعرف الله تعالى على الوجه المعتبر ولو عرفه لأقر بجميع رسله ودين الإسلام فهو كلام بعيد عن التحقيق جداً ، ولا ملازمة بين الأمرين كما لا ملازمة بين معرفة المسلم لله تعالى ومعرفة دين الحق من فرق الإسلام ، وكل حزب بما لديهم فرحون .
مسالك الافهام:2/153
قوله: ويصح اليمين من الكافر .. إلخ. إذا حلف الكافر بالله تعالى على شئ سواء كان مقراً بالله كاليهودي والنصراني ، أو من كفر بجحد فريضة من المسلمين ، أو غير مقر به كالوثني ، ففي انعقاد يمينه أقوال أشهرها الأول ، وهو الذي اختاره المصنف والشيخ في المبسوط وأتباعه وأكثر المتأخرين لوجود المقتضي وهو حلفه بالله تعالى مع باقي الشرايط وانتفاء المانع ، إذ ليس هناك إلا كفره وهو غير مانع لتناول الأدلة الدالة على انعقاد اليمين له من الآيات والأخبار، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشرايع فيدخلون تحت عموم قوله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ ، وغيره .
وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس: لا ينعقد مطلقاً لأن شرط صحتها الحلف بالله والكافر لا يعرف الله ، وفي إطلاق القولين معاً منع ظاهر .
وفصل العلامة جيداً في المختلف فقال: إن كان كفره باعتبار جهله بالله وعدم علمه به لم ينعقد يمينه لأنه يحلف بغير الله ، ولو عبر به فعبارته لغو لعدم اعتقاده ما يقتضي تعظيمه بالحلف به ، وإن كان جحده باعتبار جحد نبوة أو فريضة انعقدت يمينه ، لوجود المقتضي وهو الحلف بالله تعالى من عارف به إلى آخر ما اعتبر. وتوقف فعل المحلوف عليه لو كان طاعة ، والتكفير على تقدير الحنث على الإسلام لا يمنع أصل الإنعقاد ، لأنه مشروط بشرط زايد على أصل اليمين فلا ملازمة بينهما .
وفائدة الصحة تظهر في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة ، وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله لا في تدارك الكفارة ولو سبق الحنث الإسلام ، لأنها تسقط به عنه.
قوله: وفي صحة التكفير .. إلخ. إذا قلنا بصحة يمين الكافر على بعض الوجوه وحنث في يمينه وجبت عليه الكفارة مطلقاً ، ومذهب الأصحاب عدم صحتها منه حال الكفر لأنها من العبادات المشروطة بنية القربة ، وهي متعذرة في حقة سواء عرف الله أم لا ، لأن المراد من القربة ما يترتب عليه الثواب وهو منتف في حقه .
والمصنف&تردد في ذلك ، ووجه التردد ما ذكر ومن احتمال أن يراد بالقربة قصد التقرب إلى الله تعالى سواء حصل له القرب والثواب أم لا كما سبق تحقيقه في عتق الكافر ، ومن حيث أن بعض خصال الكفارة قد يشك في اعتبار نية القربة فيها كالإطعام والكسوة كما يقوله العامة فإنهم لا يعتبرون النية إلا في الصوم من خصالها ويجوزون الإطعام ونحوه بدونها ، ولكن مذهب الأصحاب اعتبار نية القربة في جميع خصالها ، وظاهرهم اختيار المعنى الأول من معاني القربة ، ومن ثم أبطلوا عبادات الكافر ، ومن اختار منهم صحة يمينه منع من صحة التكفير منه مادام على كفره ، فما تردد المصنف&فيه لا يظهر فيه خلاف معتد به .
بحث في معرفة الله تعالى عن طريق معرفة النفس
تفسير الميزان للطباطبائي:6/169 وما بعدها
في الغرر والدرر للآمدي عن علي(عليه السلام) قال: من عرف نفسه عرف ربه .
أقول ورواه الفريقان عن النبي أيضاً وهو حديث مشهور ، وقد ذكر بعض العلماء أنه من تعليق المحال ، ومفاده استحالة معرفة النفس لإستحالة الاحاطة العلمية بالله سبحانه. ورد أولاً ، بقوله(ص)في رواية أخرى: أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. وثانياً ، بأن الحديث في معنى عكس النقيض ، لقوله تعالى: وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ .
وفيه عنه(عليه السلام): قال الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله .
أقول: تقدم في البيان السابق معنى ارتباط الإخلاص وتفرعه على الإشتغال بمعرفة النفس .
وفيه عنه(عليه السلام): قال المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين .
أقول: الظاهر أن المراد بالمعرفتين المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات الآفاقية ، قال تعالى: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الأفَاقِ وَفِى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَئٍْ شَهِيدٌ . حم السجده : 53 ، وقال تعالى: وَفِى الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِى أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ . الذاريات : 21 .
وكون السير الأنفسي أنفع من السير الآفاقي لعله لكون المعرفة النفسانية لا تنفك عادةً من إصلاح أوصافها وأعمالها بخلاف المعرفة الآفاقية ، وذلك أن كون معرفة الآيات نافعة إنما هو لأن معرفة الآيات بما هي آيات موصلة إلى معرفة الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله ، ككونه تعالى حياً لا يعرضه موت ، وقادراً لا يشوبه ، عجز وعالماً لا يخالطه جهل ، وأنه تعالى هو الخالق لكل شئ ، والمالك لكل شئ ، والرب القائم على كل نفس بما كسبت ، خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم بل لينعم عليهم بما استحقوه ، ثم يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه ، ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى.
وهذه وأمثالها معارف حقة ، إذا تناولها الإنسان وأتقنها مثلت له حقيقه حياته وأنها حياة مؤبدة ذات سعادة دائمة أو شقوة لازمة ، وليست بتلك المتهوسة المنقطعة اللاهية اللاغية .
وهذا موقف علمي يهدي الإنسان إلى تكاليف ووظائف بالنسبة إلى ربه وبالنسبة إلى أبناء نوعه في الحياة الدنيا والحياة الآخرة ، وهي التي نسميها بالدين ، فإن السنة التي يلتزمها الإنسان في حياته ولا يخلو عنها حتى البدوي والهمجي ، إنما يضعها ويلتزمها أو يأخذها ويلتزمها لنفسه من حيث أنه يقدر لنفسه نوعاً من الحياة أي نوع كان، ثم يعمل بما استحسنه من السنة لاسعاد تلك الحياة، وهذا من الوضوح بمكان .
فالحياة التي يقدرها الإنسان لنفسه تمثل له الحوائج المناسبة لها فيهتدي بها إلى الأعمال التي تضمن عادة رفع تلك الحوائج فيطبق الإنسان عمله عليها ، وهو السنة أو الدين .
فتلخص مما ذكرنا أن النظر في الآيات الأنفسية والآفاقية ومعرفة الله سبحانه بها يهتدي الإنسان إلى التمسك بالدين الحق والشريعة الإلهية ، من جهه تمثيل المعرفة المذكورة الحياة الإنسانية المؤبدة له عند ذلك ، وتعلقها بالتوحيد والمعاد والنبوة .
وهذه الهداية إلى الإيمان والتقوى يشترك فيها الطريقان معاً ، أعني طريقى النظر إلى الآفاق والأنفس ، فهما نافعان جميعاً ، غير أن النظر إلى آيات النفس أنفع ، فإنه لا يخلو من العثور على ذات النفس وقواها وأدواتها الروحية والبدنية وما يعرضها من الإعتدال في أمرها أو طغيانها أو خمودها ، والملكات الفاضلة أو الرذيلة والأحوال الحسنة أو السيئة التي تقارنها .
واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر وسعادة أو شقاوة لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب ، فيشتغل بإصلاح الفاسد منها والإلتزام بصحيحها ، بخلاف النظر في الآيات الافاقية ، فإنه إن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف الأخلاق ورذائلها وتحليتها بالفضائل الروحية ، لكنه ينادي لذلك من مكان بعيد ، وهو ظاهر .
وللرواية معنى آخر أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقيقية في علم النفس ، وهو أن النظر في الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ذلك نظر فكري وعلم حصولي ، بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلية منها ، فإنه نظر شهودي وعلم حضوري ، والتصديق الفكري يحتاج في تحققه إلى نظم الأقيسه واستعمال البرهان وهو باق ما دام الإنسان متوجهاً إلى مقدماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها ، ولذلك يزول العلم بزوال الأشراف على دليله وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الإختلاف .
وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها فإنه من العيان ، فإذا اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه وشاهد فقرها إلى ربها وحاجتها في جميع أطوار وجودها وجد أمراً عجيباً ، وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبها وسائر صفاتها وأفعالها ، بما لا يتناهى بهاءً وسناءً وجمالاً وجلالاً وكمالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كل كمال .
وشاهد ما تقدم بيانه أن النفس الإنسانية لا شأن لها إلا في نفسها ، ولا مخرج لها من نفسها ، ولا شغل لها إلا السير الإضطراري في مسير نفسها ، وإنها منقطعة عن كل شئ كانت تظن أنها مجتمعه معه مختلطه به إلا ربها ، المحيط بباطنها وظاهرها وكل شئ دونها ، فوجدت أنها دائماً في خلا مع ربها وإن كانت في ملا من الناس .
وعند ذلك تنصرف عن كل شىء وتتوجه إلى ربها وتنسى كل شئ ، وتذكر ربها فلا يحجبه عنها حجاب ، ولا تستتر عنه بستر ، وهو حق المعرفة الذي قدر للإنسان .
وهذه المعرفة الأحرى بها أن تسمى بمعرفة الله بالله ... .
وأما المعرفة الفكرية التي يفيدها النظر في الآيات الآفاقية سواء حصلت من قياس أو حدس أو غير ذلك ، فإنما هي معرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية ، وجل الاله أن يحيط به ذهن أو تساوي ذاته صورة مختلقة اختلقها خلق من خلقه ، ولا يحيطون به علما .
وقد روي في الإرشاد والإحتجاج على ما في البحار ، عن الشعبي ، عن أمير المؤمنين(عليه السلام)في كلام له: إن الله أجل من أن يحتجب عن شئ أو يحتجب عنه شئ .
وفي التوحيد، عن موسى بن جعفر(عليه السلام)في كلام له: ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه ، احتجب بغير حجاب محجوب ، واستتر بغير ستر مستور ، لا إله إلا هو الكبير المتعال .
وفي التوحيد مسنداً عن عبد الاعلى، عن الصادق(عليه السلام)في حديث: ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال ، فهو مشرك ، لأن الحجاب والصورة والمثال غيره ، وإنما هو واحد موحد ، فكيف يوحد من زعم أنه يوحده بغيره ! إنما عرف الله من عرفه بالله ، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه ، إنما يعرف غيره.. الحديث .
والأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت(عليه السلام)في معنى ما قدمناه كثيرة جداً لعل الله يوفقنا لايرادها وشرحها في ماسيأتي إن شاء الله العزيز من تفسير سورة الاعراف.
فقد تحصل أن النظر في آيات الانفس أنفس وأغلى قيمةً ، وأنه هو المنتج لحقيقة المعرفة فحسب ، وعلى هذا فعده(عليه السلام)إياها أنفع المعرفتين لا معرفة متعينة إنما هو لأن العامة من الناس قاصرون عن نيلها ، وقد أطبق الكتاب والسنة وجرت السيرة الطاهرة النبوية وسيرة أهل بيته الطاهرين على قبول من آمن بالله عن نظر آفاقي وهو النظر الشائع بين المؤمنين. فالطريقان نافعان جميعاً ، لكن النفع في طريق النفس أتم وأغزر .
وفي الدرر والغرر عن علي(عليه السلام)قال: العارف من عرف نفسه فاعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها. أقول: أي أعتقها عن إسارة الهوى وَرِقِّية الشهوات .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: أعظم الحكمه معرفة الإنسان نفسه .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. أقول: وذلك لكونه أعلمهم بربه وأعرفهم به ، وقد قال الله سبحانه: إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .
وفيه ، عنه (عليه السلام) قال: أفضل العقل معرفة المرء بنفسه ، فمن عرف نفسه عقل ، ومن جهلها ضل .
وفيه ، عنه (عليه السلام) قال: عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها .
وفيه ، عنه (عليه السلام) قال: عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه .
وفيه ، عنه (عليه السلام) قال: غايه المعرفة أن يعرف المرء نفسه. أقول: وقد تقدم وجه كونها غاية المعرفة فإنها المعرفة حقيقة .
وفيه ، عنه (عليه السلام) قال: كيف يعرف غيره من يجهل نفسه .
وفيه ، عنه (عليه السلام) قال: كفى بالمرء معرفةً أن يعرف نفسه ، وكفى بالمرء جهلاً أن يجهل نفسه .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: من عرف نفسه تجرد. أقول: أي تجرد عن علائق الدنيا ، أو تجرد عن الناس بالإعتزال عنهم ، أو تجرد عن كل شئ بالإخلاص لله .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: من عرف نفسه جاهدها ، ومن جهل نفسه أهملها .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: من عرف نفسه جل أمره .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: من عرف نفسه كان لغيره أعرف ، ومن جهل نفسه كان بغيره أجهل .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة ، وخبط في الضلال والجهالات .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: معرفة النفس أنفع المعارف .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس .
وفيه ، عنه(عليه السلام)قال: لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شئ .
وفي تحف العقول ، عن الصادق(عليه السلام)في حديث: من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك ، ومن زعم أنه يعرف الله بالإسم دون المعنى فقد أقر بالطعن لأن الإسم محدث ، ومن زعم أنه يعبد الإسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكاً ، ومن زعم أنه يعبد بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب ، ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير ، وما قدروا الله حق قدره .
قيل له: فكيف سبيل التوحيد ؟ قال: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود ، إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. قيل وكيف يعرف عين الشاهد قبل صفته ؟ قال: تعرفه وتعلم علمه ، وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك من نفسك ، وتعلم أن ما فيه له وبه ، كما قالوا ليوسف إنك لانت يوسف ، قال أنا يوسف وهذا أخي ، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب . . . الحديث .
أقول: قد أوضحنا في ذيل قوله(عليه السلام): المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين ، الرواية الثانية من الباب أن الإنسان إذا اشتغل بآية نفسه وخلا بها عن غيرها انقطع إلى ربه من كل شئ ، وعقب ذلك معرفة ربه معرفة بلا توسيط وسط وعلماً بلا تسبيب سبب ، إذ الإنقطاع يرفع كل حجاب مضروب، وعند ذلك يذهل الإنسان بمشاهدة ساحة العظمة والكبرياء عن نفسه. وأحرى بهذه المعرفة أن تسمى معرفة الله بالله . . . وانكشف له عند ذلك من حقيقه نفسه أنها الفقيرة إلى الله سبحانه المملوكة له ملكاً لا تستقل بشئ دونه، وهذا هو المراد بقوله (عليه السلام): تعرف نفسك به ، ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك ، وتعلم أن ما فيه له وبه .
وفي هذا المعنى ما رواه المسعودي في إثبات الوصية عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال في خطبة له: فسبحانك ملات كل شئ وباينت كل شئ ، فأنت لا يفقدك شئ وأنت الفعال لما تشاء . . . إلى أن قال: سبحانك أي عين تقوم نصب بهاء نورك وترقى إلى نور ضياء قدرتك ، وأي فهم يفهم ما دون ذلك إلا أبصار كشفت عنها الأغطية وهتكت عنها الحجب العمية فرقت أرواحها على أطراف أجنحة الأرواح ، فناجوك في أركانك وولجوا بين أنوار بهائك ، ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك ، فسماهم أهل الملكوت زواراً ، ودعاهم أهل الجبروت عماراً .
وفي البحار عن إرشاد الديلمي وذكر بعد ذلك سندين لهذا الحديث وفيه: فمن عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال: أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل ، وذكراً لا يخالطه النسيان ، ومحبةً لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين. فإذا أحبني أحببته وأفتح عين قلبه إلى جلالي ولا أخفى عليه خاصة خلقي وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار ، حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم ، واسمعه كلامي وكلام ملائكتي وأعرفه السر الذي سترته عن خلقي، وألبسه الحياء حتى يستحيي منه الخلق كلهم ، ويمشئ على الأرض مغفوراً له ، واجعل قلبه واعياً وبصيراً ، ولا أخفى عليه شيئاً من جنة ولا نار ، وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة ، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء ، وأنومه في قبره وأنزل عليه منكراً ونكيراً حتى يسألاه ، ولا يرى غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلع ، ثم أنصب له ميزانه وأنشر ديوانه ، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشوراً ، ثم لا أجعل بيني وبينه ترجماناً. فهذه صفات المحبين.
يا أحمد إجعل همك هماً واحداً ، واجعل لسانك لساناً واحداً ، واجعل بدنك حياً لا يغفل أبداً ، من يغفل عني لا أبالي بأي واد هلك .
والروايات الثلاثة الأخيرة وإن لم تكن من أخبار هذا البحث المعقود على الإستقامة ، إلا أنا إنما أوردناها ليقضي الناقد البصير بما قدمناه من أن المعرفة الحقيقية لا تستوفي بالعلم الفكري حق استيفائها ، فإن الروايات تذكر أموراً من المواهب الإلهية المخصوصة بأوليائه لا ينتجها السير الفكري البتة. وهي أخبار مستقيمة صحيحة يشهد على صحتها الكتاب الإلهي على ما سنبين ذلك فيما سيوافيك من تفسير سوره الأعراف إن شاء الله العزيز... .
وأما سائر الفرق المذهبية من الهنود ، كالجوكية أصحاب الأنفاس والأوهام ، وكأصحاب الروحانيات ، وأصحاب الحكمة ، وغيرهم ، فلكل طائفة منهم رياضات شاقة عملية لا تخلو عن العزلة وتحريم اللذائذ الشهوانية على النفس .
وأما البوذية فبناء مذهبهم على تهذيب النفس ومخالفة هواها وتحريم لذائذها عليها للحصول على حقيقة المعرفة ، وقد كان هذا هو الطريقة التي سلكها بوذا نفسه في حياته فالمنقول أنه كان من أبناء الملوك أو الرؤساء فرفض زخارف الحياة وهجر أريكة العرش إلى غابة موحشة لزمها في ريعان شبابه واعتزل الناس وترك التمتع بمزايا الحياة وأقبل على رياضة نفسه والتفكر في أسرار الخلقة ، حتى قذفت المعرفة في قلبه وسنه إذ ذاك ستة وثلاثون ، وعند ذاك خرج إلى الناس فدعاهم إلى ترويض النفس وتحصيل المعرفة ، ولم يزل على ذلك قريباً من أربع وأربعين سنة على ما في التواريخ .
وأما الصابئون ، ونعني بهم أصحاب الروحانيات فهم وإن أنكروا أمر النبوة غير أن لهم في طريق الوصول إلى كمال المعرفة النفسانية طرقاً لا تختلف كثيراً عن طرق البراهمة والبوذيين ، قالوا على ما في الملل والنحل: أن الواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية ، ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية والغضبية ، حتى يحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات ، فنسأل حاجاتنا منهم ونعرض أحوالنا عليهم ونصبوا في جميع أمورنا إليهم ، فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم .
وهذا التطهير ليس يحصل إلا باكتسابنا ورياضتنا ، وفطامنا أنفسنا عن دنيئات الشهوات ، استمداداً من جهة الروحانيات ، والإستمداد هو التضرع والإبتهال بالدعوات وإقامة الصلوات ، وبذل الزكوات ، والصيام عن المطعومات والمشروبات ، وتقريب القرابين والذبائح ، وتبخير البخورات وتعزيم العزائم ، فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة. انتهى .
وهؤلاء وإن اختلفوا فيما بين أنفسهم بعض الإختلاف في العقائد العامة الراجعة إلى الخلق والايجاد لكنهم متفقوا الرأي في وجوب ترويض النفس للحصول على كمال المعرفة وسعادة النشأة .
وأما المانوية من الثنوية ، فاستقرار مذهبهم على كون النفس من عالم النور العلوي وهبوطها إلى هذه الشبكات المادية المظلمة المسماة بالأبدان ، وأن سعادتها وكمالها التخلص من دار الظلمة إلى ساحة النور ، إما اختياراً بالترويض النفساني ، وإما اضطراراً بالموت الطبيعي المعروف .
وأما أهل الكتاب ونعني بهم اليهود و النصارى والمجوس ، فكتبهم المقدسة وهي العهد العتيق والعهد الجديد وأوستا ، مشحونة بالدعوة إلى إصلاح النفس وتهذيبها ومخالفة هواها. ولاتزال كتب العهدين تذكر الزهد في الدنيا والإشتغال بتطهير السر ، ولا يزال يتربى بينهم جم غفير من الزهاد وتاركي الدنيا ، جيلاً بعد جيل وخاصة النصارى فإن من سننهم المتبعة الرهبانية. وقد ذكر أمر رهبانيتهم في القرآن الشريف قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسيِنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ. المائده : 82 ، وقال تعالى: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ، الحديد : 27 . كما ذكر المتعبدون من اليهود في قوله: لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ، يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. آل عمران : 114 .
وأما الفرق المختلفة من أصحاب الإرتياضات والأعمال النفسية كأصحاب السحر والسيمياء ، وأصحاب الطلسمات وتسخير الأرواح والجن وروحانيات الحروف والكواكب وغيرها ، وأصحاب الإحضار وتسخير النفوس ، فلكل منهم ارتياضات نفسية خاصة تنتج نوعاً من السلطة على أمر النفس .
وجملة الأمر على ما يتحصل من جميع ما مر: أن الوجهة الأخيرة لجميع أرباب الأديان والمذاهب والأعمال هو تهذيب النفس بترك هواها والإشتغال بتطهيرها من شوب الأخلاق والأحوال غير المناسبة للمطلوب .
لعلك ترجع وتقول إن الذي ثبت من سنن أرباب المذاهب والطرق وسيرهم هو الزهد في الدنيا وهو غير مسألة معرفة النفس أو الإشتغال بأمر النفس بالمعنى الذي تقدم البحث عنه. وبلفظ أوضح: الذي يندب إليه الأديان والمذاهب التي تدعو إلى العبودية بنحو أن يتزهد الإنسان نوع تزهد في الدنيا بإتيان الأعمال الصالحة وترك الهوى والاثام ورذائل الأخلاق ليتهيأ بذلك لأحسن الجزاء ، إما في الآخرة كما تصرح به الأديان النبوية كاليهودية والنصرانية والإسلام ، أو في الدنيا كما استقر عليه دين الوثنية ومذهب التناسخ وغيرهما ، فالمتعبد على حسب الدستور الديني يأتي بما ندب إليه من نوع التزهد من غير أن يخطر بباله أن هناك نفساً مجردة وأن لها نوعاً من المعرفة فيه سعادتها وكمال وجودها .
وكذلك الواحد من أصحاب الرياضات على اختلاف طرقها وسننها إنما يرتاض بما يرتاض من مشاق الأعمال ولا همَّ له في ذلك إلا حيازه المقام الموعود فيها والتسلط على نتيجه العمل كنفوذ الإرادة مثلاً ، وهو في غفلة من أمر النفس المذكور من حين يأخذ في عمله إلى حين يختمه. على أن في هؤلاء من لا يرى في النفس إلا أنها أمر مادي طبيعي كالدم أو الروح البخار أو الأجزاء الأصلية ، ومن يرى أن النفس جسم لطيف مشاكل للبدن العنصري حال فيه وهو الحامل للحياة ، فكيف يسوغ القول بكون الجميع يرومون بذلك أمر معرفة النفس .
لكنه ينبغي لك أن تتذكر ما تقدم ذكره أن الإنسان في جميع هذه المواقف التي يأتي فيها بأعمال تصرف النفس عن الإشتغال بالأمور الخارجية والتمتعات المتفننة المادية إلى نفسها ، للحصول على خواص وآثار لا توصل إليها الأسباب المادية والعوامل الطبيعية العادية ، لا يريد إلا الإنفصال عن العلل والأسباب الخارجية والإستقلال بنفسه للحصول على نتائج خاصة لا سبيل للعوامل المادية العادية إليها .
فالمتدين المتزهد في دينه يرى أن من الواجب الإنساني أن يختار لنفسه سعادته الحقيقية ، وهي الحياه الطيبة الأخروية عند المنتحلين بالمعاد ، والحياة السعيدة الدنيوية التي تجمع له الخير وتدفع عنه الشر عند المنكرين له كالوثنية وأصحاب التناسخ ، ثم يرى أن الإسترسال في التمتعات الحيوانية لا تحوز له سعادته ولا تسلك به إلى غرضه ، فلا محيص له عن رفض الهوى وترك الإنطلاق إلى كل ما تتهوسه نفسه بأسبابها العادية في الجملة ، والإنجذاب إلى سبب أو أسباب فوق الأسباب المادية العادية بالتقرب إليه والإتصال به ، وأن هذا التقرب والإتصال إنما يتأتي بالخضوع له والتسليم لامره ، وذلك أمر روحي نفساني لا ينحفظ إلا بأعمال وتروك بدنية ، وهذه هي العبادة الدينية من صلاة ونسك أو ما يرجع إلى ذلك .
فالأعمال والمجاهدات والإرتياضات الدينية ترجع جميعاً إلى نوع من الإشتغال بأمر النفس ، والإنسان يرى بالفطرة أنه لا يأخذ شيئاً ولا يترك شيناً إلا لنفع نفسه، وقد تقدم أن الإنسان لا يخلو ولا لحظة من لحظات وجوده من مشاهدة نفسه وحضور ذاته ، وأنه لا يخطي في شعوره هذا البتة ، وإن أخطأ فإنما يخطي في تفسيره بحسب الرأي النظري والبحث الفكري .
فظهر بهذا البيان أن الأديان والمذاهب على اختلاف سننها وطرقها تروم الإشتغال بأمر النفس في الجملة ، سواء علم بذلك المنتحلون بها أم لم يعلموا. وكذلك الواحد من أصحاب الرياضات والمجاهدات وإن لم يكن منتحلاً بديلاً ولا مؤمناً بأمر حقيقة النفس ، لا يقصد بنوع رياضته التي يرتاض بها إلا الحصول على نتيجتها الموعودة له ، وليست النتيجة الموعودة مرتبطة بالأعمال والتروك التي يأتي بها ارتباطاً طبيعياً نظير الإرتباط الواقع بين الأسباب الطبيعية ومسبباتها ، بل هو ارتباط إرادي غير مادي متعلق بشعور المرتاض وإرادته المحفوظين بنوع العمل الذي يأتي به ، دائر بين نفس المرتاض وبين النتيجة الموعودة .
فحقيقة الرياضة المذكورة هي تأييد النفس وتكميلها في شعورها وإرادتها للنتيجة المطلوبة. وإن شئت قلت: أثر الرياضة أن تحصل للنفس حالة العلم بأن المطلوب مقدور لها ، فإذا صحت الرياضة وتمت صارت بحيث لو أرادت المطلوب مطلقاً أو أرادته على شرائط خاصة ، كإحضار الروح للصبي غير المراهق في المرآة ، حصل المطلوب .
وإلى هذا الباب يرجع معنى ما روي: أنه ذكر عند النبي(ص)أن بعض أصحاب عيسى(عليه السلام)كان يمشئ على الماء فقال(ص): لو كان يقينه أشد من ذلك لمشى على الهواء ، فالحديث كما ترى يومئ إلى أن الأمر يدور مدار اليقين بالله سبحانه وإمحاء الأسباب الكونية عن الإستقلال في التأثير .
فإلى أي مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة المطلقة الإلهية انقادت له الأشياء على قدره ، فافهم ذلك .
ومن أجمع القول في هذا الشأن قول الصادق(عليه السلام): ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. وقال(ص)في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات .
فقد تبين أن الاثار الدينية للاعمال والعبادات وكذلك آثار الرياضات والمجاهدات إنما تستقر الرابطة بينها وبين النفس الإنسانية بشؤونها الباطنية ، فالإشتغال بشئ منها اشتغال بأمر النفس... .
إياك أن يشتبه عليك الأمر فتستنتج من الأبحاث السابقة أن الدين هو العرفان والتصوف ، أعني معرفة النفس كما توهمه بعض الباحثين من الماديين ، فقسم المسلك الحيوي الدائر بين الناس إلى قسمين المادية والعرفان وهو الدين. وذلك أن الذي يعقد عليه الدين أن للانسان سعادة حقيقية ليس ينالها إلا بالخضوع لما فوق الطبيعة ، ورفض الإقتصار على التمتعات المادية .
وقد أنتجت الابحاث السابقة أن الأديان أيما كانت من حق أو باطل تستعمل تربية الناس وسوقهم إلى السعادة التي تعدهم إياها ، وتدعوهم إليها إصلاح لنفس وتهذيبها إصلاحاً وتهذيباً يناسب المطلوب. وأين هذا من كون عرفان النفس هو الدين .
فالدين يدعو إلى عبادة الاله سبحانه من غير واسطة ، أو بواسطة الشفعاء والشركاء ، لأن فيها السعادة الإنسانية والحياة الطيبة التي لا بغية للإنسان دونها ، ولا ينالها الإنسان ولن ينالها إلا بنفس طاهرة مطهرة من ألواث التعلق بالماديات والتمتعات المرسلة الحيوانية ، فمست الحاجة إلى أن يدرج في أجزاء دعوته إصلاح النفس وتطهيرها ليستعد المنتحل به المتربي في حجره للتلبس بالخير والسعادة ولا يكون كمن يتناول الشئ بإحدى يديه ويدفعه بالأخرى .
فالدين أمر وعرفان النفس أمر آخر وراءه وإن استلزم الدين العرفان نوعاً من الإستلزام .
وبنظير البيان يتبين أن طرق الرياضة والمجاهدة المسلوكة لمقاصد متنوعة غريبة عن العادة أيضاً غير عرفان النفس وإن ارتبط البعض بالبعض نحواً من الإرتباط .
نعم لنا أن نقضي بأمر وهو: إن عرفان النفس بأي طريق من الطرق فرض السلوك إليه إنما هو أمر مأخوذ من الدين ، كما أن البحث البالغ الحر يعطي أن الأديان على اختلافها وتشتتها إنما انشعبت هذه الانشعابات من دين واحد عريق تدعو إليه الفطرة الإنسانية وهو دين التوحيد .
فإنا إذا راجعنا فطرتنا الساذجة بالأغماض عن التعصبات الطارئة علينا بالوراثة من أسلافنا أو بالسراية من أمثالنا لم نرتب في أن العالم على وحدته في كثرته وارتباط أجزائه في عين تشتتها ، ينتهي إلى سبب واحد فوق الأسباب وهو الحق الذي يجب الخضوع لجانبه ، وترتيب السلوك الحيوي على حسب تدبيره وتربيته ، وهو الدين المبني على التوحيد .
والتأمل العميق في جميع الأديان والنحل يعطي أنها مشتملة نوع اشتمال على هذا الروح الحي حتى الوثنية والثنوية ، وإنما وقع الإختلاف في تطبيق السنة الدينية على هذا الأصل والإصابة والخطأ فيه ، فمن قائل مثلاً أنه أقرب إلينا من حبل الوريد وهو معنا أينما كنا ليس لنا من دونه من ولي ولا شفيع ، فمن الواجب عبادته وحده من غير إشراك ، ومن قائل أن تسفل الإنسان الأرضي وخسة جوهره لا يدع له مخلصاً إلى الإتصال بذاك الجناب، وأين التراب ورب الأرباب فمن الواجب أن نتقرب إلى بعض عباده المكرمين المتجردين عن جلباب المادة ، الطاهرين المطهرين من ألواث الطبيعة ، وهم روحانيات الكواكب ، أو أرباب الأنواع ، أو المقربون من الإنسان ، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإذ كانوا غائبين عن حواسنا متعالين عن جهاتنا كان من الواجب أن نجسدهم بالأنصاب والأصنام حتى يتم بذلك أمر التقرب العبادي . وعلي هذا القياس في سائر الأديان والملل ، فلا نجد في متونها إلا ما هو بحسب الحقيقة نحو توجيه لتوحيد الاله عز اسمه .
ومن المعلوم أن السنن الدائرة بين الناس وإن انشعبت أي انشعاب واختلفت أي إختلاف شديد ، فإنها تميل إلى التوحد إذا رجعنا إلى سابق عهودها القهقرى ، وتنتهي بالآخرة إلى دين الفطرة الساذجة الإنسانية وهو التوحيد .
فدين التوحيد أبو الأديان وهي أبناء له صالحة أو طالحة .
ثم إن الدين الفطري إنما يعتبر أمر عرفان النفس ليتوصل به إلى السعادة الإنسانية التي يدعو إليها ، وهي معرفة الإله التي هي المطلوب الأخير عنده . وبعبارة أخرى: الدين إنما يدعو إلى عرفان النفس دعوة طريقية لا غائية ، فإن الذوق الديني لا يرتضي الإشتغال بأمر إلا في سبيل العبودية ، وإن الدين عند الله الإسلام ولا يرضى لعباده الكفر ، فكيف يرضى بعرفان النفس إذا استقل بالمطلوبية .
ومن هنا يظهر أن العرفان ينتهي إلى أصل الدين الفطري إذ ليس هو بنفسه أمراً مستقلاً تدعو إليه الفطرة الإنسانية ، حتى تنتهي فروعه وأغصانه إلى أصل واحد هو العرفان الفطري .
ويمكن أن يستأنس في ذلك بأمر آخر وهو: أن الإنسانية وإن اندفعت بالفطرة إلى الإجتماع والمدنية لاسعاد الحياة ، وأثبت النقل والبحث أن رجالاً أو أقواماً اجتماعيين دعوا إلى طرائق قومية أو وضعوا سنناً اجتماعية وأجروها بين أممهم ، كسنن القبائل ، والسنن الملوكية ، والديمقراطية ، ونحوها ، ولم يثبت بنقل أو بحث أن يدعو إلى عرفان النفس وتهذيب أخلاقها أحد من غير أهل الدين في طول التاريخ البشري .
نعم من الممكن أن يكون بعض أصحاب هذه الطرق غير الدينية ، كأصحاب السحر والأرواح ونحوهما إنما تنبه إلى هذا النوع من عرفان النفس من غير طريق الدين ، لكن لا من جهة الفطرة ، إذ الفطرة لا حكم لها في ذلك كما عرفت ، بل من جهه مشاهدة بعض الآثار النفسانية الغريبة على سبيل الإتفاق ، فتتوق نفسه إلى الظفر بمنزلة نفسانية يملك بها أعمالاً عجيبة وتصرفات في الكون نادرة تستغربها النفوس ، فيدفعه هذا التوقان إلى البحث عنه والسلوك إليه ، ثم السلوك بعد السلوك يمهد السبيل إلى المطلوب ويسهل الوعر منه .
يحكى عن كثير من صلحائنا من أهل الدين أنهم نالوا في خلال مجاهداتهم الدينية كرامات خارقة للعادة ، وحوادث غريبة اختصوا بها من بين أمثالهم كتمثل أمور لأبصارهم غائبة عن أبصار غيرهم ، ومشاهدة أشخاص أو وقائع لا يشاهدها حواس من دونهم من الناس ، واستجابة للدعوة وشفاء المريض الذي لا مطمع لنجاح المداواة فيه ، والنجاة من المخاطر والمهالك من غير طريق العادة .
وقد يتفق نظائر ذلك لغير أهل الصلاح إذا كان ذا نية صادقة ونفس منقطعة ، فهؤلاء يرون ما يرون وهم على غفلة من سببه القريب ، وإنما يسندون ذلك إلى الله سبحانه من غير توسيط وسط .
وإستناد الأمور إليه تعالى وإن كان حقاً لا محيص عن الإعتراف به ، لكن نفي الأسباب المتوسطة مما لا مطمع فيه .
وربما أحضر الروحي روح أحد من الناس في مرآة أو ماء ونحوه بالتصرف في نفس صبي على ما هو المتعارف ، وهو كغيره يرى أن الصبي إنما يبصره بالبصر الحسي ، وأن بين أبصار سائر الناظرين وبين الروح المحضر حجاباً مضروباً ، لو كشف عنه لكانوا مثل الصبي في الظفر بمشاهدته .
وربما وجدوا الأرواح المحضرة أنها تكذب في أخبارها فيكون عجباً لأن عالم الأرواح عالم الطهارة والصفاء لا سبيل للكذب والفرية والزور إليه .
وربما أحضروا روح إنسان حي فيستنطقونه بأسراره وضمائره وصاحب الروح في حالة اليقظة مشغول بأشغاله وحوائجه اليومية لا خبر عنده من أن روحه محضر مستنطق يبث من القول ما لا يرضى هو ببثه .
وربما نوم الإنسان تنويماً مغناطيسياً ، ثم لقن بعمل حتى ينعم بقبوله ، فإذا أوقظ ومضى لشأنه أتى بالعمل الذي لقنه على الشريطة التي أريد بها وهو غافل عما لقنوه ، وعن إنعامه بقبوله .
وبعض الروحيين لما شاهدوا صوراً روحية تماثل الصور الإنسانية أو صور بعض الحيوان ظنوا أن هذه الصور في عالم المادة وظرف الطبيعة المتغيرة ، وخاصة بعض من لا يرى لغير الأمر المادي وجوداً ، حتى حاول بعض هؤلاء أن يخترع أدوات صناعية يصطاد بها الأرواح ! كل ذلك استناداً منهم إلى فرضية افترضوها في النفس أنها مبدأ مادي أو خاصة لمبدأ مادي ، يفعل بالشعور والإرادة ، مع أنهم لم يحلوا مشكلة الحياة والشعور حتى اليوم .
ونظير هذه الفرضية فرضية من يرى أن الروح جسم لطيف مشاكل للبدن العنصري في هيئاته وأشكاله ، لما وجدوا أن الإنسان يرى نفسه في المنام وهو على هيئته في اليقظه ، وربما يمثل لأرباب المجاهدات صور أنفسهم قبالاً خارج أبدانهم وهي مشاكلة للصورة البدنية مشاكلة تامة ، فحكموا أن الروح جسم لطيف حال البدن العنصري مادام الإنسان حياً فإذا فارق البدن كان هو الموت .
وقد فاتهم أن هذه صورة إدراكية قائمة بشعور الإنسان نظيره صورته التي يدركها من بدنه ، ونظيره صور سائر الأشياء الخارجة المنفصلة عن بدنه ، وربما تظهر هذه الصورة المنفصلة لبعض أرباب المجاهدة أكثر من واحدة ، أو في هيئة غير هيئة نفسه ، وربما يرى نفسه عين نفس غيره من أفراد الناس ، فإذا لم يحكموا في هذه الصور المذكور أنها هي صورة الروح ، فجدير بهم أن لا يحكموا في الصورة الواحدة المشاكلة التي تتراءى لارباب المجاهدات أنها صورة الروح .
وحقيقة الأمر أن هؤلاء نالوا شيئاً من معارف النفس وفاتهم معرفة حقيقتها ، فأخطاوا في تفسير ما نالوه ، وضلوا في توجيه أمره . والحق الذي يهدي إليه البرهان والتجربة أن حقيقة النفس التي هي هذا الشعور المتعقل المحكي عنه بقولنا ( أنا ) أمر مغاير في جوهره لهذه الأمور المادية كما تقدم ، وأن أقسام شعوره وأنواع إدراكاته من حس أو خيال أو تعقل من جهة كونها مدركات إنما هي متقررة في عالمه وظرفه غير الخواص الطبيعية الحاصلة في أعضاء الحس والإدراك من البدن ، فإنها أفعال وانفعالات مادية فاقدة في نفسها للحياة والشعور ، فهذه الأمور المشهودة الخاصة بالصلحاء وأرباب المجاهدات والرياضات غير خارجة عن حيطة نفوسهم ، وإنما الشأن في أن هذه المعلومات والمعارف كيف استقرت في النفس وأين محلها منها ، وأن للنفس سمة علية لجميع الحوادث والأمور المرتبطة بها ارتباطاً ما. فجميع هذه الأمور الغريبة المطاوعة لأهل الرياضة والمجاهدة ، إنما ترتضع من إرادتهم ومشيئتهم ، والإرادة ناشئة من الشعور، فللشعور الإنساني دخل في جميع الحوادث المرتبطة به والأمور المماسة له .
فمن الحري أن نقسم المشتغلين بعرفان النفس في الجملة إلى طائفتين ، إحداهما: المشتغلون بالإشتغال بإحراز شئ من آثار النفس الغريبة الخارجة عن حومة المتعارف من الأسباب والمسببات المادية كأصحاب السحر والطلسمات وأصحاب تسخير روحانيات الكواكب والموكلين على الأمور والجن وأرواح الآدميين وأصحاب الدعوات والعزائم ونحو ذلك .
والثانية: المشتغلون بمعرفة النفس بالانصراف عن الأمور الخارجة عنها والانجذاب نحوها ، للغور فيها ومشاهدة جوهرها وشؤونها كالمتصوفة على اختلاف طبقاتهم ومسالكهم .
وليس التصوف مما أبدعه المسلمون من عند أنفسهم لما ( ثبت ) أنه يوجد بين الأمم التي تتقدمهم في النشوء كالنصارى وغيرهم ، حتى الوثنية من البرهمانية والبوذية ، ففيهم من يسلك الطريقة حتى اليوم ، بل هي طريقة موروثة ورثوها من أسلافهم. لكن لا بمعنى الأخذ والتقليد العادي كوراثة الناس ألوان المدنية بعضهم من بعض ، وأمة منهم متأخرة من أمة منهم متقدمة ، كما جرى على ذلك عده من الباحثين الأديان والمذاهب وذلك لما عرفت في الفصول السابقة من أن دين الفطرة يهدي إلى الزهد ، والزهد يرشد إلى عرفان النفس .
فاستقرار الدين بين أمة وتمكنه من قلوبهم يعدهم ويهيؤهم لأن تنشأ بينهم طريقة عرفان النفس لا محالة ، ويأخذ بها بعض من تمت في حقه العوامل المقتضية لذلك. فمكث الحياة الدينية في أمة من الأمم برهه معتداً بها ينشئ بينهم هذه الطريقة لا محالة صحيحة أو فاسدة ، وإن انقطعوا عن غيرهم من الأمم الدينية كل الإنقطاع. وما هذا شأنه لا ينبغي أن يعد من السنن الموروثة التي يأخذها جيل عن جيل.
ثم ينبغي أن نقسم أصحاب القسم الثاني من القسمين المتقدمين وهم أهل العرفان حقيقة إلى طائفتين: فطائفة ، منهم يسلكون الطريقة لنفسها فيرزقون شيئاً من معارفها من غير أن يتم لهم تمام المعرفة لها ، لأنهم لما كانوا لا يريدون غير النفس فهم في غفلة عن أمر صانعها وهو الله عز اسمه الذي هو السبب الحق الأخذ بناصية النفس في وجودها وآثار وجودها. وكيف يسع الإنسان تمام معرفة شئ مع الذهول عن معرفة أسباب وجوده وخاصة السبب الذي هو سبب كل سبب ، وهل هو إلا كمن يدعي معرفة السرير على جهل منه بالنجار وقدومه ومنشاره ، وغرضه في صنعه ، إلى غير ذلك من علل وجود السرير .
ومن الحري بهذا النوع من معرفة النفس أن يسمى كهانة بما في ذيله من الحصول على شئ من علوم النفس وآثارها .
وطائفة منهم يقصدون طريقة معرفة النفس لتكون ذريعة لهم إلى معرفة الرب تعالى ، وطريقتهم هذه هي التي يرتضيها الدين في الجملة وهي أن يشتغل الإنسان بمعرفة نفسه بما أنها آية من آيات ربه وأقرب آية ، وتكون النفس طريقاً مسلوكاً والله سبحانه هو الغاية التي يسلك إليها ، وأن إلى ربك المنتهى .
وهؤلاء طوائف مختلفة ذووا مذاهب متشتتة في الأمم والنحل ، وليس لنا كثير خبرة بمذاهب غير المسلمين منهم وطرائقهم التي يسلكونها. وأما المسلمون فطرقهم فيها كثيرة ربما انهيت بحسب الأصول إلى خمس وعشرين سلسلة ، تنشعب من كل سلسلة منها سلاسل جزئية أخر ، وقد استندوا فيها إلا واحدة ، إلى علي عليه أفضل السلام .
وهناك رجال منهم لا ينتمون إلى واحدة من هذه السلاسل ويسمون الأويسية نسبة إلى أويس القرني ، وهناك آخرون منهم لا يتسمون بإسم ولا يتظاهرون بشعار .
ولهم كتب ورسائل مسفورة ترجموا فيها عن سلاسلهم وطرقهم والنواميس والآداب التي لهم عن رجالهم ، وضبطوا فيها المنقول من مكاشفاتهم ، وأعربوا فيها عن حججهم ومقاصدهم التي بنوها عليها، من أراد الوقوف عليها فليراجعها.
وأما البحث عن تفصيل الطرق والمسالك وتصحيح الصحيح ونقد الفاسد ، فله مقام آخر ، وقد تقدم في الجزء الخامس من هذا الكتاب بحث لا يخلو عن نفع في هذا الباب ، فهذه خلاصه ما أردنا إيراده من البحث المتعلق بمعنى معرفة النفس .
واعلم أن عرفان النفس بغية عملية لا يحصل تمام المعرفة بها إلا من طريق السلوك العملي دون النظري .
وأما علم النفس الذي دَوَّنه أرباب النظر من القدماء فليس يغني من ذلك شيئاً ، وكذلك فن النفس العملي الذي دونه المتأخرون حديثاً ، فإنما هو شعبة من فن الاخلاق على ما دونه القدماء ، والله الهادي. انتهى .
الموقف الفقهي من الدعوة إلى معرفة الله تعالى عن طريق معرفة النفس
ما ذكره صاحب الميزان&من الطريقين لمعرفة الله تعالى: طريق النظر في الآفاق وطريق النظر في الأنفس ، مطلب شائع بين العرفانيين والمتصوفة، والظاهر أنهم أخذوه من قوله تعالى ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الأفَاقِ وَفِى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ) ولابد هنا من تسجيل الملاحظات التالية:
أولاً: وردت أحاديث شريفة في تفسير الآية المذكورة بأنها من علامات ظهور الإمام المهدي(عليه السلام)أو من الاحداث التي تظهر على يده ، وأن المقصود بالآفاق آفاق الأرض حيث ( تنتقض الأطراف عليهم ) أي على الجبارين قرب ظهوره (عليه السلام). ويؤيد ذلك سين الإستقبال في الآية ، التي تخبر عن حدث في المستقبل ، وإلا لقال ( ولقد أريناهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) مثلاً. أو قال ( أو لم ينظروا في الآفاق ) كما قال تعالى (أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ) .
ثانياً: لا شك أن النظر في ملكوت السماوات والأرض ، أي فيما يمكن للإنسان معرفته وفهمه وأخذ العبرة منه ، أمر محبوب شرعاً وموصل إلى معرفة الله تعالى وزيادة الإيمان به. قال تعالى: أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَئٍْ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَىِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ الاعراف : 185 ، ولكن نفس الإنسان جزء من هذا الملكوت وواحدة من هذه الآفاق ، وليست طريقاً في مقابل بقية الآفاق .
ثالثاً: لم أجد سنداً للحديث الذي ذكره ( المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين ) ومن البعيد أن يكون حديثاً شريفاً ، وعلى فرض صحته لا يصح تفسيره بما ذكره &فإن المقابل لمعرفة الله بالنفس معرفة الله بالله تعالى ، أو معرفة الله بأنبيائه وأوليائه ، أو معرفة الله بآياته غير النفس..فمن أين جعل&المعرفة التي تقابل معرفة النفس ، معرفة الآفاق وحصره المقابلة بها. ثم إذا كانت المعرفة بالسير الآفاقي تشمل معرفة الله بالله تعالى وبأوليائه صلوات الله عليهم ، فكيف يصح تفضيل معرفته عن طريق النفس على هذه المعرفة ؟!
رابعاً: تقدم بحث الحد الأدنى الواجب من معرفة الله تعالى ، ولم يتعرض الفقهاء والمتكلمون إلى طرقه ، ولم يفضلوا بعضها على بعض. كما تقدم أن معرفة الله هي من صنعه تعالى في نفس الإنسان وألطافه به ، ولا صنع للإنسان فيها .
خامساً: لا شك في صحة ما ذكره&من أن تزكية النفس وتهذيبها من الرذائل والشهوات والتعلق بحطام الدنيا ومتاعها ، مقدمة لازمة لتحقيق هدف الدين الذي هو عبادة الله تعالى. قال تعالى ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ) وقال تعالى ( هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ) ولكن الوارد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة هو تزكية النفس وجهاد النفس ومخالفة النفس ، وهي أمور عملية غير ما يطرحه المتصوفة والعرفاء من معرفة النفس ، وإن كانت تزكية النفس تتوقف على قدر من معرفتها .
سادساً: لو سلمنا أن تزكية النفس ومخالفتها وجهادها هي نفس معرفة النفس التي طرحها المتصوفة والعرفاء ، ولكن الدعوة إلى معرفة الله تعالى وطاعته عن طريق معرفة النفس على إجمالها وإهمالها تتضمن مخاطر عديدة لا يمكن قبولها ، لأنها تتسع للضد والنقيض في الأساليب والاهداف والقدوات . . جميعاً .
فبعض الدعوات إلى معرفة الله تعالى عن طريق معرفة النفس تتبنى العزلة والرهبانية ، وبعضها يتبنى إصلاح النفس والمجتمع والحكم. وبعضها يدعو إلى التقيد بأحكام الشريعة المقررة في هذا المذهب أو ذاك . . . وبعضها يدعو إلى تقليد الأستاذ شيخ الطريقة أو أستاذ الأخلاق وما شابه، دون الحاجة إلى أخذ أي مفهوم أو حكم شرعي من غيره !
وبعضها يدعي أنه يتصل بالله تعالى عن طريق المعرفة فيلهم العقائد والأحكام الشرعية ، ولا يحتاج عند ذلك إلى شريعة ! بل ولا إلى نبوة !!
وبعض الدعوات تجعل قدوتها في المعرفة بعض الصحابة أو الأولياء الذين لم يجعلهم الله تعالى ولا رسوله قدوة. بل قد يتخذ بعضهم قدوة من العرفاء والمتصوفة غير المسلمين .. إلى آخر ما هنالك من تعدد الأساليب والأهداف والقدوات .
ولهذا ، فإن من المشكل جداً أن ندعو الناس إلى معرفة الله تعالى عن طريق معرفة النفس ، ونقول لهم اقتدوا بأستاذكم حتى يصل أحدكم إلى الله تعالى فيصير أستاذاً مجتهداً ! فما أيسر أن يجلس الشيطان في هذا الطريق وينحرف بالإنسان !
سابعاً: بما أن حب الذات أقوى غرائز الإنسان على الإطلاق ، فإن دعوة العوام بل وأكثر المتعلمين إلى سلوك طريق العرفان والتصوف بدون تحديد الوسائل والأهداف والقدوة ، يجعلهم في معرض الوقوع في عبادة الذات وتعظيمها ، فيتخيل أحدهم أنه وصل إلى الله تعالى ، وحصل على ارتباط به ، وصار صاحب أسرار إلهية ، ويزين له الشيطان العيش في عالم من نسيج الخيال وحب الذات ، وقد تظهر منه ادعاءات باطلة واتجاهات منحرفة ، أعاذنا الله وجميع المؤمنين .
لذلك فإن الإئتمام في المعرفة وتعيين وسائلها وهدفها من أول ضرورياتها ، فالواجب التركيز على القدوة في معرفة النفس والسلوك ، قبل الدعوة إلى سلوك طريق لا إمام له .
ثامناً: ما دامت معرفة النفس عند المتصوفة طريقاً إلى معرفة الله تعالى ، ومعرفة الله تعالى طريقاً إلى عبادته ، فالهدف المتفق عليه عند الجميع هو عبادة الله سبحانه. وهذه العبادة التي هي غاية الخلق وطريق التكامل الإنساني الوحيد ، إنما تحصل بإطاعته سبحانه ، وإطاعة رسوله(ص)وإطاعة أهل بيته((عليهم السلام)أولي الأمر الذين أمرنا الله ورسوله بإطاعتهم والاقتداء بهم . .
ولذلك فلابد في الدعوة إلى المعرفة والعرفان وتزكية النفس وتطهيرها وجهادها وغرس الفضائل فيها .. أن تتقيد بإطاعة الأحكام الشرعية كاملة ، وتتخذ من النبي وآله صلى الله عليه وعليهم قدوة وأئمة في المسلك والسلوك .. حتى تكون طريقاً صحيحاً في الحياة ، موصلة إلى رضوان الله تعالى. ولذلك أجاب أحد الفقهاء شخصاً سأله ما هو العرفان ، وكيف يكون الإنسان عارفاً ، فقال له: هذه الأحكام الشرعية التي تطبقها يومياً فتصلي وتقوم بالواجبات وتترك المحرمات هي العرفان ، وأنت بسلوكك هذا تمارس المعرفة .
ومن الطبيعي أن يكون ذلك السلوك على درجات ومراتب ومقامات ، ولكنها تتحق من هذا الطريق الذي سلكه النبي وآله وتلامذتهم ، لا من غيره .
الفصل التاسع ;أنواع من المعرفة والعارفين
- الزيارات: 5942