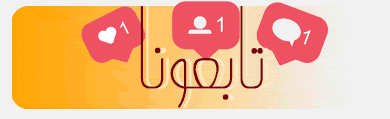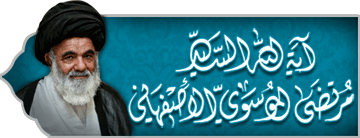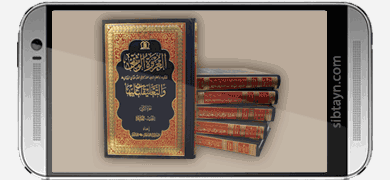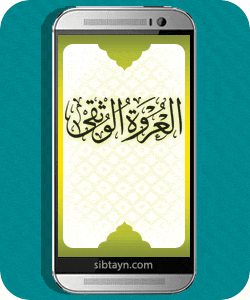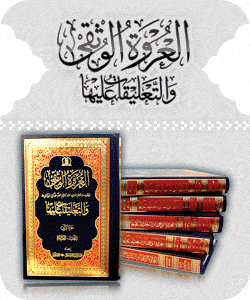قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر ما ينقسم إليه الخلاف في الإمامة:
" إعلم أن جميع (1) من جعل صفة الإمام صفة النبي يصح له أن يوجب فيه جميع (1) ما يجب في النبي، كما أن من جعل صفة الإمام صفة الإله يصح له أن يوجب فيه ما يجب الله تعالى، والكلام مع هذين الفريقين لا يقع في الإمامة، إلى آخر كلامه (2)... " (3)
قال السيد الشريف المرتضى رضي الله عنه:
أما من جعل للإمام جميع صفات النبي صلى الله عليه وآله. ولم يجعل بينهما مزية في حال فالكلام معه - وإن لم يسقط جملة من حيث لم يعلم بطلان قوله ضرورة - فإنه لا يكون كلاما في الإمامة، بل في النبوة، وهل هي واجبة في كل حال أم لا؟؟ فإن من جعل للإمام بعض صفات النبي أو أكثرها، وجعل بينهما مزية معقولة فالكلام معه لا محالة كلام في
الإمامة، وكيف لا يكون كلاما في الإمامة وهو لا يعدو أن يكون كلاما في صفاته، أو في صفة ما يتولاه (4) ويقوم به، لأن من قال من الإمامية: إن الإمام لا يكون إلا معصوما، (5) فاضلا، أعلم الناس إنما خالف خصومه في صفات الإمام، وكذلك إذا قال: إنه حجة في الدين، وحافظ للشرع، ولطف (6) في فعل الواجبات والامتناع من المقبحات، فخلافه إنما هو فيما يتولاه الإمام ويحتاج فيه إليه، فكيف ظن صاحب الكتاب أن الكلام مع من لم يوافقه في صفات الإمام وفيما يتولاه لا يكون كلاما في الإمامة؟ وهذا يؤدي إلى أن الكلام في الإمامة إنما يختص به المعتزلة (7) وبعض الزيدية (8)، ويخرج خلاف الإمامية والكلام عليهم من أن يكون كلاما في الإمامة، ويؤدي إلى أن ما سطره المتكلمون - قديما وحديثا - عليهم في الإمامة ليس بكلام فيها، وهذا حد لا يصير إليه ذو عقل.
وبعد، فإن الكلام مع الزيدية إذا كان كلاما في الإمامة على ما اعترف به صاحب الكتاب، ونحن نعلم أنهم لم يوافقوا في جميع صفات الإمام لأنهم يعتقدون: أنه لا يكون إلا الأفضل، فإذا كان الكلام معهم في الإمامة من حيث وافقوا على بعض صفات الإمام وخالفوا في بعض فكذلك الكلام مع الإمامية لأنهم وافقوا المعتزلة في بعض صفاته وخالفوهم في بعض، وكذلك وافقوهم في بعض ما يتولاه ويقوم به وإن خالفوا في بعض آخر.
فأما من جعل للإمام ما هو صفة الإله فخارج عن هذه الجملة، لأن الكلام في الإمامة هو الواقع بين أوجب على الله تعالى نصب الإمام في كل زمان وبين من لم يوجبه، فمن قال: إن الله تعالى هو الإمام فقد خرج عن هذا الباب جملة.
فأما قوله: " فجملة أمرهم أنهم لما غلوا في الإمامة وانتهوا بها إلى ما ليس لها من القدر (9) ذهبوا في الخطأ كل مذهب " إلى قوله: " والأصل فيهم (10) الإلحاد لكنهم تستروا بهذا المذهب " (11) فسباب وتشنيع على المذهب بما لا يرتضيه أهله (12) من قول الشذاذ منهم، ومن أراد أن يقابل هذه الطريقة المذمومة بمثلها، واستحسن ذلك لنفسه فلينظر في كتب ابن الراوندي (13) في فضائح المعتزلة فإنه يشرف (14) منها على ما يجد به على الخصوم فضلا كثيرا لو أمسكوا معه عن تعيير خصومهم لكان أستر لهم، وأعود عليهم (15)، وقل ما يسلك هذه الطريقة ذو الفضل والتحصيل.
فأما قوله: في الطبقة الثانية (16) من الغلاة عنده: " وإنهم نزلوا عن هذه الطبقة لكنهم انتهوا بالإمام إلى صفة النبوة وربما زادوا وربما نقصوا، وهم الذين يوجبون الحاجة إلى الإمام (17) من حيث لا يتم التكليف ولا حال المكلفين إلا به (18)، وبمعرفة (19) ما هو منهم ".
فظن بعيد، لأن من أوجب الحاجة إلى الإمام من حيث لا يتم التكليف إلا به لم يجعله نبيا، ولا بلغ به إلى صفة النبوة، وليس من حيث شارك الإمام النبي في الحاجة إليه من هذا الوجه يكون نبيا، كما أن المعرفة عند الخصوم (20) وإن وجبت من حيث كانت لطفا في التكليف (21) والنبوة طريق وجوبها أيضا اللطف لم يجب عندهم أن تكون المعرفة نبوة، ولا النبوة معرفة لاستبداد (22) كل واحدة منهما بصفة لا يشركها فيها الأخرى، والنبي لم يكن عندنا نبيا لاختصاصه بالصفات التي يشرك فيها الإمام بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير واسطة، أو بواسطة هو الملك، وهذه مزية بينة.
ثم يقال له: يجب عليك إن قلت " إن النبي يكون نبيا لعصمته ".
أن تجعل الأمة أنبياء لأنهم عندك أجمعهم معصومون (23) وأنت أيضا تجوز أن يكون في آحاد الأمة من هو معصوم فيجب عليك أن تجعله نبيا، وإن جعلته نبيا من حيث أداء الشرع لزمك مثل ذلك في الأمة (24) لأنها المؤدية للشرع عندك، فإن عدلت عن هذا كله، وقلت: إن النبي وإن شارك غيره في هذه الصفات - وإن لم يكن ذلك الغير نبيا - فإنما كان نبيا لاختصاصه بصفة كذا وكذا، وأشرت إلى صفة لا يشركه فيها من ليس بنبي لزمك أن تقنع منا بمثل ذلك.
فأما حكايته عنهم القول (25) " أن الإمام يزيد في العلم على الرسول، وكذلك في العصمة، وتعليله بأن ذلك يجب له من حيث انقطع الوحي عنه (26) " فحكاية طريفة (27) لا نعلم أحدا من الإمامية ذهب إليها وإلى معناها، ولا أعتقده، وهذه كتب مقالاتهم، ومصنفات شيوخهم خالية من صريح هذه الحكاية وفحواها معا (28) وكيف يقول الإمامية هذا؟! وهم إذا أفرغوا وسعهم (29) وبلغوا غايتهم انتهوا بالإمام في العصمة والكمال والفضل والعلم إلى مرتبة النبي، وكانت تلك عندهم الغاية القصوى؟ ولو لم يكشف عن غلط حاكي هذه المقالة إلا ما هو معروف من مذهبهم وأن النبي لا بد أن يكون إماما (30)، وأن ما يجب للإمام لكونه إماما يجب للنبي لأن النبوة تعم المنزلتين (31) فكيف يتوهم مع هذا عليهم القول بأن الإمام يزيد - فيما ذكره - على النبي؟
فأما قوله: " ولولا (32) أن الكلام في كون الإمام حجة، وأن الزمان لا يخلو منه، وقد دخل في الإمامة من جهة التعليل [ وصار مع القوم عند لزوم ما الزموا من ارتكاب ذلك ] (33) لم يكن لإدخاله في الإمامة وجه... " (34) فقد مضى الكلام عليه، وبينا أن ذلك لا بد أن يكون كلاما في الإمامة لأنه كلام في صفة الإمام وما يتولاه (35) فأما حكايته عن بعض الإمامية: " إيجاب الإمام من حيث كان تمكينا، وأنه باطل " (36). فغير صحيح، فإن التمكين قد يطلق ويراد به ما يرجع إلى ما يصح به الفعل من القدرة والآلات، وقد يراد به ما يسهل الفعل ويدعو إليه من الألطاف، فالإمام تمكين من الوجه الثاني، وليس بتمكين من الوجه الأول، وإن كنا تمنع من إطلاق القول بأنه ليس بتمكين إلا بتقييد (37) فأما ما حكاه عن بعضهم من أنه " لولا الإمام لما قامت السماوات والأرض ولا صح من العبد الفعل ".
فليس نعرفه قولا لأحد من الإمامية تقدم ولا تأخر، اللهم (38) إلا أن يريد ما تقدم حكايته من قول الغلاة (39)، فإن أراد ذلك فقد قال: إن الكلام مع أولئك ليس بكلام في الإمامة، وأحال به على ما مضى في كتابه من أن الإله لا يكون جسما، على أن من قال بذلك من الغلاة - إن كان قاله - فلم يوجبه من حيث كان إماما، وإنما أوجبه من حيث كان إلها (40) وصاحب الكتاب إنما شرع في حكاية تعليل من أوجب الإمامة، وذكر أقوال المختلفين فيها، وفي وجوبها وما احتيج له إلى الإمام.
وفي الجملة، فليس يحسن بمثله من أهل العلم أن يحكي في كتابه ما لا يرجع في العلم بصحته إلا إليه، ولا يسمع إلا من جهته، فإن فضلاء أهل العلم يرغبون عن أن يحكوا عن أهل المذاهب إلا ما يعترفون به، وهو موجود في كتبهم الظاهرة المشهورة! (41) فأما حكايته من كون الإمام بيانا وما يتصل بذلك، فعندنا أن أخذ ما احتج به إلى الإمام (42) كونه بيانا، بمعنى أنه مبين للشرع، وكاشف عن ملتبس (43) الدين وغامضه، غير أن هذه العلة ليست الموجبة للحاجة إلى الإمام في كل زمان، وفي كل حال، لأن الشرع إذا كان قد أجاز أن لا تقع العبادة به لم يحتج إلى مبين فيه.
فأما قول بعض أصحابنا: " أنه ينبه على الأدلة والنظر فيها " فالحاجة لا شك في ذلك إليه واضحة إلا أنه ليس يصح أن يتعلق في إيجاب الإمامة بما يجوز أن يقوم غير الإمام مقامه، وقد يجوز أيضا أن ينبه على الأدلة والنظر فيها غير الإمام، وقد يجوز أيضا أن يتفق لبعض المكلفين الفكر فيما يدعو إلى النظر من غير خاطر ولا منبه، بل يستغني عن المنبه، ولا يكون عندنا مستغنيا عن الإمام.
وأما قوله " إنهم يقولون: لا بد من الإمام ما دام السهو والغلط جائز [ ين ] على المكلفين فيما ينقلونه ويؤدونه (44)، إلى آخر كلامه... (45) ".
فإن هذه العلة في الحاجة إلى الإمام تجري مجرى الأولى (46) في أنها ليست بلازمة في كل حال، وإنما هي مختصة بالأحوال التي يحتاج فيها إلى نقل الشرائع وأدائها، فقد قلنا: إن العقل يجوز ارتفاع التعبد بكل شرع غير أن ذلك وجه صحيح يحتاج فيه إلى الإمام مع التعبد بالشرائع، والمكلفون وإن لم يجز (47) على الجماعة منهم السهو عما يسمعونه من الإمام شفاها، ولا عن كثير مما يؤكد علمهم به من الأخبار فإن تعمد الخطأ عليهم جائز في الحالين (48)، وبين جوازه عليهم فيما يسمعونه من الإمام وهو حاضر موجود العين قريب الدار وبين ما يجوز عليهم (49) بعد وفاة الرسول والإمام فرق واضح، لأن ما يقع من ذلك والإمام موجود يمكن للإمام استدراكه وتلافيه، وما يقع بعد وفاته لا يكون له مستدرك، وإذا استمر منهم الغلط في هذه الأحوال بطلت الحجة بالشرع على من يأتي من الأخلاف (50) فأما قوله: " إن كون (51) الإمام مع الجهل به غير معتبر لأنه بمنزلة غيره عند المكلف [ فإذا كانت الحال هذه ] (52) فلا بد من العلم بالإمام " (53).
فإن الجواب: أن الواجب على الله تعالى أن يوجب العلم به، ويمكن منه، فإن فرط المكلف بالعلم به لم يكن معذورا وإن أخرج نفسه من الانتفاع به، والتمكن من لقائه بأمر يتمكن من إزالته لم يكن أيضا معذورا، ولا سقطت الحجة عنه، فكيف يصح قوله: " إن ذلك يؤدي إلى أن يعذر كل من لم يعرف إمامه لأنه (54) لم يزح علته " (55)؟ وإنما كان يصح كلامه لو كان: كل من لا يعرف الإمام لا يتمكن من معرفته ولا سبيل له إلى الانتفاع به، فأما والأمر بخلاف ذلك فلا إشكال في لزوم الحجة له بتفريطه. وهذا كما يقوله جماعتنا في المعرفة: إن حصولها هو اللطف، ولا عذر لمن لم تحصل له إذا فرط في التوصل إليها من حيث كان متمكنا من تحصيلها.
فأما إلزامه إيجاب أئمة عدة بحسب حاجة المكلفين (56) فغير لازم لو فطن لموضع عمدتنا، لأن الذي يقتضيه العقل والاعتبار الذي ذكرناه اللطف بوجود الرئاسة لا عددا مخصوصا فيها، ولا رئاسة مخصوصة، وإنما يرجع في صفات الرؤساء وأعدادهم إلى أدلة أخر، فليس يمتنع قيام الدليل على أن الإمام يجب أن يكون واحدا في العالم، ويكون أمراؤه وخلفاؤه في الأطراف - إذا كان من ورائهم - يغنون عن وجود جماعة من الأئمة، وكل ذلك غير قادح في أن الرئاسة لطف على ما ذهبنا إليه.
فأما قوله: " لأنهم إذا قالوا: إن الإمام واحد ففي الحال التي تظهر إمامته لا يخلو من أن يقف كل (57) العالم عليه، أو بعضهم، ووقوف الجميع غير ممكن، فيجب أن تكون العلة غير مزاحة، إلى آخر كلامه (58)... ".
فأول ما نقول في ذلك: إنا لا نوجب إمامة واحد في الزمان بالدليل الذي دلنا على وجوب الرئاسة في الجملة، وإنما المرجع في ذلك إلى أمور أخر
وقد يجوز أن تختلف المصلحة فيه، فيكون تارة إماما واحدا، وتارة جماعة، فإن أراد بما يسأل عنه من حال ظهور إمامته، ولزوم الحجة لها ابتداء الإمامة، وأول الأئمة ففي ذلك الحال إذا لم يتمكن الجميع من العلم بحال الإمام الظاهر في أحد المواضع قد يجوز عندنا بل يجب إقامة أئمة عدة لتكون علة الجميع مزاحة.
فأما أن يسأل عن الأحوال التي تلي الابتداء من حيث لم يمكن من هو في أطراف البلاد العلم بحال الإمام وظهوره عند حصول النص عليه ونصبه إماما فعندنا أن هؤلاء - وإن لم يتمكنوا من العلم بما ذكر في الحال - فهم عالمون بإمامة الإمام الذي هو قبل ذلك الإمام الظاهر، ومتصرفون من قبل أمرائه وولاته، وبحسب تدبيرهم، وهذا كاف لهم في مصلحتهم، وليس يتصل بهم فقد الإمام وموته إلا مع اتصال غيره وظهوره، وقيامه بهم مقامه (59)، فليس يخلو في حال من الأحوال من المعرفة بالإمام، وإنما كان في كلامه شبهة لو أمكن أن يتصل بهم فقد الإمام، ويعروا (60) من اعتقاد إمامته من غير أن يتصل بهم قيام الإمام الآخر مقامه، فأما والأمر على ما ذكرناه فالقدح بمثل ذلك ساقط.
فأما تعلقه بالفترة بين الرسل فبعيد لأن المعلوم من حال الفترة هو خلو الزمان من النبي لا من الإمام، فمن أين " أن الفترة إذا ثبتت في الرسل وجبت في الأئمة " (61)؟ وهذا يلزم من جعل النبوة في كل حال واجبة دون ما اعتبرناه (62).
فأما حكايته عنا ما نذهب به من كون الإمام لطفا، وقوله: " إن جعلتموه لطفا على وجه يعم (63) أمكنكم هذا القول، وإلا فيجب أن تجوزوا في ذلك (64) خلو بعض الأزمنة منه، أو بعض المكلفين " (65). ثم قوله من بعد ذلك " لم نقل إن هذه المعرفة لطف إلا بدليل، فبينوا أن مثله من الأدلة قائم [ فيما ذكرتم ] (66) ليتم ما ذكرتم... ".
فالإمامة عندنا لطف في الدين، والذي يدل على ذلك أنا وجدنا أن الناس متى خلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحوالهم، وتكدرت عيشتهم، وفشا فيهم فعل القبيح. وظهر منهم الظلم والبغي، وأنهم متى كان لهم رئيس أو رؤساء يرجعون إليهم في أمورهم كانوا إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد، وهذا أمر يعم كل قبيل وبلدة وكل زمان وحال، فقد ثبت أن وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب إليه.
فأما تعلقه بعموم اللطف في المعرفة وإيجابه علينا إلحاق الإمامة بها في ذلك (67) فبعيد، لأن المعرفة لم تعم كل تكليف ومكلف من حيث كانت لطفا بل من حيث اختصت بما أوجب ذلك فيها، وليس بممتنع في الألطاف أن يختلف بعضها، فيكون بعضها عاما من كل وجه، وبعضها خاصا من كل وجه، وبعض آخر عاما من وجه وخاصا من وجه آخر.
فمثال ما هو عام من كل وجه المعرفة، فإنها تعم كل مكلف وتكليف أمكن أن تكون لطفا فيه، ويعم أيضا الأحوال.
فأما ما يعم من وجه ويخص من آخر كالصلاة لأنها تجب على كل مكلف غير معذور بحصول منع أو ما يجري مجراه (68)، وليس يمكن القطع على عموم كونها لطفا في كل تكليف، بل لا يمتنع أن تكون خاصة في التكليف، وإن كانت عامة في المكلفين، فأما الأحوال فمما لا شبهة في أنها ليست بعامة لها لوجودنا أحوالا لا يجب فيها فعل الصلاة بل لا يحسن،.
فأما الأحوال التي لا يجب فيها فهي الأحوال التي لم توقت للصلاة الواجبة.
وأما التي لا يحسن فيها فهي التي نهى الله عز وجل عن الصلاة مع حضورها (69) فأما ما هو خاص من كل وجه فكخلق الولد لزيد، أو تثمير مال عمرو، فإنه لا يمتنع أن يكون لطفا في بعض تكاليفه، بل في واحد منها، وكذلك لا يمتنع أن يكون له لطفا (70) دون غيره من الناس، وكذلك أيضا في الأحوال حتى يكون لطفا في حال ولا يكون لطفا في أخرى، فإذا ثبت [ ت ] هذه الجملة فما المانع من أن يكون وجود الإمام لطفا لكل مكلف كان على صفته من يجوز فيه فعل القبيح وفي كل حال وإن جوزنا اختصاصه ببعض التكاليف دون بعض، فليس يجب إذا سوينا بينه وبين المعرفة لما ألزمنا الخصوم أن يكون مختصا بمكلف دون آخر، وبحال دون حال، وكان قصدنا بذلك إلحاقه بالمعرفة في شمول من اختص بالصفة التي ذكرناها من المكلفين وعموم الأحوال أن يلزمنا التسوية بينه وبين المعرفة في كل وجه.
على أنا لم يظهر لنا القطع على كون الإمام لطفا في كل الأفعال والتكاليف لظهوره فيما يتعلق بأفعال الجوارح لأنه لا يمتنع أيضا أن يكون لطفا فيما يختص القلوب من الاعتقادات والقصود (71)، لأن المعلوم من حال الناس أن صلاح سرائرهم كالتابع لصلاح ظواهرهم، واستقامة أمورهم. وحسن طريقتهم فيما يقع من أفعالهم الظاهرة من أبر الدواعي إلى استقامة ضمائرهم أيضا، وعلى هذا يمكن أن يكون الإمام لطفا في الكل.
وإنما تكلفنا ما تقدم من الكلام حيث كان هذا الوجه كأنه غير مقطوع عليه، ومما يمكن أن يعترض التجويز فيه بخلاف ما قررناه.
فأما قوله: " ولا فرق بين من قال: الإمامة لطف وبين من قال مثله في الإمارة، وسائر من يقوم بشئ من أمور (72) الدين، وبين من يقول ذلك في إمام واحد، وبين من يقول في إمامين أو أئمة (73)... " فقد تقدم من كلامنا ما يفسده، وبينا أن العقول دالة على وجوب الرئاسة في الجملة، وليست دالة على عدد الرؤساء ولا صفاتهم.
والإمارة وما جرى مجراها من أمر الولايات رئاسة في الدين، ومكان اللطف بها والانتفاع ظاهر، وإنما لم نجعل إمام الكل ورئيس الجميع بصفة الأمراء لعلل أخر سنذكرها إن شاء الله تعالى، وإنما كان يلزم كلامه لو كنا نجعل الدليل على وجوب الإمامة بصفاتها التي تختص بها ما قدمناه من وجوب الرئاسة فيقال: " إن العقول لا تفرق فيما أوجبتموه بين رئاسة الإمام والأمير ورئاسة واحد وجماعة ".
فأما إذا عولنا في وجوب الرئاسة في الجملة على ما ذكرناه، وفي صفات الرئيس وعدد الرؤساء على غير لم يلزمنا كلامه.
فأما تكراره القول " بأن معرفة الإمام لا تمكن جميع المكلفين إذا كان واحدا " فقد بينا ما فيه، وفصلنا الكلام تفصيلا يزيل الشبهة.
فأما قوله: " فقد كان يجب على هذا القول أن يتمكن كل مكلف من معرفة الأمور من قبله، ومتى قالوا لنا (74): يجب ذلك في حال دون حال، قيل لهم: فجوزوه في قوم دون قوم (75) " إلى قوله -: " وقد كان يجب على هذا التعليل أن نعرف (76) إمام زماننا، وإلا فيجب أن نكون معذورين " (77) فقد تقدم شئ من الكلام على معناه، وجملته: أن معرفة الإمام ومعرفة ما يؤديه وإن لم يحصلا لكل أحد فإن الجميع متمكنون من حصول المعرفة له (78)، واستماع الأدلة منه، لأنهم قادرون على إزالة خوفه فيمكن عند ذلك من الظهور، والدلالة على نفسه. وبيان ما يلزمه بيانه، فارتفاع المعرفة به، وبما يؤديه إذا كان يرجع إلينا، وكنا متمكنين من إزالته لم يجب ما ظنه من ثبوت عذر من لم يعرف إمام زمانه.
فأما قوله: " إن خبرهم - أعني خبر الأئمة (79) - أغني عن مشاهدة الإمام، فخبر الرسول والتواتر بأن يغني عن الإمام أولى... (80) " فقدمنا ما يفصل به بين الأمرين، وبينا الفرق بين لزوم الحجة بالأخبار التي يكون الإمام من ورائها، وحاضرا لها، ومتمكنا من استدراك ما يقع فيها من الغلط وبين الأخبار التي لا إمام من ورائها، ولا معصوم يرجع إليه عند وقوع الغلط فيها، وهذا فرق واضح في استغنائها عن مشاهدة الإمام بالخبر عنه إذا كان موجودا وعدم استغنائنا عن الرسول بالأخبار بعد وفاته إذا لم يكن في الزمان إمام يتلافى ما يقع من الغلط فيها، فأما قوله: " فإن قالوا: إنا لا نقول: إن الإمام مصلحة من حيث ظننتم لكن لما نعلمه من أن اجتماع الكلمة على رئيس (81) واحد مطاع أقرب إلى التآلف على الخير والطاعة، والعدول عن الظلم والفساد، إلى آخر السؤال (82)... ".
ثم قوله: " قيل لهم: لكن (83) الوجه الذي له قلنا: إنها (84) لطف - يعني المعرفة - يختص كل مكلف، وكل فعل من أفعاله، إذ لا أحد من العقلاء إلا وهو عالم أن خوف المضرة صارف، ورجاء المنفعة داع، إلى آخر كلامه... (85) " فقد بينا فيما مضى اختلاف الألطاف في عمومها وخصوصها وأنه لا يجب حمل بعضها على بعض، وبينا غرضنا في تشبيه الإمامة بالمعرفة، والوجه الذي من أجله جمعنا بينهما، وأنه لا يلزمنا عليه التسوية بينهما من كل وجه، وأن ذلك وإن تعذر لم يقدح في كون الإمامة لطفا من الوجه الذي ذكرناه.
فأما قوله: " لا أحد من العقلاء إلا وهو عالم أن خوف المضرة صارف ورجاء المنفعة داع " فكذلك، لا أحد من العقلاء إلا وهو عالم بأن وجود الرؤساء وانبساط أيديهم مقلل لوقوع الظلم والفساد، والبغي والعدوان، أو رافع لذلك، فإن حمل نفسه حامل لنصرة مذهب له فاسد على أن يدفع ما ذكرناه في الرئاسة، وما يعلمه العقلاء من وجود الصلاح بها لم يجد فرقا بينه وبين من حمل نفسه أيضا على مثل ذلك فيما ذكر من خوف المضرة وكونه صارفا، ورجاء المنفعة وكونه داعيا.
فأما قوله: " ويبين (86) ذلك أن المعرفة أوجبنا كونها مصلحة للكل فليزمهم في الإمام أن يكون من مصالحه إمام ثان، ومتى جوزوا استغناءه عن إمام لزم ذلك في غيره (87)... " فبعيد عن الصواب لأن الوجه الذي من أجله أوجبنا كون الإمام لطفا لا يتعدى إلى الإمام، لأنه إنما يكون لطفا لمن لا يؤمن منه فعل القبيح دون من كان ذلك مأمونا منه. فكيف يلزمنا القول بحاجة الإمام إلى إمام مع عصمته وكماله، وأماننا من وقوع شئ من القبيح منه قياسا على حاجة الرعية التي لا يؤمن منها كل ما ذكرناه؟
ولو قيل أيضا: إن الإمام إنما ارتفعت حاجته إلى إمام من حيث لم يصح فيه أن يكون تابعا مأموما، وذلك لأن الدليل قد دل على أن الإمام لا بد من أن يكون معصوما كاملا وافرا غير مفتقر في شئ من ضروب (88) العلم والفضل إلى غيره، وإذا كان ذلك ثابتا فلو كان له إمام لم يكن بد من أن يكون مقتديا به في بعض الأفعال، ومستفيدا منه بعض العلوم. ومحتاجا إليه في تكميل أمر لم يحصل عليه، لأنه لا يجوز أن يكون إمام لا يفتقر إليه في شئ من هذه الخلال.
وإذا كانت صفات الإمام التي قدمناها تحيل (89) حاجته إلى غيره في شئ مما عددناه. والرجوع إليه في قليل منه وكثير استحال أن يكون للإمام إمام من هذا الوجه، وجرى ما ذكرناه هاهنا مجرى قولهم: " إن المعرفة لطف في كل تكليف سوى التكاليف التي تقدمها، مثل تكليف النظر في طريقها وما جرى مجراه " ولما خرجت المعرفة من أن تكون لطفا في بعض التكليف من حيث لم يصح أن يكون لطفا فيه وقام غيرها مقامها في اللطف ولم يلزم على ذلك أن لا يكون لطفا فيما يصح أن يكون لطفا فيه لم يمتنع أيضا أن يكون الإمام لطفا لكل مكلف صح فيه معنى الاقتداء والائتمام لغيره وإن لم يكن لطفا لمن لا يصح ذلك فيه من الأئمة والأنبياء بل قام لهم غير الإمامة في اللطف مقامها لكان وجها قويا معتمدا.
فأما قوله: " ويلزمهم على علتهم أن الله تعالى لو كلف مكلفا واحدا لاستغنى (90) عن إمام، لأن الإلفة والفرقة إنما يصحان في الجماعة (91)... " فطريف (92) لأن الذي حكاه عنا من الاستدلال لم نقتصر فيه على ذكر الفرقة عند عدم الإمام فقط، بل قد ذكرنا أيضا وقوع الظلم والفساد، وفعل الخير والطاعات. فهب أن الألفة والفرقة إنما تصحان في الجماعة ولا تصحان في الواحد أما يصح في الواحد فعل الطاعة وتجنب المعصية؟ فهذا سهو من صاحب الكتاب!
فأما قوله: " ويلزم إذا كان المعلوم من حال الجماعة أنها تبقى على الطاعة كالملائكة (93) أن تستغني عن الإمام (94)... " فلا شك أن من كان معصوما فهو مستغن عن إمام يكون لطفا له في الامتناع من القبيح، وليس معنى المعصوم أكثر من أن يعلم أن يبقى على الطاعة ولا يخرج منها، ولا فرق في الاستغناء عن الإمام من هذا الوجه بين من المعلوم أنه يبقى على الطاعة كالملائكة وبين الأئمة والأنبياء.
فأما قوله: " لأن في العقلاء من إذا ترك واختياره، ولم يحصل تابعا لغيره ومنقادا له يكون أقرب إلى الصلاح. ومتى قهر على اتباع غيره كان من الصلاح أبعد... (95) " فإنا لا نشك أن من العقلاء من إذا قهر على اتباع غيره لم يستقم حاله، وكان إلى الفساد أقرب، غير أنه وإن لم يصلح حاله على من قهر على اتباعه لنفاره عنه وكراهته له أو لغير ذلك فلا بد من أن يكون ممن يصلح حاله أو يستقيم على غيره ممن يرتضيه ويميل إليه، ويؤثر رئاسته والانقياد له، وما ذكره إنما يكون قدحا في قول من قال:
" إن الصلاح حاصل عند وجود كل رئيس كائنا من كان " ولم نقل بهذا فيقدح به في قولنا والموضع الذي يحتاج إلى تحصيله، أن حال الناس لا يجوز أن يكون مع فقد رئيس ما في الجملة كحالهم عند وجوده، وإن كان لا يمتنع أن يكرهوا رئيسا دون رئيس ويفسدوا (96) عند رئاسة دون رئاسة، والذي يبين هذا ويكشفه أن الذي يفسدون ويضطربون عند إقامة بعض الرؤساء لو أقيم لهم من يختارونه ونصب لهم من يرضونه لسكنوا إليه، وصلحوا عليه، فدل ذلك على أن فسادهم عند رئاسة من كرهوه لم يكن استفرغ لأمر يتعلق بأصل الرئاسة. وجملة الرؤساء، بل لأجل رئيس دون رئيس، وهؤلاء الخوارج (97) مع خلعهم لطاعة السلطان ومروقهم عن كلمته لم يخلوا من الرؤساء ونصب الأمراء، ورؤساؤهم في كل وقت بعد آخر معروفون.
كذلك من لم يزل عن هذه الطبقة من أهل الذعارة (98) والتلصص (99) لا بد أن يكون لهم رئيس يفزعون إلى رأيه، وكبير يتدبرون بتدبيره.
فمن نازع منهم الإمامية فيما ادعيناه أولا من أنه لا يجوز أن يكون حكم وجود الرئاسة في الجملة حكم ارتفاعها (100) نبهناه على غفلته، ورفعه لما هو ثابت في عقله، وإن خالفنا في الثاني وهو أن بعض العقلاء قد يكره بعض الرؤساء، ولا ينقاد له، ويفسد عند ولايته لم يضرنا خلافه لأنا قد بينا أن ذلك - وإن صح - فهو غير قادح في طريقنا.
فأما قوله: " وبعد، فيلزمهم على هذه الطريقة إثبات أئمة، لأن المتعالم (101) أن أهل كل بلد إذا كان لهم رئيس يشارف (102) أحوالهم، ولا يغيب عنهم ويأخذ حالا بعد حال على أيديهم [ ويقوم المعوج منهم، ويزيل الشتات (103) عنهم ] (104) إنهم أقرب إلى الصلاح من أن يكون الرئيس في العالم واحدا (105) فقد بينا فيما سلف بطلان التعلق بهذا المعنى، وقلنا:
إن العقول لا تدل على إثبات عدد في الأئمة والرؤساء دون عدد، وأنه موقوف على ما يعلمه الله تعالى من الصلاح وليس يجب ما ظنه من اعتبار ما يوجب وجود الرئيس في كل مكان وفي كل بلد، لأنه إن أراد بذلك أن رئاسة ما يجب في كل بلد فهو صحيح، وعندنا أن الإمام وإن كان واحدا فيجب عليه أن يستخلف الخلفاء في البلدان. ويؤمر الأمراء في الأمصار. وإن أراد أنه لا بد من أن يكون الرئيس في كل موضع بصفة رئيس الكل وإمام الجميع فهو اقتراح طريف لا يدل عليه العقل، ولا يجب علينا التزامه من حيث أوجبنا الرئاسة في الجملة، والذي نبينه فيما بعد بمشيئة الله تعالى عند مصيرنا إلى موضع [ - ه ] من صفة إمام الكل وأحواله وما يجب أن يكون عليه يكشف عن أن تلك الصفات لا يجب أن تكون لخلفائه والولاة من قبله.
فأما قوله: " ومتى قالوا: إن الإمام يولى في كل بلد، قلنا لهم:
ربما كان الصلاح أن لا يتبع الرؤساء بعضهم بعضا، وينقاد بعضهم لبعض، لأن من حق الرئيس أن يتميز (106) في ذلك عن الرعية (107)... " فلسنا ننكر أن يكون الصلاح في بعض الأحوال على جهة تقدير ما ذكره، وإذا وقع ذلك نصب الله تعالى في كل بلد إماما له صفات إمام الجميع، فإن العقل يسوغ ذلك ولا يمنع منه، بل لا يمتنع أن ينصب الله تعالى لكل واحد من الناس إماما، وإنما الذي منعنا منه أن يكون ذلك واجبا، فأما أن يكون جائزا فمما لا يضرنا ولا ينفع صاحب الكتاب.
فأما قوله: " فلو (108) جاز لبعضهم أن يكون تابعا لبعض، جاز في أولهم أن يكون تابعا للجماعة، إذا أرادوا نصبه، فمن أين لا بد من إمام من قبله تعالى؟... (109) ". فهو رجوع إلى الظن علينا إيجاب النص على الإمام من قبل الله تعالى من حيث أوجبنا الرئاسة في الجملة وحصول اللطف بها، وقد ذكرنا أن الطريقين مختلفان. وأن الذي به نوجب النص عليه ليس هو الذي دل على ثبوت اللطف في الرئاسة على سبيل الجملة، على أن الذي ذكره من قوله: " جاز في أولهم أن يكون تابعا للجماعة إذا أرادوا نصبه " تصريح منه باتباع الإمام، وانقياده لمن يريد نصبه من الرعية على آكد الوجوه التي لم يزل أصحابنا يسومون (110) أهل مذهبه التزامها، والقول بها. فيمتنعون لأنه جعل اتباعه للجماعة إذ أرادوا نصبه كاتباع الرعايا أمراءه وخلفاءه لهم، ونحن نعلم أن اتباع هؤلاء وانقيادهم هو على سبيل الطاعة والتصرف بين أمرهم ونهيهم، فإن كان قد نشط (111) أن يجعل حكم الإمام مع من يختاره وينصبه حكم الرعية مع الأمير ومن جرى مجراه من الولاة فما بقي من الشناعة موضع لم يصر إليه، وقد زاد على ما أراده أصحابنا من أهل مذهبه في التزام هذا المعنى.
فأما قوله: " فإن قالوا: المقرر في عقول العقلاء الفزع إلى نصب رئيس يجمع الكلمة (112) وينظم الشمل، ويجمع على الصلاح، ويزيل الفساد، وهو الموجود في عقل (113) العقلاء عند الحوادث والنوائب، وقد بلغ حاله في الظهور إلى أن غير العقلاء يشركهم فيه، إلى آخر السؤال... (114).
ثم قوله: " قيل لهم (115): قولكم إن هذا مقرر (116) في العقول لا يخلو من وجهين:
إما أن يدعى علم اضطرار وذلك مما لا سبيل إليه، لأنا نجد من أنفسنا خلافه، ولأن الاختلاف في ذلك ممكن مع سلامة الأحوال (117)، ولأنه ليس بأن يدعى في العقل إماما واحدا (118) بأولى من أن يدعى جماعة، ولا (119) بأن يدعى معصوما أولى من غيره.
وإن كنت مدعي علم الاكتساب (120) فبين طريقه،... (121) " فقد بينا ما الذي يعلم ضرورة من هذا الباب، وما الذي يعلم اكتسابا ونبهنا عليه، وجملته: أن المعلوم ضرورة من أن الناس لا يجوز أن يكون حالهم عند وجود الرؤساء المطاعين وانبساط أيديهم (122)، ونفوذ أوامرهم ونواهيهم، وتمكنهم من الحل والعقد، والقبض والبسط، والاحسان والإساءة كحالهم إذا لم يكونوا، في الصلاح والفساد، وإنما المشتبه الذي يرجع فيه إلى طريقة الاستدلال هل هو هذه حالهم عند كل رئيس؟! أو هو أمر يجوز اختصاصه ببعض الرؤساء دون بعض؟ وهل غير الإمام يقوم مقام الإمام في ذلك أو ممن لا ينوب منابه فيه،؟ وهل هذه الحاجة مستمرة لازمة، أو هي منقطعة يجوز ارتفاعها؟، فهذه الوجوه وما قاربها هي التي يمكن أن يقع الاختلاف فيها، وتبين الدليل الصحيح منها (123).
فأما ما قدمناه فلا طريق إليه من جهة الاستدلال لأنه في حيز الضرورات، وما هو معلوم بالعادات، وقد قدمنا أن من حمل نفسه على دفعه لم ينفصل ممن دفعه عما نعتقده في جميع العادات وغيرها.
وكيف لا يكون ما ذكرناه مستقرا في العقول، معلوما لسائر العقلاء ونحن نجد جميع حكماء الأمم يحضون (124) عليه، ويوصون به، ويحذرون من التغافل عنه، والتقصير في القيام به، وهذا أردشير بن بابك (125)، وألفاظه ووصاياه في الحكمة، وما يتعلق بالأخذ بالحزم معروفة بقوله:
" الملك والدين أخوان توأمان (126) لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه ".
ومن أمثالهم القديمة: " إن مثل الملك والدين مثل الروح والجسد، فلا انتفاع بالروح من غير جسد، ولا بجسد من غير روح ".
وأما حكماء العرب فقولهم في ذلك معروف شايع قال الأفوه الأودي:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا (127)
تهدى الأمور بأهل الحزم ما صلحت وإن تولت فللأشرار تنقاد (128)
فالبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاد (129)
فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغ الأمر الذي كادوا (130)
فما يكون قول العقلاء والألباء (131) فيه هذا القول، ووصيتهم به جارية على هذا الوجه كيف يمكن اختلاف العقلاء فيه، وأنه أمر يستغنى عنه أحيانا ويحتاج إليه أحيانا؟!!
وليس لأحد أن يقول: فلعل من حكيتم عنه ما ذكرتموه غالط ومتوهم لخلاف الواجب لأنا لم نحتج بقوله على وجه يقدح فيه مثل هذا الكلام وإنما أردنا أن اعتقاد الحاجة إلى الرؤساء وعموم النفع بهم شامل للعقلاء، وأنه مما لا يختص به أحد فاستشهدنا بقول من قد صحت حكمته، وتبينت (132) معرفته بالسياسة وما يرجع إلى الأخذ بالحزم والتدبير ليكون أبلغ فيما قصدنا.
وبعد فكيف غلط هؤلاء فيما ذكرناه ولم يغلطوا في جميع ما وصوا به من الحكم والآداب والتدبير والسياسة ونحن نجد جميع العقلاء يفزعون في هذه الأمور إلى كتب هؤلاء القوم ويستفيدون منها ما يسوسون به أمر معايشهم. وأكثر متصرفاتهم؟! وهل ادعاء (133) الغلط عليهم في هذا دون غيره إلا فرارا من لزوم الحجة؟.
وأما قوله: " وليس بأن يدعى إماما واحدا بأولى من جماعة، ولا معصوما بأولى من غيره... (134) " فقد مضى ما فيه، وبينا أن الذي يثبت وجوب الرئاسة وحصول اللطف بهما في الجملة غير الذي به يثبت صفات الرؤساء وأعدادهم.
وأما قوله: " ولو أن قائلا قال بالمتقرر (135) في العقول فزعهم إلى اختيار أنفسهم في نصب رئيس جامع للكلم فيجب أن يبطل (136) بذلك إثبات الإمام بنص أو معجزة لكان أقرب مما ذكروه... (137) " فقد سلف من الكلام عليه في هذا المعنى المتكرر ما يغني.
وبعد، فإنهم إنما فزعوا إلى اختيار أنفسهم عند جهلهم بأن لهم إماما يجب عليهم طاعته، وعند نفورهم عمن نصب لهم من الأئمة وعصيانهم لهم ففزعوا إلى نصب رئيس من حيث فوتوا أنفسهم الاتباع لمن نصب لهم. وهذا يؤكد ما ذكرناه من مثابرة (138) العقلاء على أمر الرئاسة.
واعتقادهم وجوبها وحصول الضرر في الاخلال بها.
فأما قوله: " ولو أن قائلا قال: المعلوم (139) أنهم ينصبون رئيسا عند الحوادث لا في كل حال، وأنهم مع سلامة أحوالهم قد لا يفعلون ذلك، فإذا وقعوا (140) في محاربة ومنازعة (141) فعلوه لكان، أقرب مما قالوه، (142)... " فقد بينا أن الأمر الذي يحتاج فيه إلى إمام ليس مما يحدث في حال دون حال، بل هو عام في الأحوال فكيف يصح ما ذكروه؟.
وبعد، فكيف يجوز الاستغناء عن الإمام في حال الأمن وارتفاع الحاجة إلى الحرب والمنازعة وما جرى مجراهما ونحن نعلم أن حال الأمن لا يعدم فيها التظالم والتغالب، وامتداد يد القوي إلى الضعيف إلى سائر ما يستغنى عن ذكره من وجوه الفساد التي لا يمتنع الأمن منها ولا يحيل وقوعها (143)؟ وإذا كان كل هذا متوقعا ممكنا ووجود من يهاب مكانه، وتخشى سطوته، أو يوقر في نفسه. ويستحيى من مجاهرته يرفع ذلك أو يقلله فقد بطل ما ظنه من اختصاص الحاجة إليه بحال دون أخرى، على أنه لا فرق بين من قال: إن الإمام قد يجوز أن يستغنى عنه في الأمن عند الاستغناء من الحرب وبين من قال: وقد يجوز أيضا أن يستغنى عنه في الحرب وغيرها مما يدعي أنه يحتاج إليه فيه، وما يصحح الحاجة إليه في الحرب والمنازعات بمثله يصحح الحاجة إليه في جميع الأحوال، وقوله:
" لأنهم مع سلامة الأحوال قد لا يفعلون ذلك " لا ينكر غير أنهم إذا لم يفعلوه أعقبهم من الضرر والانتشار (144) ما هو معروف ولم يكن احتجاجنا بفعلهم حسب، وإنما احتجاجنا أنهم يفعلون ذلك. ويبادرون إليه لوجوبه في عقولهم. ومتى أغفلوه تبينوا عن مضرته، على أنهم إذا لم يفعلوا ذلك علموا من أنفسهم أنهم مهملون، وتاركون لما يجب في عقولهم، وأنهم مستعملون الهوى، ومتبعون له، كما يعلمون - إذا كانوا عقلاء وارتكبوا الظلم وما جرى مجراه في القبائح في العقول - أنهم فاعلون لما يقتضي عقولهم خلافه. وأنهم في ذلك عاملون على الهوى، ومائلون مع الطباع ولا يخل (145) ذلك بمعرفتهم بقبح ما صنعوه فكذلك حكمهم إذا أهملوا أمر الإمامة وتوانوا عن إقامة الرؤساء مثل ذلك.
فأما قوله: " لو أن قائلا قال: فزعهم إلى نصب رئيس كفزعهم إلى الاستبدال (146) به إذا كرهوا منه أمرا (147) ".
وقوله: " ولو أن قائلا قال: كل فرقة تفزع إلى رئيس غير الذي تفزع إليه سائر الفرق فيجب إثبات رئيس لكل فرقة (148) لكان أقرب مما ذكروه، (149)... " فقد تكرر منا الكلام عليه لتكراره له.
وجملته: أن يظن أن طريقتنا في إثبات الإمامة، وما نوجبها به هي طريقتنا إلى إثبات صفات الإمام التي يختص بها. وكون عليه نص من قبل الله تعالى، وهذا ظن منه بعيد.
وأما قوله: " ولو أن قائلا قال: المتقرر في العقول أنهم ينصبون رئيسا عند ظنهم الحاجة إليه كما ينصبون وكيلا عند ذلك. ولذلك لو ظنوا الغنى عنه لم يتكلفوه، (150)... " فقد بينا أنهم عالمون بالحاجة إلى الإمام والرئيس لا ظانون، وأن حاجتهم إلى ذلك لا تختلف باختلاف الأوقات.
فإن الاستغناء عن الرؤساء لا يجوز أن يتخيله عاقل، وذلك كاف.
وأما قوله: " لا فرق بين من قال: المتقرر (151) في العقول وجوب نصب الإمام لحصول الأمن وبين من قال: المتقرر في العقول وجوب * (152) الصلاة والصيام. ورجع إلى ما ثبت (153) في العقل من وجوب الخضوع للمعبود، وإذا كان ذلك لا يدل على وجوبهما بهذه الشرائط، لأن العقل إنما يقتضي الخضوع فقط ولا يقتضي الخضوع بهذين الفعلين [ على ما اختصا به من الشرائط ] (154) فكذلك لو ثبت ما قالوه من نصب رئيس في العقل كما دل على ما قالوه لأنه لم يثبت نصبه على الصفة التي ذكروها فلا بد من رجوعهم إلى دليل سواه، (155)... " فقد رضينا بما ذكره ومثل به من أمر الصلاة والصيام وما أشبههما من العبادات الشرعية، لأن العقل وإن دل على وجوب الخضوع للمعبود في الجملة فهو غير دال على استعمال ضرب من الخضوع مخصوص وإنما يرجع في ذلك إلى أدلة أخر، وكذلك القول في الإمامة عندنا، لأن العقل الدال على الحاجة إلى الرئاسة في الجملة ووجوب إقامة الرؤساء لا يدل بنفس ما دل به على الحاجة إليهم في الجملة على صفاتهم المخصوصة، وأحوالهم المعينة، بل لا بد من إثبات ذلك من الرجوع إلى طريقة أخرى، وهي وإن كانت من جملة طرق العقل وأدلته فليست نفس ما دلنا على وجوب الرئاسة، فنسبة صاحب الكتاب - على ظنه - أن طريقتنا في وجوب الرئاسة وصفات الرؤساء وأعدادهم واحدة [ غير صحيحة ].
فأما قوله: " إن العقلاء قد يفعلون (156) ما هو واجب وما ليس بواجب، فمن أين أنه واجب؟ وقد يفعلون (157) ما يحسن وما لا يحسن، فمن أين أنه حسن؟ وقد يفعلون (158) ما يشتركون في معرفته وسببه، وما يفترقون فيه، فمن أين أن جميعهم قد وقفوا على وجوب سببه (159)؟ وهذا يبين أن فعلهم ليس بحجة إلا إذا كان عن معرفة، (160)... " فقد بينا أن تعلقنا لم يكن بفعلهم فقط، بل بما يعلمونه من وجوب ذلك الفعل عليهم، وما في تركه من الاستضرار (161)، وفي فعله من الصلاح، وأنه مما لا يختلف حاله مع كون المكلفين على ما هم عليه بل العلم بوجوده مستمر غير منقطع. وإذا كنا قد فرغنا من ذلك فقد سقط ما ذكره في هذا الفصل لأنهم إذا كانوا قد فعلوه مع العلم بوجوبه فقد زاد ذلك على إثبات حسنه لأن الواجب في العقول لا يكون إلا حسنا، وبان أيضا أنهم مشتركون في معرفة سبب وجوبه، وقد تقدم فصلنا بين ما يعلم من ذلك باضطرار وما يعلم باكتساب فلا وجه لا عادته.
فأما قوله: " لأن العقلاء مختلفون فمنهم من ينصب رئيسا ومنهم من يعول على ما يعلمه من حال جميعهم في بذل النصفة (162) من أنفسهم، ومنهم من يبطل الرئيس ويعزله، ويعود إلى طريقة الشورى (163)... " فقد عرفنا وعرف من يفزع إلى نصب الرؤساء من العقلاء ويثابر على أمر الرئاسة. ويحذر من التفريط فيها، والاهمال لأمرها. وليس يعرف من الذي يعول على بذل النصفة من نفسه، ويظن الاستغناء عن الرؤساء والأئمة، وقد كان يجب عليه إذا ادعى ذلك أن يشير إلى من لا يمكن جحد مكانه، ولا يعول على محض الدعوى، وقوله " ومنهم من يعزل الرئيس ويعود إلى الشورى (164) " لسنا نعلم بأي طريق يقدح في مذهبنا، لأن رجوع من يرجع إلى الشورى لم يخرج به عن طريقة من يعتقد الحاجة إلى الرؤساء، ولزوم إقامتهم. لأن الشورى إنما هي زمان الفحص عن المستحق الأمر الرئاسة، وذلك يؤكد أمر الحاجة إلى الإمام، اللهم إلا أن يريد بلفظ الشورى الاهمال والاستغناء عن الإمام، فإذا كان يريد ذلك فهو غير مفهوم من هذه اللفظة مع الاصطلاح الواقع على معناها، وقد مضى الكلام على فساد ذلك - إن كان أراده - مستقصى (165).
فأما قوله: " واعلم أن الذي يفعله العقلاء لا مدخل له في باب الإمامة لأنهم يفعلون ما يتصل باجتلاب المنافع، ودفع المضار.
والاستعانة بالغير عند الحاجة تدخل في هذا الباب، ولا فرق بين الاستعانة بوكيل يقوم بأمر الدار والضيعة (166) والاستعانة بأمير (167) يقوم بحفظ البلد " - إلى قوله -: " فلا فرق بين من يدعي نصب الإمام بهذه الطريقة وبين من يدعي جميع ما يتعلق باجتلاب المنافع ودفع المضار، ويجعله أصلا في هذا الباب، (168)... " فليس كما ادعاه من أن الحاجة إلى الإمام بخصوصه في اجتلاب المنافع ودفع المضار الدنيوية، بل الذي ذكره إن كان حاصلا فيها فقد يتعلق بها أمر ما يرجع إلى الدين، واللطف في فعل الواجبات، والاقلاع من المقبحات.
ألا ترى أنا قد دللنا على أن بوجود الرؤساء وانبساط أيديهم. وقوة سلطانهم يرتفع كثير من الظلم والبغي، ويخف أكثر ما يجري عند فقدهم من الفساد والانتشار؟ وكل ذلك يبين أن للرئاسة دخولا (169) في الدين قويا، وكيف يدفع تأثير الرئاسة في أمر الدين مع ما ذكرناه من تقليلها لوقوع كثير من المقبحات، وتكثيرها لفعل الواجبات؟
وليس لأحد أن يقول: لو كانت الرئاسة إما تجب من حيث كانت لطفا في واجبات العقول لم يجب على الناس إقامة الرؤساء، لأنه لا يجب عليهم أن يلطفوا لغيرهم في فعل الواجبات عليه، فإذا كان غرض من ينصب الأئمة في نصبهم دفع ما يقع من المفسدين من الظلم والعدوان على ما ادعيتم فقد صار واجبا عليهم أن يلطفوا لغيرهم فيما يتعلق بالدين وفساد ذلك ظاهر، وإذا فسد لم يبق إلا أن غرضهم في نصب الرؤساء مقصور على المصالح الدنياوية، ودفع المضار العاجلة، واجتلاب المنافع الحاضرة، وذلك أن غرض العقلاء في نصب الرؤساء ليس بمقصور على أن لا يقع من غيرهم فعل القبيح. بل على أن لا يقع من غيرهم ومنهم أيضا فعل ما يقبح في عقولهم مما وجود الرؤساء يرفعه أو يقلله، فقد عاد الأمر إلى أن ذلك لا يتعلق بالدنيا، ويجب لأمر يتعلق بالدين، على أنه لا أحد من العقلاء يجب عليه في الحقيقة عندنا - نصب الرؤساء وإقامتهم، لأنا إنما نوجب ذلك على الله تعالى، ونحيل (170) أن يكون نصب الإمام مما تمكن منه العقلاء بآرائهم واختيارهم، وإنما ظن بعض العقلاء أن ذلك واجب عليه ففزع عند هذا الظن إلى نصب الرؤساء من حيث جهل ما ذكرناه من اختصاص ذلك بالله تعالى دون البشر، وليس يجب إذا اعتقدوا وجوبه عليهم أن يكون واجبا في الحقيقة، وموضع تعلقنا بفعلهم، وما يعلمونه من الصلاح بوجود الرؤساء، والفساد بفقدهم باق، ولا يقدح فيه اعتقادهم أن إقامته من فروضهم، لأننا قد بينا ما أدخلهم في هذا الاعتقاد الفاسد وكشفناه، والفرق بين الوكيل والأمير والإمام واضح، لأنا قد دللنا فيما تقدم على أن الحاجة إلى الرؤساء والأمراء ثابتة غير زائلة، وليس كذلك الحاجة إلى الوكيل فإن من لا ضيعة له ولا عقار له، ولا ما يجري مجراهما مما يتصرف فيه الوكلاء لا حاجة به إلى الوكيل، ولا يعده العقلاء في ترك الاستعانة بوكيل مهملا ومفرطا، وليس نجد أحدا من العقلاء يستغني عن أن يكون له رئيس يأخذ على يده ويمنعه عن كثير مما يتسرع (171) بطباعه وهواه إليه من القبائح. وحكم سائر من يجوز عليه فعل القبيح من المكلفين حكم صاحب الضياع والأموال التي لا يتسع لتدبيرها والقيام بها، وكما أن من هذه حاله إذا ترك إقامة الوكيل والاستعانة به كان مفرطا مذموما موبخا (172) وأعقبه ذلك غاية الضرر فكذلك حال المكلفين متى خلوا من الرؤساء والأمراء.
وقوله: " فلا فرق بين من يدعي نصب إمام بهذه الطريقة... " إن أراد نصب الإمام المختص بالصفات التي يذكرها فقد تقدم أنا بهذه الطريقة وحدها لا نثبته، وإن أراد نصب رئيس في الجملة فهو الصحيح وقد أوضحناه.
فأما قوله: " على أنا قد بينا أن ما يكون طريقا لاجتلاب المنافع يحسن ولا يجب، وما يكون طريقا لدفع المضار قد يجب، وأن ذلك متعلق بغالب الظن، إلى آخر كلامه... (173) " فقد تقدم آنفا (174) ما يبطل ما ادعاه من اختصاص نصب الرؤساء بدفع المضار الدنياوية، واجتلاب المنافع العاجلة، ودلنا على أن للرئاسة تعلقا وكيدا بالدين بما لا يمكن دفعه.
فأما قوله: " وربما اجتمعوا على رئيس كافر، وربما اجتمعوا على رئيس مؤمن، ويحل ذلك محل اختلافهم في أغراضهم وشهواتهم، وما هذا حاله لا يجعل أصلا في باب الديانات، (175)... " فليس ننكر ما ذكره من جواز اجتماع الناس على رئيس كافر، ولا نمنع من أن تستقيم أحوالهم على رئاسته بعض الاستقامة، وليس ذلك بقادح في قولنا. لأنا نمنع من أن ينصب الله إماما كافرا لأمر يرجع إلى حكمته لا أن رئاسة الكافر لا يجوز أن تكون، إذ في المعلوم أن قوما يستقيمون عندها فيه [ و ] هذا - كما نقوله نحن وأنتم جميعا - لا يمتنع أن يعلم الله تعالى من بعض عباده أنه لا يؤمن إلا بأن يفعل - تعالى (176) - بعض القبائح. فنقول: إن ذلك لا يجوز أن يفعله، بل لا يحسن فكذلك القول في رئاسة الكافر، وكل هذا لا يمنع من صحة ما ذكرناه في وجوب الرئاسة على الجملة بل يؤكده.
فإن قيل: ما تقولون لو علم الله تعالى أن سائر المكلفين لا يصلحون ولا يستقيم حالهم إلا عند رئاسة كافر، أو عند رئاسة من ليست له هذه الصفات المخصوصة التي تدعونها للأئمة؟.
قيل له: إذا علم الله ذلك أسقط عن المكلفين ما الإمامة لطف فيه من التكليف، أو لم يخلقهم في الابتداء، ويجري مجراه أن يعلم الله سبحانه أن بعض المكلفين لا يصلح في شئ من تكاليفه، ولا يكون شئ من الأفعال الحسنة لطفا له، بل يعلم أن صلاحه ولطفه في فعل قبيح يفعله سبحانه، فكما أنا نوجب إسقاط التكليف عن هذا أو أن لا يخلق فكذلك نوجبه فيمن تقدم.
فأما ما طوله من الخاطر والتنبيه على النظر، إلى آخر كلامه في ذلك... (177) فليس مما نتعلق به ولا نعتمده، وقد أوضحنا عن وجه الحاجة إلى الإمام بما يغني عن غيره. وقد كنا قلنا فيما قبل: أنه ليس يجوز أن يوجب إقامة إمام لأمر يجوز أن يقوم غيره فيه مقامه، والتنبيه على النظر فيما يجوز عندنا أن يستغنى فيه عن الإمام وإن كان بعض أصحابنا تعلق بذلك تقريبا.
فأما ما ذكره وأطنب فيه (178) أيضا من شكر النعمة، وتعاطيه (179) إفساد قول من يدعي: أن الإمام يحتاج إليه لبيان كيفية الشكر لله تعالى فمما لا نرتضيه ولا نعتمده.
وقوله في آخر كلامه: " إن هذا التعليل لو صح [ لهم ] لما كان يوجب في كل عصر حجة لا محالة (180)، لأن بيان الرسول الواحد إذا انتشر بالتواتر في كيفية الشكر أغني عن حجة [ بعده ]... (181) " باطل لا يفسد بمثله المذهب الذي حكاه لأن ما بينه الرسول عن كيفية الشكر ليس مما يجب نقله لا محالة، ولو وجب نقله لم يجب على وجه التواتر الموجب للحجة لأنه لا يمتنع أن يعرض الناقلون أو أكثرهم عن النقل لداع يدعوهم إلى الإعراض، كما أنهم في الأصل لم ينقلوا ما نقلوه إلا لداع دعاهم إلى النقل، وإذا كان ذلك عليهم جائزا وغير ممتنع سقطت الحجة بالنقل وثبتت الحاجة إلى إمام مؤد لما وقع من بيان الرسول لأنه لو كان الأمر بخلاف ما ذكرناه، وعلى ما ظنه خصومنا لم يكن لله تعالى على من لم يشاهد زمن النبي حجة إذا كان النقل بالصورة التي ذكرناها، وهذا يبطل قوله: " إن التواتر يقوم مقام الإمام في بيان مراد الرسول (182) ".
فأما ما ذكره في السموم القاتلة، والأغذية المتبقية (183) فمما لا نعتمده أيضا في وجوب الحاجة إلى الأئمة ولو كان ذلك مما لا يستفاد بالتجربة والاختبار لما وجب الحاجة إلى الإمام في كل زمان، بل كان لا يمتنع أن ينبه عليه في الابتداء إمام واحد ويستغني من يأتي من بعده عن بيان الإمام لذلك بالنقل، وليس يجري هذا الوجه مجري ما ذكرناه قبل هذا الفصل في باب العبادات وشكر المنعم، وأنه غير ممتنع على الخلق أن يكتموا ما نبه الرسول عليه من ذلك لداع وغرض، وبين الأمرين فرق واضح. لأن ما يعلمه الناس من السموم القاتلة. والأغذية المصلحة. وما جرى مجراهما مما به قوام أبدانهم هم كالملجئين إلى نقله وإعلام أولادهم وأخلافهم (184) ومن يأتي بعدهم، مضرته ليجتنبوا منه المضر ويتناولوا المصلح. ويبعد بل يستحيل أن يكون لعاقل داع إلى كتمان ما جرى هذا المجرى، وليس بمستحيل ولا ممتنع أن يعرض الناس عن نقل العبادات وكثير من التكليفات لأغراض معقولة فلهذا جاز أن يستغنى عن المبين في كل وقت لأحوال السموم والأغذية وإن لم يجز أن يستغنى عنه في باب الدين والعبادات.
وأما قوله: " ويقال لهم: إن وقوع القتل بالسم ليس بواجب، وقد كان يجوز أن تتعلق الشهوة به فيصير غذاء، وأن تجري العادة فيه بخلاف ذلك فلا يكون قاتلا فما الذي يمنع أن يخلي الله المكلفين من حجة إذا كانت الحالة هذه، إلى آخر كلامه (185)... " فإنه لا يقدح في طريقة جعل الإمام مبينا لهذه الأمور، لأنهم إنما أوجبوا الحجة إليه من هذا الوجه بطبائع الانسان، وسائر الناس وعاداتهم على ما هي عليه، وما قدره صاحب الكتاب لا يصح إلا بانتقاض العادات، وخروج الناس عن طبائعهم المعروفة، ولهم أن يقولوا: إن تقديرك لو وقع لارتفعت الحاجة إلى الإمام في هذا الوجه وإن لم يرتفع من وجه آخر، كما أنا لو قدرنا عصمته جميع الخلق، وامتناع وقوع القبيح منهم لم يكن لهم حاجة إلى الإمام على بعض الوجوه ولم يمنع ذلك من القضاء بحاجتهم إليه إذا لم يكن هذه حالهم.
فأما قوله: " وبعد فإن ذلك يوجب الاستغناء بالرسول إذا بين بيانا يشتهر بطريقة التواتر هذه الأمور التي ذكروها، كما يستغنى الآن عن الإمام في وجوب الصلوات، فإن الفرض أن يستقبل القبلة (186) ويصلي بطهارة إلى غير ذلك... (187) " فقد بينا ما يصح أن يستغنى فيه بالتواتر وما لا يصح أن يستغنى بذلك فيه وفصلنا بين الأمرين.
فأما الإمام فليس يستغنى عنه في وجوب الصلوات إلى سائر ما ذكره على ما ظنه. لأن أصحابنا قد ذكروا وجوه الحاجة إليه في ذلك.
فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات.
ومنها أن يبين ذلك ويفصله، وينبه على مشكله وغامضه.
ومنها كونه من وراء الناقلين ليأمن المكلفون من أن يكون شئ من الشرع لم يصل إليهم.
ولو وجب أن يطلق الاستغناء عن الإمام في هذه الأمور من حيث كان لنا طريق يوصل إلى العلم بها من غير جهة لوجب على صاحب الكتاب وأهل مذهبه أن يطلقوا الاستغناء عن الرسول في جميع ما أداه إلينا مما علمناه قبل أدائه بالعقل، ومن أطلق بذلك خرج من جملة المسلمين.
وليس يمكن أن يمتنع منه ويحتج فيه إلا بمثل ما احتججنا به.
فأما قوله: " واعلم أن الذي أوجب هذا الخلاف الشديد (188) الذي هو أصل الكلام مع الإمامية (189) " إلى قوله: " لأن الرسول [ صلى الله عليه ] كما تغني مشاهدته وسماع كلامه في معرفة الأمور من قبله عن غيره في وقته فكذلك يجوز أن يستغنى بما يتواتر عنه من الأخبار في سائر ما يحتاج إليه عن إمام بعده بالصفة التي ذكروها (190)... " فقد مضى الكلام في أن التواتر لا يغني عن ذلك. والفصل بينه في الاستغناء به بعد الرسول وبين استغنائنا بمشاهدة الرسول وسماع كلامه في معرفة الأمور عن غيره واضح، لأنا نأمن في حال مشاهدته وسماع كلامه على من يكتم بعض ما يجب أداؤه، ويعرض عنه بشبهة وسهو. وما جرى مجراهما، فنستغني في حال مشاهدته بكلامه وبيانه لما ذكرناه، وليس كذلك الحال بعد وفاته، لأنا قد بينا أن الإعراض عن النقل بشبهة أو تعمد غير مأمون على الناقلين، فكيف يجوز أن يحمل إحدى الحالين على الأخرى مع تباعد بينهما.
فأما قوله: " ولذلك ارتكب بعضهم عند هذا الالزام القول بإبطال التواتر،... (191) " فهو سهو منه عجيب، لأنا لا نبطل - بحمد الله - التواتر، وهو عندنا الحجة في ثبوت السمعيات، وكيف نبطله وبه نحتج في النص على أعيان الأئمة، ومعجزات الأنبياء؟، فإن كان يظن إذا جوزنا على المتواترين الإعراض عن النقل بشبهة أو تعمد فقد أبطلنا التواتر، فقد وقع بعيدا، لأن الناقلين إنما يكونون متواترين إذا نقلوا أو أخبروا على وجه مخصوص، وعندنا أنهم إذا نقلوا الخبر على وجه التواتر كان نقلهم حجة، وتجويز الإعراض عن النقل عليهم لا يقدح في صحة التواتر، ولا يكون تجوزه عليهم مبطلا له.
فأما قوله: " وبعضهم ارتكب القول بجواز الكتمان على الخلق العظيم (192)، وارتكب بعضهم إبطال الاجماع (193) لأنهم رأوا مع القول بصحة هذه الأدلة أنه لا يصح تعلقهم بما قدمنا في أنه لا بد من حجة في كل وقت، (194).... " فإنا لم نرتكب ما حكاه، بل ذهبنا إليه واعتقدناه للأدلة الباهرة التي قد ذكرنا بعضها.
وإنما يقال: ارتكب كذا وكذا فيما لا دليل عليه، وفيما يضطر المرتكب لزوم المحجة إلى ارتكابه. ولم نجوز الكتمان من حيث نضطر ليصح لنا ما ذكرناه، بل لأن الاعتبار كشف لنا عن جوازه عليهم.
فأما الاجماع فليس بباطل عندنا لأن الدليل قد دلنا على أن في جملة المجمعين معصوما. حجة لله تعالى، فليس يجوز أن ينعقد الاجماع على باطل من هذا الوجه، لا كما يدعيه المخالفون.
ثم يقال له: لكنك وأصحابك ارتكبتم أن الخلق لا يجوز عليهم الكتمان، وتجاوزتم ذلك إلى الجماعات، وادعيتم أيضا أن الأمة لا تجتمع على باطل بشبهة ولا تعمد (195) ليسلم لكم ما تريدون نصرته من الاستغناء عن الأئمة والحجج بعد الرسول صلى الله عليه وآله. ولأنكم رأيتم أن في تجويز ذلك على الأمة ونفي وجود الأئمة انسلاخا عن الدين، وخروجا عن الاسلام. وطريقنا إلى ارتفاع الثقة بشئ من العبادات والشرع فحملتم نفوسكم على دفع المعلوم الجائز في العقول ليصح لكم مذاهبكم الفاسدة.
فأما قوله: " ثم دعا ذلك بعضهم إلى إنكار العقليات أو بعضها لكي يثبت له إثبات حجة في الزمان فأبطلوا الحجج الصحيحة لكي يثبتوا ما لا أصل له (196)، * وما لو ثبت لكان فرعا على هذه الحجج، لأن إثبات الإمام لا يمكن إلا بطريقة العقل أو التواتر... (197) * " فواضح البطلان، وكيف يبطل أدلة العقل من تقاضى خصومه إليها. ويعول في حجاجهم ودفع مذاهبهم عليها لولا يرى صاحب الكتاب أن معتمدنا من أول كلامنا إلى هذه الغاية في إثبات الرئاسة على محض دلالة العقل فكيف يتوهم المحتج بالعقل اعتقاد بطلانه؟، والذين أنكروا العقليات في الحقيقة وأبطلوها من حيث لا يشعرون هم الذين نفوا الحاجة إلى الرؤساء مع شهادة العقل بالحاجة إليهم.
فأما قولهم: " * ثم أداهم ذلك إلى إثبات أشخاص * (198) لا أصل لهم لكي يصلح (199) ما ادعوه فاثبتوا في هذا الزمان إماما مختصا بنسب واسم من غير أن يعرف منه (200) عين أو أثر... " فمبني على مجرد دعوى ومحض الاقتراح (201)، وقد دللنا على أن الإمامة واجبة في كل زمان بما لا حيلة فيه ولا قدرة على دفعه، وإذا استحال أن يكون القديم تعالى غير مزيح لعلل عباده لما فيه لطفهم ومصلحتهم وجب القطع على وجود الأئمة، وليس جهل من جهل وجودهم ودخلت عليهم الشبهة في أمرهم بقادح في الأدلة، ولا منع معترض عليها (202).
وقوله: " لا يعرف منه عين ولا أثر "... إن أراد أن لا يعرف بالدليل فما ذكرناه يبطله، وإن أراد بالمشاهدة فليس كل ما كان غير مشاهد يجب نفيه وإبطاله.
وأما قوله: " وأدى بعضهم هذه الطريقة إلى ادعاء الضرورة في النصوص على المخالف، بل أدى بعضهم إلى القول بأن المعارف كلها ضرورية (203)... " (204) فليس فينا من يدعي الضرورة في النص إلا على السامع له، ممن وقع من جهته، فأما من يعرفه من طرق الخبر فخارج عن باب الضرورة، وما نعرف فينا أحدا محصلا يدعي أن المعارف كلها ضرورية. وقد كان يجب أن لا يعير باعتقاد الضرورة في المعارف من له مثل أبي عثمان الجاحظ (205) الذي افتتح هذا الرأي المنكر، وتناهى فيه إلى ما هو المشهور وأما (206) قوله: " وبعيد في كثير منهم أن يعتقد ما يظهر عنه في هذه العلل لأن اعتقادها لا يصح مع التمسك بالديانات التي ذكرناها، ولهذه الجملة قال شيخنا أبو علي (207): إن أكثر من نصر هذا المذهب كان قصده الطعن في الدين والاسلام فتسلق بذلك إلى القدح فيهما. لأنه لو طعن (208) فيهما بإظهار كفره وإلحاده لقل (209) القبول منه، فجعل هذه الطريقة سلما إلى مراده نحو هشام بن الحكم (210) وطبقته ونحو أبي عيسى الوراق (211) وأبي فص الحداد (212) وابن الراوندي " - إلى قوله -: " وبين شيخنا أبو علي أنهم تجاوزوا ذلك إلى إبطال التوحيد والعدل، لأن هشام بن الحكم قال بالتجسيم وبحدوث العلم (213)، وبجواز البداء (214) إلى غير ذلك مما لا يصح معه التوحيد وقال بالجبر (215)، وما يتصل بتكليف ما لا يطاق، ولا يصح معه التمسك بالعدل، وأما حال ابن الراوندي في نصرة الإلحاد، وأنه كان يقصد بسائر ما يؤلفه إلى التشكيك فظاهر، وإنما كان يؤلف بضرب من الشهرة والمنفعة (216) وأما أبو عيسى فتمسكه بمذاهب الثنوية ظاهر، وأنه كان عند الخلوة ربما قال: " بليت بنصرة أبغض الناس إلى، وأعظمهم إقداما على القتل... " (217) فعدول عن النظر والحجاج إلى القذف والسباب والافتراء، أو استعمال طريقة جهال العامة في التشنيع على المذاهب،، وسب أهلها، وتقبيحها في النفوس بما لو صح لم يك نقضا لأصل المقالة، ولا قادحا في صحة النحلة (218)، وقلما يستعمل ذلك إلا عند نفاد الحجة، وقلة الحيلة.
ونحن مبينون عما في كلامه من الخطأ والتحامل.
فأما ما رمي به هشام بن الحكم رحمه الله بالتجسيم فالظاهر من الحكاية عنه القول بجسم لا كالأجسام. ولا خلاف في أن هذا القول ليس تشبيه ولا ناقض لأصل، ولا معترض على فرع، وأنه غلط في عبارة يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة.
وأكثر أصحابنا يقولون: إنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة. فقال لهم: إذا قلتم إن القديم تعالى شئ لا كالأشياء، فقولوا: إنه جسم لا كالأجسام (219) - وليس كل من عارض بشئ وسأل عنه يكون معتقدا له، ومتدينا به، وقد يجوز أن يكون قصد به إلى استخراج جوابهم عن هذه المسألة.
ومعرفة ما عندهم فيها، أو إلى أن يبين قصورهم عن إيراد المرتضى في جوابها. إلى غير ذلك مما يتسع ذكره.
فأما الحكاية عنه أنه ذهب في الله تعالى أنه جسم له حقيقة الأجسام الحاضرة. وحديث الأشبار المدعى عليه فليس نعرفه إلا من حكاية الجاحظ عن النظام (220) وما [ هو ] فيها إلا متهم عليه، غير موثوق بقوله في مثله، وجملة الأمر إن المذاهب يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها.
وأصحابهم المختصين بهم ومن هو مأمون في الحكاية عنهم، ولا يرجع فيها إلى دعاوى الخصوم فإنه إن يرجع إلى ذلك في المذهب اتسع الخرق، وجل الخطب، ولم نثق بحكاية في مذهب ولا استناد مقالة.
ولو كان يذهب هشام إلى ما يدعونه من التجسم يوجب أن يعلم ذلك ويزول اللبس فيه كما يعلم قول الخوارزمي وأصحابه بذلك، ولا نجد له دافعا كما ولا نجد لمقالة الخوارزمي دافعا.
ومما يدل على براءة هشام من هذا القرف (221) ورميه على هذا المعنى الذي يدعونه ما روي عن الصادق عليه السلام في قوله: " لا تزال يا هشام مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك " وقوله عليه السلام حين دخل عليه وعنده مشائخ الشيعة فرفعه على جماعتهم، وأجلسه إلى جانبه في المجلس وهو إذ ذاك حديث السن: " هذا ناصرنا بقلبه ويده ولسانه ".
وقوله عليه السلام: " هشام بن الحكم رائد حقنا، وسايق قولنا، المؤيد لصدقنا، والدافع لباطل أعدائنا، من تبعه وتبع أمره تبعنا. ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا ".
وأنه عليه السلام كان يرشد في باب النظر والحجاج، ويحث الناس على لقائه ومناظرته فكيف يتوهم عاقل - مع ما ذكرناه - على هشام هذا القول بأن ربه سبعة أشبار بشبره؟ وهل ادعاء ذلك عليه - رضوان الله عليه - مع اختصاصه المعلوم بالصادق عليه السلام وقربه منه، وأخذه عنه إلا قدح في أمر الصادق عليه السلام ونسبة له إلى المشاركة في الاعتقاد الذي نحلوه (222) هشاما وإلا كيف لم يظهر عنه (223) من التنكير (224) عنه، والتبعيد له ما يستحقه المقدم على هذا الاعتقاد المنكر، والمذهب الشنيع فأما حدوث العلم (225) فهو أيضا من حكاياتهم المختلقة وما نعرف للرجل فيه كتابا، ولا حكاه عنه ثقة.
فأما الجبر وتكليف ما لا يطاق (226) مما لا نعرفه مذهبا له، ولعله لم يتقدم صاحب الكتاب في نسبة ذلك إليه غيره. اللهم إلا أن يكون شيخه أبو علي الجبائي فإنه يملي بكل تحامل وعصبية، وقليل هذه الحكايات ككثيرها في أنها إذا لم تنقل من جهة الثقة وكان المرجع فيها إلى قول الخصوم المتهمين لم يحفل بها (227)، ولم يلتفت إليها. وما قدمناه من الأخبار المروية عن الصادق عليه السلام، وما كان يظهر من اختصاصه به وتقريبه له، واجتبائه (228) إياه من بين صحابته يبطل كل ذلك. ويزيف (229) حكاية روايته.
وأما البداء، فقول هشام وأكثر الشيعة فيه هو قول المعتزلة بعينه في النسخ في المعنى، ومرادهم به مراد المعتزلة بالنسخ. وإنما خالفوهم في تلقبه بالبداء لأخبار رووها (230) ولا معتبر في الألفاظ والخلاف فيها، فأما ابن الراوندي، فقد قيل: إنه إنما عمل الكتب التي شنع بها عليه معارضة للمعتزلة، وتحديا لهم. لأن القوم كانوا أساؤوا عشرته، واستنقصوا معرفته، فحمله ذلك على إظهار هذه الكتب ليبين عجزهم عن استقصاء نقضها، وتحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة، وقد كان يتبرأ منها تبرءا ظاهرا، وينتفي من عملها، ويضيفها إلى غيره.
وليس يشك في خطئه بتأليفها، سواء اعتقدها أم لم يعتقدها.
وما صنع ابن الراوندي من ذلك إلا ما قد صنع الجاحظ مثله أو قريبا منه، ومن جمع بين كتبه التي هي: (العثمانية) (231) و (المروانية) و (الفتيا) و
(العباسية) و (الإمامية) و (كتاب الرافضة والزيدية) رأي من التضاد واختلاف القول ما يدل على شك عظيم وإلحاد شديد، وقلة تفكر في الدين.
وليس لأحد أن يقول: إن الجاحظ لم يكن معتقدا لما في هذه الكتب المختلفة، وإنما حكى مقالات الناس وحجاجهم. وليس على الحاكي جريرة (232)، ولا يلزمه تبعة. لأن هذا القول إن قنع به الخصوم فليقنعوا بمثله في الاعتذار، فإن ابن الراوندي لم يقل في كتبه هذه التي شنع بها عليه: إنني أعتقد المذاهب التي حكيتها، وأذهب إلى صحتها. بل كان يقول: قالت الدهرية (233)، وقال الموحدون، وقالت البراهمة (234)، وقال مثبتو الرسول، فإن زالت التبعة عن الجاحظ في سب الصحابة والأئمة والشهادة عليهم بالضلال، والمروق (235) عن الدين بإخراجه كلامه مخرج الحكاية فلتزولن أيضا التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك.
وبعد، فليس يخفى كلام من قصده الحكاية، وذكر المقالة من كلام المشيد لها، الجاهد له (236) نفسه في تصحيحها وترتيبها. ومن وقف على كتب الجاحظ التي ذكرناها علم أن قصده لم يكن الحكاية، وكيف يقصد إلى ذلك من أورد من الشبه والطرف ما لم يخطر كثير منه ببال أهل المقالة التي شرع في حكايتها. وليس يخفى على المنصفين ما في هذه الأمور.
وأما أبو حفص الحداد فلسنا ندري من أي وجه أدخل في جملة الشيعة. لأنا لا نعرفه منهم، ولا منتسبا إليهم، ولا وجد له قط كلام في الإمامة، وحجاج عنها؟ فليس ادعاؤه أنه من جملتهم من تبريهم منه، وأنه لم يظهر منه ما يقتضي لحوقه بهم إلا كادعائهم عليه أنه من المعتزلة فليس بعده من أحد المذهبين إلا كبعده من الآخر.
فأما أبو عيسى الوراق فإن التثنية (237) مما رماه بها المعتزلة، وتقدمهم في قذفه بها ابن الراوندي لعداوة كانت بينهما، وكانت شبهته في ذلك وشبهة غيره تأكيد أبي عيسى لمقالة الثنوية في كتابه المعروف ب (المقالات) وإطنابه في ذكر شبهتهم، وهذا القدر إن كان عندهم دالا على الاعتقاد فليستعملوه في الجاحظ وغيره ممن أكد مقالات المبطلين ومحضها وهذبها (238) فأما الكتاب المعروف ب (المشرقي) وكتاب (النوح على البهائم) فهما مدفوعان عنه، وما يبعد أن يكون بعض الثنوية عملهما على لسانه، لأن من شأن من يعرف ببعض المذاهب أن يضاف إليه مما يدخل في نصرتها الكثير، وليس بنا أن نضيف مثل هذه المذاهب القبيحة إلى من لم يكن متظاهرا بها، ولا مجاهرا باعتقادها. وإن لم يكن يتبرأ منها، ويتبرأ من أهلها. لأن الدين يحجز عن ذلك ويمنع منه، ولا نعمل إلا على الظاهر، وأن واحدا أو اثنين ممن انتسب إلى التشيع واحتمى به لو كان في باطنه شاكا أو ملحدا أي تبعة تلزم بذلك نفس المذهب وأهله إذا كانوا ساخطين لذلك الاعتقاد، ومكفرين (239) لمعتقده والذاهب إليه؟ ولو جعل مثل هذا وصمة على المذهب وعيبا على أهله لكانت جميع المذاهب موصومة معيبة، لأنها لا تخلو من أن ينسب إليها من لم يكن في الحقيقة منها، وأين المعير بما تقدم. والقادح به عن قول شيوخه وأسلافه القبيحة. ومذاهبهم الشنيعة؟ وكيف لم يذكر قول أبي الهذيل (241) بتناهي مقدورات الله تعالى ومعلوماته، وقوله: " إن علم الله تعالى هو الله " (240) وهذا أقبح من القول المحكي عن هشام رحمه الله لأن أبا الهذيل قد قال في تناهي المعلوم بأقبح من قوله وأضاف إليه المقدور.
وقول النظام: إن الله لا يقدر على الظلم " وحمله أن قال: " لو أن طفلا وقع في شفير جهنم لم يوصف الله تعالى بالقدرة على إلقائه فيها، وإن كان يجوز وصف الملائكة والزبانية بذلك " وقوله بالمداخلة والطفرة (242)، وأنه لا نهاية لأجسام العالم في التجزي، ونفيه الأعراض وهذا مزج التعطيل والالحاد بالتجاهل والعناد.
وقول معمر (243): " من زعم أن الله يعلم نفسه فقد أخطأ لأن نفسه ليست غيره والمعلوم غير العالم " (244)، واعتقاده أن الأمراض والأسقام من فعل غير الله تعالى (245)، وكذلك الألوان والطعوم والأراييح التي في العالم (246).
وقول هشام بن عمرو الفوطي (247) بنفي دلالة الأعراض على الله تعالى (248)، واعتقاده أن حرب الجمل لم يكن عن قصد من أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه، ولا من عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم، ولا برضى منهم. وإنما اجتمعوا لتقرير الأمور وترتيبها حتى وقع بين نفر من الأعراب من أصحاب الجميع الحرب والكبراء ساخطون لها. وتخطئة من زعم أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل كونها.
وهذا القول الذي حكوه عن هشام بن الحكم رحمه الله تعالى مع نفي أصحابه له قد صححوه عن شيخهم (249).
وغلط الجاحظ قبيح في المعرفة، واعتقاده استحالة أن يقدر الله تعالى على إعدام الأجسام، وقوله: " إن الله لا يخلد كافرا في النار ولا يدخله إليها، وإن النار هي التي تدخل الكافر إليها " حتى حكى عن بعض أصحابه وقد سئل عن معنى هذا القول: وكيف صارت النار تدخل الكفار نفسها؟ فقال: " لأنهم عملوا أعمالا صارت أجسادهم إلى حال لا يمتنع النار إذا جاورتها في القيامة من اجتذابها إليها بطباعها " (250) وقوله ثمامة (251) في المانية (252) وذهابه في أن المعارف ضرورية إلى أقبح من مذهب الجاحظ وأغلظ، واعتقاده أنه لا فعل للعباد إلا الإرادة فقط. وما سوى ذلك فهو حدث لا محدث له.
وكيف ذهب عن حكاية الجاحظ عن واصل بن عطاء (253) وعمرو بن عبيد ما يطم (254) على كثير مما تقدم؟
ونحن نحكي لفظه بعينه، قال: " كان واصل بن عطاء يجعل عليا وطلحة والزبير بمنزلة المتلاعنين (255) يتولى كل واحد منهم على حاله، ولا يتولاهما مجتمعين، وكذلك قوله: في إجازة شهادتهم مجتمعين ومتفرقين، وكان عمرو بن عبيد لا يجيز شهادتهما (256) مجتمعين ولا متفرقين وكان يفصل بين الولاية والشهادة، وكان يقول: " قد أتولى من لا أقبل شهادته، وقد وجدت المسلمين يتولون كل مستور من أهل القبلة. ولو شهد رجل من عرضهم (257) على عثمان وأبي بكر أو عمر بن الخطاب سأل الحاكم عنه السؤال الشافي فأنا أتهم كل واحد منهما بسفك تلك الدماء، وقد أجمعوا على أن المتهم بالدماء غير جائز الشهادة ".
هذه ألفاظه حرفا بحرف في كتابه المعروف ب (فضائل المعتزلة) ولا حكاية أصح وأولى بالقبول من حكاية الجاحظ عن هذين الرجلين (258) وهما شيخا نحلته، ورئيسا مقالته.
وقد ذكر أيضا هذه الحكاية البلخي في (كتاب المقالات) (259)، وأسندها إلى الجاحظ، وقال عند انتهائها: " وبعض أصحابنا يدفع ذلك عن عمرو بن عبيد، ويقول: إن عمرا لم يكن بالذي يخلف واصلا.
ويرغب عن مقالته " فكأنه صحح عليها المذهب الأول الذي هو اعتقاد " أنهما كالمتلاعنين، وأن شهادتهما تقبل إذا كانا متفرقين، ولا تقبل إذا كانا مجتمعين " ولم يكن عنده في دفع المذهب الثاني أكثر من حكايته عن بعض أصحابه بتنزيه عمرو عن مخالفة واصل، وهذا إنكار ضعيف، والمنكر له للعلة التي حكاها كالمقر به، بل أقبح منه حالا.
ومن عجيب أن هؤلاء القوم. وقبيح تعصبهم أنهم يناقضون شيخهم أبا عثمان الجاحظ في المعارف والطبائع وهما أصلان من أصول الدين كبيران ليس الغلط فيهما يسيرا (260)، وفي تضليله لوجوه الصحابة، والشهادة عليهم بتكلف ما لا يعنيهم. والذهاب عما يهمهم، ثم في سلبه أمير المؤمنين عليه السلام مرتبته في الفضل، ودفعه أكثر ما روي من فضائله ومناقبه، وتأوله ما استحيى هو من دفعه المتأول الذي يخرجه به عن الشهادة بالفضل، والقضاء بالتقدم حتى أخرجه ذلك إلى القدح في إمامته في الكتاب المعروف ب " المروانية " وإقامة المعاذير لمعاوية في حربه، وخلع طاعته، إلى غير ما ذكرناه من الأمور التي لا يقدم عليها مسلم.
ولا يتحاسن (261) على التظاهر بها مؤمن ولا متدين، وهم في كل ذلك يذكرونه (262) بأحسن الذكر! ويثنون على بأفضل الثناء، ولا يجرون ذكره إلا مع مشيختهم، وتشييخهم له (263) ورغبتهم إلى الله تعالى في الرضوان عليه، حتى كأنهم إنما يناقضونه في بعض مسائل الاجتهاد كلمس الذكر، (264) ورفع اليدين في التكبير (265)، وما جرى مجراهما، ولا يدعوهم ما ظهر من خلافه العظيم،، وإقدامه على ما إن لم يوجب تكفيره فأقل أحواله أن يوجب تفسيقه. ويمنع من تعظيمه إلى الطعن عليه والبراءة منه، أو إلى أن يمسك ويكف عن الأمرين ويريد (266) منا أن نرجع عن ولاء هشام بن الحكم رحمة الله عليه، واعتقاد زكاته لأجل دعواهم عليه ما لا حقيقة له عندنا، ولا مرجع فيه إلا إلى أقوالهم المحرفة. وحكاياتهم المضعفة، ومن نظر فيما ذكرناه علم طريقة القوم في عشق مذهبهم، والتعصب لنحلتهم، وأن غرضهم تمزيق نصرتنا بكل حق وباطل، وغث وسمين.
فأما قوله: " وإنما يخرج عن هذه الطريقة من يكون مقلدا ممن يسلك في الإمامة المسلك الذي ذكرناه، فأما من لم يتحقق (267) بما قدمناه من الطريق (268) في الإمامة، وسلك طريقة متوسطة بين العقل والشرع ممن كان يتمسك بالتوحيد والعدل فهو برئ مما نسبناه إلى من تقدم ذكره كأبي الأحوص والنوبختية (269) وغيرهم لأنهم لا يسلكون ما قدمناه، وإنما يتبعون في الأكثر طريقة السمع وإن كانوا ربما التجؤوا إلى طريقة العقل،... (270) " فكلام ينقض بعضه بعضا ومع أنه كذلك قد تضمن غلطا على القوم المذكورين في مذاهبهم، وإنكار اللطف من مقالتهم إما تعمدا على سبيل التلبيس والمغالطة أو سهوا وكلاهما قبيح.
فأما وجه المناقضة فإن صاحب الكتاب إنما نسب إلى من تقدم الإلحاد وقرفهم به (271)، وبإبطال الشرائع (272)، ونقض الأصول من حيث ذهبوا إلى وجوب الإمامة من طريق العقول، وأن الإمام يجب أن يكون معصوما منزها كاملا وافرا عالما فاضلا (273) ثم برأ أبا الأحوص والنوبختية مما قذف به من تقدم. وادعى عليهم أنهم لا يقولون بمثل قولهم، يعني في الرجوع إلى العقول في باب الإمامة.
ثم قال في آخر الفصل: " وإن كانوا ربما التجؤوا إلى طريقة العقل " فأدخلهم بهذا القول في جملة من تقدم، وأوجب فيهم كل ما وصف به المتقدمين من حيث لا يشعر لإضافته إليهم الالتجاء إلى الطريقة التي هي عنده سبب تهمة من ذكر فقذفه، وهذا تناقض ظاهر.
فأما غلطه على القوم فبين، لأن المعلوم منهم اعتقاد وجوب الإمامة، وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع ذلك وإن كانوا ربما استدلوا بالسمع استظهارا وتصرفا في الأدلة، وليس كل من استدل على شئ بالسمع فقد نفى دلالة العقل عليه، وهذه كتب أبي محمد وأبي سهل رحمهما الله في الإمامة تشهد بما ذكرناه. وتتضمن نصرة جميع ما ذكره أبو عيسى الوراق وابن الراوندي في كتبهما في الإمامة، بل قد اعتمدا على أكثر ما ذكراه من الأدلة، وسلكا في نصرة أصول الإمامة تلك الطرق بعينها. ومن خفي عليه ما ذكرناه من قولهم ظالم لنفسه بالتعرض للكلام في الإمامة!.
فأما قوله: " وأحد ما يدل على أن الإمامة لا تجب من جهة العقل أن الإمام إنما يراد لأمور سمعية كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وما شاكلها، وإذا كان ما يراد له الإمام لا مدخل للعقل فيه فبأن لا يكون له مدخل في إثبات الإمامة أولى... " (274) فقد تقدم من كلامنا في إبطاله ما يغني، وبينا أن ما يراد له الإمام أمر يتعلق بواجبات العقل، وأن الحاجة إليه واجبة سواء وردت العبادة بالسمع أو لم ترد، وليس إذا كان أحد ما يراد الإمام له ما جاء به السمع كإقامة الحدود وما أشبهها يجب أن تبطل الحاجة إليه من وجه آخر. وإنما كان في هذا الكلام شبهة لو كانت الحاجة إليه في الأمور السمعية تنافي الحاجة في الأمور العقلية، فأما إذا لم يكن كذلك فلا طائل (275) فيما ذكره.
فأما قوله: " فإن قالوا: إنا لا نسلم أن الإمام يراد لما ذكرتموه فقط... " - وقوله -: " فطريق الكلام معهم أن يقال: لا بد من أن يكون قيما بأمر ما (276)، إما أن يكون بما ذكرناه، أو يكون حجة وقد أبطلنا ذلك... " (277) فقد سلف الكلام على ما ظن به صاحب الكتاب أنه أبطل كونه حجة. ودللنا على أنه لطف في الدين وحجة بما لا شبهة في مثله.
فأما قوله: " فإن قالوا: ألا يحتاج إليه ليؤدي عن الرسول الشريعة،... "؟ وقوله: " فقد علمنا أن التواتر يغني عن ذلك. وكذلك الاجماع،... " (278) فقد مضى في التواتر ما يكفي.
فأما الاجماع فإنا وإن ذهبنا إلى أنه لا يجوز أن ينعقد على باطل من حيث استقر عندنا أن في جملة المجمعين معصوما فليس يجوز أن يجعل الإمام حجة قبل ثبوت وجود المعصوم. وكونه في جملة المجمعين، فمن هاهنا قلنا: إن الاجماع لا يستغنى به عن الإمام، فكيف يتوهم عاقل الاستغناء بالتواتر والاجماع عن مؤد للشريعة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتسعة أشعار ما يحتاج إليه لا إجماع فيه، ولا تواتر به؟ ولو عول بما في الشريعة على التواتر والاجماع لوجب أن يكون ما لم يجمع عليه ولم يتواتر الخبر به ليس من الشريعة. أولا حجة علينا فيه، وكلا الأمرين فاسد.
فأما قوله: " فإن قالوا بجواز الخطأ عليهما (279) " (280) فقد بينا فساد ذلك، وبينا أيضا أن إثبات الإمام لا يصح إلا بإثبات التواتر، فهو كالفرع على صحته. ولا يصح مع بطلانه القول بإثبات الإمامة، فليس الأمر كما توهم. لأن التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الأئمة في الجملة، ووجوب وجودهم في الأعصار، بل طريق ذلك هو العقل وحجته، وإنما التواتر طريق إلى إثبات أعيان الأئمة، ولكون الإمام فلانا دون غيره، وإن كان إلى ذلك أيضا طريق آخر وهو المعجز، فكيف يظن أنه لا يصح القول بالإمامة مع بطلانه على أن ذلك مبني على توهمه إنا نبطل التواتر، وقد قدمنا أن الأمر بخلافه، وإنا وإن جوزنا أن يعرض المتواترون عن النقل لأجل ما ذكرنا فغير مجوزين على المتواترين الكذب فيما يتواترون به فأما قوله: " ومتى قالوا: يحتاج إليه (281) لإزالة السهو والخطأ، إلى غير ذلك فقد بينا أن ذلك يزول من دون الإمام إذا عرف * أن الإمام لا يحتاج إليه في ذلك * (282) وأن السهو لا يقع في نقل الأخبار على طريق التواتر ولا يصح على جميع الأمة (283).... " فقد تقدم أن ما يكون الإمام لطفا فيه وفي ارتفاعه من ضروب الخطأ لا يقوم فيه غيره مقامه.
وقوله: " إن السهو لا يقع في نقل الأخبار على طريق التواتر ولا يصح على جميع الأمة " فهب أن الأمر كما ادعى في السهو فمن أين نأمن عليهم تعمد الخطأ؟ يعني فيما تجتمع الأمة عليه، وإذا كان ما يفزع إليه في امتناع السهو عليهم من العادة لا ينافي تعمد الخطأ، فقد ثبتت الحاجة إلى الأئمة على كل حال فبطل ما يدعي من الاستغناء عنهم.
فأما قوله: " فإن قالوا يحتاج إليه لإزالته ما اختلف الناس فيه من الديانات، فقد علمنا أن مع بيان الإمام الخلاف قائم فوجوده كعدمه (284) في هذا الباب، فإن كان يحتاج إليه - عندهم - ليزيل الخلاف، فقد بينا فساده، وإن كان يحتاج إليه لصحة زوال الخلاف ببيانه (285) فأدلة العقل والشرع تغني عن ذلك،... " فما يختلف الناس فيه من الديانات على ضربين: عقلي وسمعي:
فأما العقلي فمن حيث كانت الحجة به قائمة، والطريق إلى الوصول إليه ممكنا لكل متكامل الشروط لم يحتج إلى الإمام فيه إلا من الوجه الذي قدمناه، وهو أن يكون مؤكدا، وإن كان لا يمتنع أن يكون لتنبيهه وتذكيره بالنظر من الحظ ما ليس لغيره.، وأما السمعي فعلى ضربين: منه ما قد ورد به التواتر على حد يرفع العذر، ويزيل الشك والريب، ومنه ما ليس كذلك.
فأما الذي لم يتواتر به الخبر فالحاجة إلى الإمام فيه ظاهر [ ة ]، لأن الخلاف إذا وقع فيه ولم يكن لنا مفزع إلا إلى قوله وبيانه فكان حجة في قطع الخلاف.
وليس معنى قولنا أن حجة في ذلك ما ظنه صاحب الكتاب من أن وجوده يرفع الخلاف جملة، وإنما أردنا أن قوله يكون المفزع والحجة عند الخلاف، وأنه لولا مكانه لم يكن لله تعالى على المختلفين في الشئ الذي بيناه حجة، مع أنه لا يمكن أن الخلاف عند وجود الأئمة في الدين كالخلاف عند فقدهم. فلا بد أن يكون لوجودهم في رفع ذلك مزية ظاهرة، وهذا يبين أن الخلاف قد يزول بهم وإن كان ربما لم يزل كل الخلاف.
فأما ما ورد به التواتر من السمعيات فالحاجة إليه ماسة لأنه يبينه ويؤكده، ولأن من المتواترين - أيضا - لا يؤمن منهم الرجوع عن التواتر فليلحق هذا القسم بالآخر فيكون الحجة حينئذ في الجميع قول الإمام وبيانه.
____________
(1) كلمة " جميع " ساقطة في الموضعين من مطبوعة المغني.
(2) ما حذفه المرتضى من كلام القاضي يتعلق بالغلاة والمفوضة والقائلين بالتناسخ ممن وصفوا بالتشيع وما هم منه بفتيل ولا نقير.
(3) المغني ج 20 ق 1 ص 2.
(4) أي في صفات الإمام وما يتولاه من الأمور.
(5) الدليل العقلي على وجوب عصمة الإمام أن الخطأ من البشر ممكن ولا يمكن رفع الخطأ الممكن إلا بالرجوع إلى المجرد من الخطأ وهو المعصوم ولا يمكن افتراض عدم عصمته لأدائه إلى التسلسل أو الدور. أما التسلسل فإن الإمام إذا لم يكن معصوما احتاج إلى إمام آخر، لأن العلة المحوجة إلى نصبه هي جواز الخطأ على الرعية، فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى إمام آخر فإن كان معصوما وإلا لزم التسلسل، وأما الدور فلحاجة الإمام إذا لم يكن معصوما للرعية لترده إلى الصواب مع حاجة الرعية إلى الاقتداء به " الألفين للعلامة الحلي ص 4 " أما الدليل النقلي فقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) البقرة 124 فدلت هذه الآية على أمرين: أن نصب الإمام من قبل الله تعالى، والثاني عصمة الإمام، لأن المذنب ظالم ولو لنفسه.
(6) دليل اللطف مفاده: أن العقل يحكم بوجوب اللطف على الله تعالى. وهو فعل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ويوجب إزاحة العلة وقطع العذر بما لا يصل إلى حد الالجاء (هوية التشيع للدكتور الوائلي).
(7) المعتزلة: طائفة من طوائف المسلمين وهم فرق متعددة أنهاها الشهرستاني في الملل والنحل إلى اثنتي عشرة فرقة وسبب تسميتهم بالمعتزلة أن واصل بن عطاء كان من أصحاب الحسن البصري فبينما هو في حلقة درسه إذ سأل الحسن البصري رجل ما تقول في صاحب الكبيرة؟
فقال الحسن: إن جماعة من المسلمين يعتبرونه مؤمنا ويقولون: لا يضر مع الإيمان سيئة، ولا تنفع مع الكفر حسنة، وجماعة آخرون يعتبرونه كافرا، فقال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمنا ولا أقول كافرا وإنما هو بمنزلة بين منزلتين. ليس بكافر ولا مؤمن، واعتزل واصل بعد هذه الواقعة مجلس الحسن، واتخذ له مجلسا خاصا جعل يقرر فيه هذا الرأي وتبعه على ذلك جماعة فقال الحسن: اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة، ولهم أصول خمسة لا يستحق برأيهم أن يوصف بالاعتزال من لم يقل بها التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين.
(8) الزيدية: هم الذين ساقوا الإمامة بعد علي والحسن والحسين عليهم السلام في أولاد فاطمة عليها السلام بأن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة فهو إمام واجب الطاعة وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة ولعل نسبتهم إلى زيد رضي الله عنه من هنا لأنه جامع لهذه الصفات لا أن زيدا يخالف الأئمة عليهم السلام في العقيدة والفقه.
(9) غ " العدد ".
(10) يعني من تقدم ذكره في المغني من الغلاة وأمثالهم.
(11) المغني 20 ق 1 / 13.
(12) أي أهل المذهب لأنهم يكفرون الغلاة وإن نسبوا إليهم وليس قول المرتضى هذا دفاعا عن الغلاة وأضرابهم ولكنه يربأ بفاضل مثل قاضي القضاة أن يكون رده بالتشنيع والسباب.
(13) ابن الراوندي أحمد بن يحيى الحسين الراوندي نسبة إلى راوند قرية تابعة لأصبهان، متكلم مشهور له من الكتب مائة وأربعة عشر كتابا منها كتاب " فضيحة المعتزلة " وكأنه أراد مناقضة كتاب معاصره الجاحظ " فضيلة المعتزلة " اتهم بالزندقة، ولعل هذا الاتهام جاءه من قبل المعتزلة لتحامله عليهم، توفي سنة 245 أو 250 " أنظر معاهد التنصيص 1 / 155. والمنتظم لابن الجوزي 6 / 59.
(14) يشرف: يطلع، والإشراف الاطلاع من فوق.
(15) أعود: أنفع، والعائدة: المنفعة والعطف.
(16) يقصد بالطبقة الثانية من يوجبون نصب الإمام على الله تعالى من باب اللطف.
وهم الإمامية ولاحظ تفنيد الشريف لقول القاضي في نسبة الغلو لهم. وفي المغني " الطريقة " بدل " الطبقة ".
(17) في المغني " إلى الأئمة ".
(18) في المغني " إلا بهم ".
(19) وفيه " ولمعرفة ما معهم وطريقتهم في ذلك ".
(20) يريد بالخصوم هنا المعتزلة.
(21) المغني ج 20 ق 1 ص 14.
(22) أنظر المغني ج 12 / 492 فما بعدها.
(23) اعتمادا منهم على ما روي (لا تجتمع أمتي على ضلالة) أنظر الملل والنحل 1 / 13 وحول هذا الحديث كلام لا يسع المجال ذكره.
(24) أي لزمك القول بعصمة الأمة وتجويز العصمة في آحادها أن تنتهي بالأمة وآحادها إلى صفة النبوة كما نسبت ذلك إلى الإمامية.
(25) لأن صاحب المغني قال " وربما قالوا ".
(26) نقل الشريف الحكاية بمعناها لا بحروف ما في المغني 20 / 14.
(27) طريفة: غريبة، والطريف: الغريب من الثمر وغيره.
(28) فحوى الكلام - مقصور وممدود: معناه.
(29) افرغوا: بذلوا، والوسع - مثلث الواو -: الطاقة.
(30) أنظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي 1 / 709.
(31) أي النبوة والإمامة.
(32) في المغني: " فلولا ".
(33) الزيادة بين المعقوفين من المغني.
(34) المغني 20 ق / 1 / 15.
(35) أي ما يتولاه من أمور الإمامة.
(36) المغني 20 ق 1 / 18.
(37) " بأنه ليس بتمكين أو أنه تمكين بتقييد " خ ل.
(38) اللهم - هنا - جملة دعائية معناها الاستثناء، تدل على أن ما بعدها قليل بالنسبة لما قبلها.
(39) المغني 20 ق 1 / 18.
(40) أي جعلهم للإمام صفات الإله.
(41) وعلى ذلك جرى معظم من كتب عن الإمامية قديما وحديثا فإن أكثر ما كتبوه عنهم أخذوه من كتب خصومهم لا من كتبهم مع أنها في متناول الجميع!.
(42) احتيج إلى الإمام فيه، خ ل.
(43) التبس الأمر: اختلط واشتبه.
(44) سقطت من المطبوعة " فيما ينقلونه ويؤدونه ".
(45) المغني 20 ق / 1 / 20.
(46) وهي التنبيه على الأدلة والنظر فيها.
(47) في الأصل: " وإن لم يجر ".
(48) في حال سماعهم وحال ما يتأكد علمهم به.
(49) وهو تعمد الخطأ.
(50) جمع الخلف - بسكون اللام - والمراد به: القرن بعد القرن.
(51) في المغني " أن كونه ".
(52) الزيادة من المغني.
(53) المغني ج 2 ق 1 / 21.
(54) في الأصل " بأنه " وأصلحناه من " المغني ".
(55) المغني 20 ق 1 / 21.
(56) المغني ق / 1 / 21.
(57) في المغني " أن يقف حكم العالم ".
(58) المغني 20 ق 1 / 21.
(59) لأن من شرائط الإمامة - عند الإمامية - نص المتقدم على المتأخر.
(60) يقال: أعراه وعراه فهو عار، والأصل فيها العرى - بضم العين - من الثياب ثم استعملت بمعنى الخلو والفراغ.
(61) ما بين القوسين خلاصة ما في المغني.
(62) في الأصل " من اعتبرناه ".
(63) أي يعم جميع الأزمنة والمكلفين. وكلمة يعم مطموسة في المغني ولذا ترك المحققون مكانها فارغا وأبدلوه بالتعليق " والظاهر عدم الحاجة إليها ".
(64) " في ذلك " ساقطة من المغني.
(65) في المغني " من الإمام ".
المغني 20 ق 1 / 25.
(66) الزيادة من المغني.
(67) قال القاضي في المغني 20 ق 1 / 23: " فإن قالوا: كذلك " - أي أن الإمامة واجبة من حيث كانت لطفا - " نقول: ولا يمتنع في اللطف أن يعم كل التكليف وكل المكلفين كما يقولونه في المعرفة بالله تعالى إلى غير ذلك، قيل لهم: لم نقل إن المعرفة لطف إلا بدليل فبينوا أن مثله في الأدلة قائم " الخ.
(68) كالحيض والنفاس للمرأة، وفقد الطهورين على قول من يقول بمعذورية فاقدهما.
(69) أي مع حضور تلك الحال كصلاة السكارى وقد نهى سبحانه عن الصلاة في تلك الحال.
(70) لطفا خبر للمبتدأ الذي هو ضمير يكون.
(71) جمع قصد: وهو إتيان الشئ.
(72) في المغني " أمر ".
(73) المغني 20 / 23 وفيه " و " بدل " أو ".
(74) في المغني " وهنا قالوا لنا إنما ".
(75) غ " في يوم دون يوم ".
(76) غ " يعرف ".
(77) المغني 20 ق 1 / 24.
(78) أي للإمام.
(79) لا يخفى أن عبارة " أعني خبر الأئمة " توضيح من الشريف حيث لا توجد في المغني.
(80) المغني 20 ق 1 / 24.
(81) في المغني " من اجتماع الكلمة على واحد " وقال المحقق: لعل كلمة (إن) سقطت من هنا فصواب العبارة " من أن اجتماع " ولو أنه رجع إلى الشافي لأغناه ذلك عن التعب بالتوجيه في مواضع كثيرة من الكتاب.
(82) المغني 20 ق 1 / 24.
(83) في المغني " إن ".
(84) في المغني " أنه " وهو خطأ لأن المراد المعرفة لا الإمام كما فسر ذلك السيد الشريف في جملته المعترضة.
(85) المغني: 20 ق 1 / 24.
(86) في المغني " وتبين ذلك " ولا يستقيم المعنى إلا أن تكون " من ذلك ".
(87) المغني 20 ق 1 / 24.
(88) جمع ضرب - بسكون الراء - وهو الصنف.
(89) أي تجعلها محالا.
(90) في المغني " أن يستغني ".
(91) المغني 20 ق 1 / 24.
(92) طريف: غريب.
(93) في مطبوعة المغني " كالملكية " ولم يعلق عليها المحقق.
(94) المغني 20 ق 1 / 25.
(95) المغني 20 ق 1 / 25.
(96) ونفدوا، خ ل: ولعله نافدوا من نافده أي استفرغ جهده في الخصومة، ومنه الحديث (إن نافذتهم نافذوك) ورويت بالقاف يقال: ناقده: أي ناقشه.
(97) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر وهم عدة فرق ولكل فرقة فروع منهم المحكمة والأزارقة والصفرية تجد تفصيل ذلك في الكامل للمبرد وشرح نهج البلاغة والملل والنحل للشهرستاني 1 / 115.
(98) الذعارة - بفتح الذال المعجمة والعين المهملة -: التخويف ولعلها تصحيف الدغارة بالدال المهملة والغين المعجمة - من الدغرة: وهي أخذ الشئ اختلاسا.
(99) اللص: فعل الشئ في تستر وخفاء، والسدات يفعلون ذلك كذلك.
(100) الارتفاع - هنا - عدم الوجود ويلاحظ أن هذه الكلمة تكررت في الكتاب.
(101) تعالم القوم الأمر: علموا به، فهو متعالم.
(102) يقال: شارف: اطلع عليه من فوق.
(103) الشتات: التفرق.
(104) الزيادة من المغني.
(105) المغني 20 ق 1 / 25.
(106) المغني 20 ق 1 / 25.
(107) غ " فإن ".
(108) المغني 20 ق 1 / 26.
(109) سامه به: كلفه به، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر.
(110) نشط للشئ " طابت نفسه له.
(111) غ " الكلم ".
(112) وفيه " عقول ".
(113) المغني 20 ق 1 / 27.
(114) في المغني " قيل لك " وعلق عليها المحقق بقوله: الأولى " لهم ".
(115) غ " المنصور " بدل " المقرر " لا يختلف المعنى.
(116) غ " أحوال " وهو غلط.
(117) " إمام واحد " فجعله فاعل " يدعى " والأرجح أن يكون تمييز المدعى.
(118) " وليس ".
(119) ما يحصل عليه بطلب وتعلم.
(120) المغني 20 ق / 281 وفيه " فبين طريقته ".
(121) انبساط اليد: انطلاقها، وهو كناية عن التمكن من التصرف في الأمور.
(122) في الأصل " ونبين بالدليل الصحيح منها ".
(123) حضه على كذا: حرضه وحثه.
(124) أردشير بن بابك من ملوك الفرس الساسانية ملك 14 أو 15 سنة استقامت له الأمور فيها، وملك البلاد وصال على الملوك، فانقادت إلى طاعته، وهو أول من رتب المراتب في الملك واقتدى به المتأخرون من الملوك والخلفاء، وحفظت عنه وصايا في الملك والسياسة، ثم تخلى عند الملك، وانقطع للعبادة وما ذكره الشريف في المتن جزء من وصيته لولده سابور عندما نصبه ملكا بعده، وتتمة ما ذكر في المتن " فالدين أس الملك. والملك حارسه، وما لم يكن له أس فمهدوم، وما لم يكن له حارس فضائع.. " أنظر مروج الذهب 1 / 248 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17 / 124.
(125) التوأم: المولود مع غيره في بطن والجمع توائم وتوام، في مروج الذهب " الدين والملك أخوان " ولم ينقص المعنى، وانظر عيون الأخبار لابن قتيبة ج 1 / 3 ومحاضرات الأدباء للراغب الإصبهاني 1 / 104.
(126) فوضى - بوزن سكرى -: أي متساوون لا رئيس لهم والسراة اسم جمع لأسرياء وسرواء وسرى، وهي جمع السري وهو من تكون له مروءة في شرف، ومراد الشاعر الرئيس.
(127) تهدى: ترشد، والحزم: ضبط الأمور.
(128) الأعمدة جمع قلة لعمود البيت. وفي الكثرة: عمد - بفتحتين - وعمد - بضمتين - وقرئ بهما قوله تعالى (في عمد ممددة) وفي رواية العقد الفريد ج 1 / 9 " إلا له عمد ".
(129) كادوا - هنا -: أرادوا، لأن كاد قد تأتي في مكان أراد، أنشد الأخفش:
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى قال بعضهم في تفسير قوله تعالى (أكاد أخفيها) أريد أخفيها، كما وضع يريد موضع يكاد في قوله سبحانه (يريد أن ينقض).
(130) الألباء - بوزن أشداء - جمع لبيب - وهو العاقل، واللب: العقل.
(131) ثبتت خ ل.
(132) في الأصل " ادعي ".
(133) المغني 20 ق 1 / 28.
(134) في الأصل " بالمقرر " وأصلحناه من المغني.
(135) غ " نبطل ".
(136) المغني 20 ق / 1 / 28.
(137) المثابرة: المواظبة على الأمر.
(138) المتعالم خ ل وكذلك في المغني.
(139) غ " دفعوا ".
(140) في الأصل " محادثة " وما أثبتناه من المغني.
(141) المغني 20 ق / 1 / 28.
(142) أي يجعله مستحيلا.
(143) الانتشار: التفرق.
(144) يخل: يفسد.
(145) غ " الاستدلال " ولا أرى له وجها.
(146) المغني 20 ق 1 / 28.
(147) غ " قرية ".
(148) المغني 20 ق 1 / 28.
(149) المغني 20 ق 1 / 28.
(150) غ " المتصور في العقل ".
(151) ما بين النجمتين ساقط من مطبوعة المغني ولذا وقع محققه في حيرة لعدم ظهور الطرف الآخر من المقارنة.
(152) في الأصل " يثبت ".
(153) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل فأعدناه من المغني.
(154) المغني 20 ق 1 / 29.
(155) في المغني " فأما قولهم: إن العقلاء يعقلون ذلك فقد يعقلون ما هو واجب ".
الخ.
(156) في المغني " يعقلون ".
(157) وفيه " وجوب سببه ".
(158) المغني 20 / 29.
(159) استفعال من الضرر.
(160) النصفة والنصف - محركتين - بمعنى واحد أي العدل، يعني ومنهم من يرى أنه إذا علم من الناس التناصف فلا حاجة للإمامة حينئذ كما يذهب إلى ذلك الأصم من المعتزلة، وفي مطبوعة المغني " ومنهم من يقول لا لما نعلمه من حال جميعهم " ولا وجه له.
(161) في المغني " إلى طريقته الأولى " ولا معنى لذلك.
(162) المغني 40 ق 1 / 29.
(163) استقصى في المسألة وتقصى: بلغ الغاية.
(164) قال الأزهري: " الضيعة عند الحاضرة النخل والكرم والأرض والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة ".
(165) غ " أمين ".
(166) المغني 20 / 30.
(167) دخلا، خ ل.
(168) أي نراه مستحيلا.
(169) في المغني " يعقلون ".
(170) في المغني " يميز " والمعنى واحد.
(171) يتسرع: يبادر.
(172) التوبيخ: التهديد والتأنيب.
(173) المغني 20 ق 1 / 31.
(174) آنفا: سالفا.
(175) المغني 20 / ق 1 / 31.
(176) الضمير في فعل يرجع إلى الله تعالى على سبيل الافتراض ولذلك قال رحمه الله بعد ذلك: " لا يجب أن يفعله بل لا يحسن ".
(177) من ص 31 ق 1 فما بعدها.
(178) أطنب فيه: بالغ في وصفه مدحا أو قدحا.
(179) تعاطى كذا: خاض فيه.
(180) المحالة: الحيلة والمراد هنا لا بد.
(181) المغني: 20 ق 1 / 35.
(182) ما بين القوسين معنى كلام القاضي لا حروفه.
(183) في الأصل " المقيئة " وأصلحناه من المغني.
(184) أخلافهم من يخلفهم، والخلف - بسكون اللام - القرن بعد القرن.
(185) المغني 20 ق 1 / 36.
(186) غ " الكعبة ".
(187) المغني 20 ق 1 / 36.
(188) نتج هذا الخلاف الشديد خ ل.
(189) غ " في الإمامة ".
(190) المغني 20 ق 1 / 37.
(191) المغني 20 ق 1 / 37.
(192) علق محقق المغني على هذه الجملة بقوله: " الأولى أن تحذف هذه الكلمة أو يضاف إليها ما تكمل به جملة " والجملة كاملة وهي أن بعضهم يرى أن الخلق وإن عظموا كثيرة يجوز عليهم كتمان ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وآله لأمر ما.
(193) الاجماع في اللغة: العزم، وفي الشرع اتفاق العلماء، في وقت من الأوقات على شئ والاجماع - عند السنة - حجة كالنص المتواتر، وهو معتبر عند الشيعة بل أحد مصادر الفقه الأربعة وهي الكتاب والسنة والعقل والاجماع، لأن الاجماع يكشف عن رضاع المعصوم باعتبار أن أقوال التابعين تدل على قول المتبوع وأن المجمعين علماء أتقياء والتقوى تمنع من القول بلا علم فاللازم أن نؤمن بأن المجمعين ما أجمعوا إلا لوجود دليل معتبر عندهم وهو حجة بالرغم من جهل المنقول إليه العلم به، وقاعدة اللطف تقتضي أن إجماع العلماء لو كان خطأ لوجب أن يظهر الله سبحانه لهم الحق ليقربهم من الطاعة ويبعدهم من المعصية إلى غير ذلك من الأقوال، ولكن بعضهم يرى أن عد الاجماع من الأدلة فيه نوع من التسامح وما هو إلا راو وحاك لحكم من الكتاب والسنة والراوي لا يجوز الأخذ بقوله إلا بعد الوثوق والاطمئنان بالصدق وعدم الخطأ ولذا نرى أن بعضهم ضرب ببعض الاجماعات عرض الجدار إذا قام عنده الدليل بما يعارضها.
(194) المغني 20 ق 1 / 37.
(195) يشير إلى ما روي " لا تجتمع أمتي على ضلالة " أنظر الملل والنحل 1 / 13.
(196) سقط ما بين النجمتين من المغني.
(197) المغني 20 ق 1 / 37.
(198) ما بين النجمتين ساقط من المغني.
(199) غ " ينجح ".
(200) غ " فيه ".
(201) الاقتراح سؤال الشئ من غير روية أو ارتجال الكلام من غير تدبر.
(202) الخبر محذوف فيكون تقدير الكلام: ولا منع معترض عليها بقادح فيها أي في الأدلة.
(203) غ " ضرورة ".
(204) المغني 20 ق 1 / 37.
(205) الجاحظ عمرو بن بحر الكناني بالولاء، لقب بالجاحظ لجحوظه عينيه - أي نتوء المقلة وكبرها - أديب كبير، وكاتب شهير، رئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، ولد في البصرة، وأقام ببغداد وتردد على سامراء، فلج في آخر عمره، ومات والكتاب على صدره، كان مشوه الخلقة حتى أن المتوكل العباسي أراده لتأديب ولده، ولكنه رجع عن ذلك لدمامته وقبح صورته، ألف في فنون من العلم وخلف آثارا تشهد له بذلك، غير أن الانحراف عن علي عليه السلام يبدو واضحا في بعض ما كتبه، ولعله فعل ذلك تقربا للمنحرفين عنه ممن رفع منزلته وكفاه مؤنته أمثال محمد بن عبد الملك الزيات، ولما فلج عاد إلى البصرة ومات بها سنة 250 أو 255 تجد ترجمته في ميزان الاعتدال 3 / 247.
وفيه: " وكان من أئمة البدع " ولسان الميزان 4 / 355 وفيه " ليس بثقة ولا مأمون وسبحان من أضله على علم) وتاريخ بغداد 12 / 212 وفيه " حضرت الصلاة ولم يصل ".
ص 217، وفيات الأعيان 3 / 140، والأعلام للزركلي 5 / 239.
(206) فأما خ ل.
(207) أبو علي: محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري شيخ المعتزلة وهو والد أبي هاشم عبد السلام المعتزلي، ونقل قاضي القضاة في (شرح المقالات) لأبي القاسم البلخي " أن أبا علي رحمه الله ما مات حتى قال بتفضيل علي عليه السلام " وأنه ألقى بذلك لولده أبي هاشم عند وفاته توفي سنة 303 (شرح نهج البلاغة 1 / 9 وشذرات الذهب 2 / 241).
(208) غ " قدح ".
(209) " فإذن يقل ".
(210) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي، ولد بالكوفة ونشأ بواسط وسكن بغداد من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ألف كتبا كثيرة اشتهر منها ستة وعشرون كتابا في الأصول والفروع والتوحيد والفلسفة العقلية والإمامة والوصية والرد على الملاحدة، والقدرية والجبرية والغلاة والخوارج والناصبة. وكان في مبدأ أمره من الجهمية ثم لقي الإمام الصادق عليه السلام فاستبصر بهديه ثم صحب الكاظم عليه السلام ففاق أصحابهما. وكان سريع البديهة حاضر الجواب وكانت له صلة بيحيى بن خالد البرمكي وكان خالد يعقد له مجلس الكلام والمناظرة في قصره. فسمعه الرشيد يوما وقد جلس يسمع مناظرته على تخف وتستر وهشام لا يعلم بموضعه فقال الرشيد لما سمعه " إن لسان هذا أضر علي من مائة ألف سيف " وبلغه ذلك فاستتر حتى مات ويقال إنه عاش إلى زمن المأمون.
(211) أبو عيسى محمد بن هارون الوراق من مناظري المعتزلة، وله تصانيف على مذهبهم توفي سنة 247 (لسان الميزان 5 / 412).
(212) أبو حفص الحداد.
(213) قال السيد شرف الدين: " رماه بالتجسيم وغيره من الطامات مريدوا إطفاء نور من مشكاته، ونحن أعرف الناس بمذهبه وفي أيدينا أحواله وأقواله فلا يجوز أن يخفى علينا وهو سلفنا ما ظهر لغيرنا من بعدهم في المشرب والمذهب (المراجعات 334).
(214) البداء - بفتح الباء - في الانسان أن يبدو له رأي في الشئ لم يكن له ذلك الرأي سابقا، بأن تبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه إذا يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية قال الصادق عليه السلام " من زعم أن الله تعالى بدا له في شئ بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم) وقال أيضا (من زعم أن الله بدا له في شئ ولم يعلمه أمس فابرأوا منه) غير أنه وردت أخبار توهم القول بصحة البداء في المعنى المتقدم كما ورد عن الصادق عليه السلام (ما بدا لله كما بدا له في إسماعيل ابني) ولذا جعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. والصحيح في ذلك أن نقول (كما قال الله تعالى (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) ومعنى ذلك أن الله تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك فيكون غير ما ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك حق العلم ولكن في علمه المخزون المصون الذي لم يطلع عليه لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي ممتحن، وهذا المقام من العلم هو المعبر عنه بأم الكتاب، كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم عليهما السلام أنه يذبحه، فهو ظهور بعد خفاء بالنسبة للمخلوق لا للخالق جلت حكمته فهو كالنسخ أو قريب من النسخ، وإن اختلف اللفظ، فلا عبرة بالألفاظ كما سيأتي في كلام السيد الشريف رحمه الله وللمزيد في ذلك يراجع أصل الشيعة وأصولها للإمام كاشف الغطاء ص 232 وعقائد الإمامية للشيخ المظفر ص 45. والبداء للعلامة السيد محمد كلنتر.
(215) الجبر لغة الإكراه والقهر وفي اصطلاح المتكلمين نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى أي العبد مجبر على فعله حسنا كان أو سيئا. خيرا أو شرا.
(216) التضرب: التطلب والتكسب ولعلها: لضرب من الشهوة والمنفعة.
(217) المغني 20 ق 1 / 38.
(218) النحلة - بكسر النون -: الدعوى، وفلان ينتحل مذهب كذا أي ينتسب إليه.
(219) قال الشهرستاني في الملل والنحل 1 / 185: " هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول، لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة، فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخصم، ودون ما يظهره من التشبيه، وذلك أنه ألزم العلاف فقال: إنك تقول الباري تعالى عالم بعلم. وعلمه ذاته فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم ويباينها في أن علمه ذاته فيكون عالما لا كالعالمين فلم لا تقول: أنه جسم لا كالأجسام وصورة لا كالصور، وله قدر لا كالأقدار " ا ه ولكن العجيب أن الشهرستاني بعد وصفه هشام بما وصفه به من المعرفة نقل عنه القول بإلهية علي عليه السلام، وهو أجل من ينسب إليه مثل هذا القول.
(220) النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري لقب بالنظام لنظمه الكلام المنثور والشعر الموزون وقيل لأنه كان ينظم الخرز بالبصرة من شيوخ المعتزلة مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين كما في لسان الميزان لابن حجر 1 / 67، وله كتاب النكث طعن فيه على جملة من كبار الصحابة بما فيهم علي عليه السلام وقد نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 6 / 139 بعض تلك المطاعن، وله مسائل خالف فيها أصحابه سنشير إليها.
(221) القرف: التهمة ويقال قرف فلان فلانا وقع فيه.
(222) نحلوه: نسبوه إليه.
(223) أي عن الإمام الصادق عليه السلام.
(224): لعله " التنكر ".
(225) أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها.
(226) تكليف ما لا يطاق فيه معركة كلامية بين المجبرة والعدلية، قالت المجبرة:
إذا أخبر الله تعالى عن شخص معين أنه لا يؤمن قط مثل أبي لهب فلو صدر منه الإيمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصادق كذبا والكذب قبيح وفعل القبيح محال على الله تعالى والمفضي إلى المحال محال فصدور الإيمان منه محال والتكليف به تكليف بالمحال وهذا هو تكليف ما لا يطاق.
وقال أهل العدل: إن العلم بعدم الإيمان لا يمنع من الإيمان، لأن العلم لا أثر له في المعلوم ولا يكلف الله تعالى بما لا يطاق (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وكيف يأمره بالإيمان وقد منعه عنه ونهاه عن الكفر وقد حمله عليه وكيف يصرفه على الإيمان وهو يقول (أنى تصرفون) إلى آخر ما جرى في ميدان هذه المعركة فمن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بالكتب الكلامية للفريقين.
(227) حفل بهذا: أي بالى به.
(228) اجتباه: اصطفاه.
(229) التزييف: التغيير بغش.
(230) أنظر سفينة البحار ج 1 ص 61 مادة " بدأ ".
(231) العثمانية من رسائل الجاحظ المعروفة حاول فيها أن يطمس حتى ما اتفق عليه الناس من مناقب علي عليه السلام بكل ما أوتي من براعة في القول وتلاعب في الألفاظ، وقد طبعت هذه الرسالة في دار الكتاب العربي بمصر بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون وألحق بها قطعا من كتاب نقض العثمانية لأبي جعفر الإسكافي المعتزلي، كما نقل طرفا من الرسالتين ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج 13 من ص 215 إلى ص 225.
(232) الجريرة: الجناية.
(233) الدهرية - بفتح الدال وتضم - القائلون ببقاء الدهر ولا يؤمنون بالحياة الأخرى قالوا وهم المشار إليهم بقوله تعالى: (ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) الجاثية 124، ويقال لهم المعطلة أيضا والتعطيل مذهب قوم من العرب بعضهم أنكر الخالق والبعث والإعادة فجعلوا الجامع لهم الطبع والمهلك لهم الدهر، وبعضهم اعترف بالخالق - جلت قدرته - وأنكر البعث (أنظر شرح نهج البلاغة 1 / 118).
(234) البراهمة قوم لا يجوزون على الله بعثة الرسل.
(235) المروق: الخروج، ومنه سميت الخوارج مارقة لقوله صلى الله عليه وآله " يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرمية ".
(236) المشيد: الباني والجاهد: المجد والضمير في له ل " كلام ".
(237) التثنية: هي القول بالاثنين الأزليين. ويقال لأصحاب هي العقيدة الثنوية.
لأنهم يزعمون: أن النور والظلمة أزليان قديمان، أنظر الملل والنحل للشهرستاني 1 / 244.
(238) محضها: خلصها عما يخالطها. وهذبها: نقاها.
(239) في الأصل " ومكفرون " ويصح على الاستئناف فتكون خبرا لمبتدأ محذوف، ولكن العطف هنا أقرب.
(240) أبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف مولى عبد القيس من شيوخ المعتزلة ومتكلميهم أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل سنة 235 في أول أيام المتوكل العباسي.
(241) أنظر مقالات الاسلاميين للأشعري 2 / 482.
(242) المداخلة: القول بأن الروح جسم لطيف مشابك للبدن، مداخل للقلب بأجزائه مداخلة الدهنية بالسمسم والسمنة في اللبن، والطفرة: أن الجسم الواحد قد يصير في المكان الثالث فون أن يمر على الثاني، وأحال أصحابه أن يصير الجسم إلى مكان دون أن يمر بما قبله.
(243) معمر بن عباد السلمي من أئمة المعتزلة توفي سنة 220.
(244) الملل والنحل 1 / 68.
(245) مقالات الاسلاميين 2 / 548.
(246) لأنه قال: " إن الله لم يخلق شيئا غير الأجسام. فأما الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام إما طبعا كالنار التي تحدث الاحراق والشمس التي تحدث الحرارة وإما اختيارا كالحيوان الذي يحدث الحركة والسكون (الملل والنحل 1 / 66).
(247) هشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة وإمام فرقة منهم تسمى الهشامية توفي سنة 226 وكان يرى أن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن إذ لا فائدة في وجودهما وهما خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما وبقيت هذه المسألة منه اعتقادا للمعتزلة وكان يجوز قتل واغتيال المخالف لمذهبه، وأخذ أموالهم لاعتقاده بكفرهم. والفوطي كما ضبطه ابن حجر في لسان الميزان 6 / 164، بضم الفاء وإسكان الواو، اه كأنه نسبه إلى بيع الفوط - كصرد - ثياب تجلب من السند أو مآزر مخططة واحدتها فوطة بالضم أو هي لغة سندية وغلط من كتبه بالغين المعجمة ظنا منه أن النسبة إلى غوطة الشام.
(248) الملل والنحل 1 / 72.
(249) يعني أبا الهذيل العلاف.
(250) نقل كل ذلك عن الجاحظ الشهرستاني في الملل والنحل 1 / 75، وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص 105 ومن فضائح الجاحظ قوله باستحالة عدم الأجسام بعد حدوثها. كما نقل ذلك القاضي أيضا في كتاب النظر والمعارف من المغني وانظر مقدمة الجزء الثاني من المغني ص / ر.
(251) هو ثمامة بن أشرس من علماء الكلام في العصر العباسي، وقد قرب الرشيد منزلته وكذلك المأمون أخذ عن بشر بن المعتمر وكان يرى - كالجاحظ - أن المعارف ضرورية يعني من لم يضطر إلى معرفة الله تعالى عن اقتناع ومعرفة فليس عليه أمر ولا نهي وينتج من هذا أن الكفار والأطفال الذين لا يستطيعون المعرفة سيكونون رأيا فلا ثواب ولا عقاب، ودافع عنه أبو الحسين الخياط في الانتصار: بأنه يرى أن الكفار عرفوا بما أمروا به وما نهوا عنه ثم قصدوا الكفر أما من لم يجد للمعرفة سبيلا فلا حجة عليه، وليس يهوديا ولا نصرانيا ولا كافرا. ويرى ثمامة أن الأفعال مثل حركة اليد ليست من فعل الانسان وإلا كان قادرا مثل الله تعالى على خلق حقائق جديدة ولا تضاف إلى الله تعالى لأن ذلك يؤدي إلى فعل القبيح. فالمتولدات أفعال لا فاعل لها وقائمة في الطباع فلا فعل للانسان إلا الإرادة، والعالم فعل الله بطباعه أنظر (الملل والنحل 1 / 89 والانتصار).
(252) المانية: نسبة إلى ماني بن بابك من حكماء الفرس كان في عصر سابور بن اردشير وقتله بهرام بن هرمز لأنه أخذ دينا بين المجوسية والنصرانية، وزعم أن العالم مصنوع من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وأنهما أزليان إلى آخر مقالته أنظر الملل والنحل للشهرستاني 1 / 70.
(253) واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغزال مولى بني ضبة أو بني مخزوم كان يلثغ بالراء لثغة قبيحة فكان يخلص كلامه ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام. وهو رأس المعتزلة وأول متكلميهم. له مصنفات وإخباره كثيرة ولد بالمدينة سنة 80 وتوفي سنة 181 (يراجع في ترجمته وفيات الأعيان 6 / 7، ولسان الميزان 6 / 214، ومرآة الجنان 1 / 274).
(254) يطم: يدفن ويغطي ومن أمثالهم: فوق كل طامة طامة.
(255) ونقل ذلك عن واصل: الشهرستاني في الملل والنحل 1 / 49.
(256) نقله الشهرستاني في الملل والنحل 1 / 49 وعمرو بن عبيد بن باب مولى بني عقيل كابلي من جبال السند متكلم مشهور، وكان أبوه يخلف أصحاب الشرط بالبصرة فكان الناس إذا رأوا عمرا مع أبيه قالوا هذا خير الناس ابن شر الناس، فكان إذا سمع ذم الناس له ومدحهم لولده يأخذه الحسد فيقول: وأي خبر يكون من ابني وقد أصبت أمه من غلول وأن أبوه كان صاحب المنصور وصديقه قبل أن يتولى الأمر فلما ولي الخلافة دخل عليه ووعظه وفيه يقول المنصور:
كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد
غير عمرو بن عبيد
توفي سنة 144، (تاريخ بغداد 12 / 166 ميزان الاعتدال 3 / 273 وفيات الأعيان 3 / 130.
(257) من عرضهم - بضم العين المهملة - من بينهم.
(258) أي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد.
(259) كتاب المقالات لأبي القاسم عبد الله بن محمود البلخي البغدادي وهو من أكابر علماء المعتزلة وقد شرح كتابه هذا قاضي القضاة أحمد بن عبد الجبار صاحب " المغني " أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 7 و 8.
(260) نقل ذلك عن الجاحظ القاضي في كتاب النظر والمعارف من المغني وأطال في رده أنظر ج 12 ص 235 و 306 فما بعدها.
(261) التحاسن: التظاهر بأن هذا الشئ حسن.
(262) أي أن المعتزلة مع ما يعلمون من آراء الجاحظ وأقواله التي لا يقدم عليها مسلم ولا يتظاهر بها يذكرونه الخ.
(263) بقولهم عند ذكره " شيخنا " وكثيرا ما رد هذه الكلمة ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة.
(264) يريد ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالشافعي وأحمد من أن لمس الذكر بلا حائل ناقض للوضوء، والحق بعضهم فرج المرأة بذلك وذهبت الإمامية إلى أنه غير ناقض ولكنهم ذهبوا إلى تجديد الوضوء استحبابا (أنظر تفصيل ذلك في نيل الأوطار 1 / وغيره من المجاميع الفقهية.
(265) أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام. على خلاف بين الوجوب والاستحباب وكونه قبلها أو بعدها أو مقارنا لها واختلفوا في مشروعية الرفع فيما عدا ذلك عند التكبير قبل الركوع والسجود وبعدهما ومذهب الإمامية المشروعية في كل ذلك (أنظر نيل الأوطار 2 / 148 فما بعدها).
(266) أي ويريدون منا الرجوع عن اعتقاد تزكيته.
(267) غ " لا يتحقق ".
(268) غ " الطرائق ".
(269) بنو نوبخت منسوبون إلى نوبخت المنجم بيت معروف من الشيعة نبغ فيهم علماء وفقهاء أشهرهم أبو سهل إسماعيل بن علي وأبو محمد الحسن بن موسى ولهم خلاف يسير في بعض المسائل الكلامية.
(270) المغني 20 / 38.
(271) وقذفهم، خ ل.
(272) في الأصل: وبإبطاله الشرائع.
من عقائد الإمامية أن الأنبياء جميعا من آدمهم إلى خاتمهم وكذلك الأئمة من أولهم إلى قائمهم معصومون من جميع الذنوب والمعاصي والرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من أول حياتهم إلى حين وفاتهم عمدا وسهوا كما يجب أن يكونوا معصومين من الخطأ والنسيان، والتنزه عما ينافي المروة ويدعو إلى الاستهجان، والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو الخطأ وينسى وصدر منه شئ من هذا القبيل فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه خطأ أو نسيانا أو لا يجب، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك. وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا، والإمام في ذلك كالنبي، لأنه الحافظ للشريعة، المبين لها، والقائم عليها، وليس في ذلك شئ من الجبر فهم معصومون مع قدرتهم من فعل المعصية، وخالف في ذلك بقية فرق المسلمين على تفصيل لا يسعه المقام. وكل ما ورد من ظاهر القرآن الكريم من منافي العصمة فمؤول، من أراد المزيد فعليه بمراجعة كتب الإمامية مثل تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى وعقائد الإمامية للمظفر.
(273) المغني 20 ق / 1 / 39.
(274) يقال: هذا أمر لا طائل فيه إذا لم يكن غنى ومزية، يقال ذلك في التذكير والتأنيث، ولا يتكلم به إلا في الجحد.
(275) غ " أن يكون لأمر ما ".
(276) المغني 20 ق 1 / 39.
(277) المغني 20 ق 1 / 39.
(278) يعني الاجماع والتواتر وفي الأصل " عليهم " وآثرنا ما في المغني.
(279) المغني 20 ق 1 / 39.
(280) أي إلى الإمام.
(281) ما بين النجمتين ساقط من المغني.
(282) المغني 20 ق 1 / 39.
(283) والطريف الظريف أن هذه العبارة وردت في مطبوعة المغني هكذا: " فقد علمنا مع ثبات الإمام عبده - وقال المحقق: لعلها " عندهم " - أن الخلاف قائم فوجوده تقدمة في هذا الباب "!!
(284) غ " بتبيانه ".
(285) المغني 20 ق 1 / 40.
فصل في تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة
- الزيارات: 2544