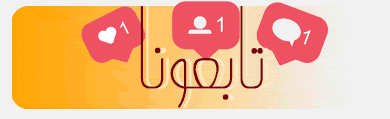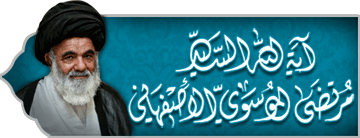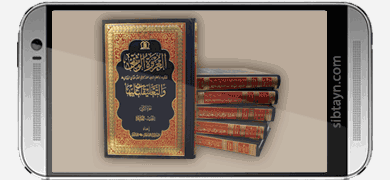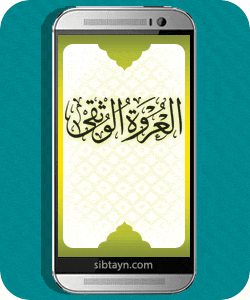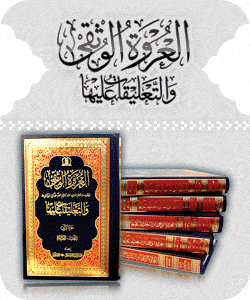خطة الإمام (عليه السلام)
إنحراف الحكام:
إن أدنى مراجعة لتاريخ الحكام آنذاك ـ العباسيين والأمويين على حد سواء ـ لكفيلة بأن تظهر بجلاء مدى منافاة تصرفات أولئك الحكام، وسلوكهم، وحياتهم لمبادئ الإسلام وتعاليمه.. الإسلام، الذي كانوا يستطيلون على الناس به، ويحكمون الأمة ـ حسب ما يدعون ـ باسمه، وفي ظله. حتى لقد أصبح الناس، والناس على دين ملوكهم، يتأثرون بذلك، ويفهمون خطأ: أن الإسلام لا يبتعد كثيراً عما يرون، ويشاهدون، مما كان من نتائجه شيوع الانحراف عن الخط الإسلامي القويم. بنحو واسع النطاق، ليس من السهل بعد السيطرة عليه، أو الوقوف في وجهه.
العلماء المزيفون وعقيدة الجبر:
ولقد ساعد على ذلك، وزاد الطين بلة، فريق من أولئك الذين اشتريت ضمائرهم، ممن يتسمون، أو بالأحرى سماهم الحكام ب «العلماء» حيث إنهم قاموا يتلاعبون بمفاهيم الإسلام، وتعاليمه، لتوافق هوى، وتخدم مصالح أولئك الحكام المنحرفين، الذين أغدقوا عليهم المال، وغمروهم بالنعمة.
حتى إن أولئك المأجورين قد جعلوا عقيدة الجبر ـ الواضح لكل أحد زيفها وسخفها ـ من العقائد الدينية الإسلامية!.، من أجل أن يسهلوا على أولئك الحكام استغلال الناس، ولكي يوفروا لهم حماية لتصرفاتهم تلك. التي يندى لها جبين الإنسان الحر ألماً وخجلاً، إذ أنهم يكونون بذلك قد جعلوا كل ما يصدر منهم هو بقضاء من الله وقدره، ولذا فليس لأحد الحق في أن ينكر عليهم أي تصرف من تصرفاتهم، أو أي جناية من جناياتهم.
وكان قد مضى على ترويجهم هذه العقيدة المبتدعة ـ حتى زمان المأمون ـ أكثر من قرن ونصفاً، أي من أول خلافة معاوية، بل وحتى قبل ذلك أيضاً. بزمان طويل!
عقيدة الخروج على سلاطين الجور:
كما أنهم ـ أعني هؤلاء العلماء ـ قد جعلوا الخروج على سلاطين الجور والفساد موبقة من الموبقات، وعظيمة من العظائم..
وقد جرحوا بذلك عدد من كبار العلماء: مثل الإمام أبي حنيفة وغيره، بحجة أنه: «يرى السيف في أمة محمد»(30).
بل لقد جعلوا عدم جواز الخروج هذا من جملة العقائد الدينية، كما يظهر من تتبع كلماتهم(31).
وأما عقائد التشبيه، وقضية خلق القرآن، فلعلها أشهر من أن تذكر، أو تحتاج إلى بيان.
والذي زاد الطين بلة:
يضاف إلى ذلك كله غرور الحكام، الذي لا مبرر له، وكذلك من لف لفهم، الذين كانوا يحكمون الأمة باسم الدين.
وكذلك غفلة الناس، وعدم إدراكهم لحقيقة ما يجري وما يحدث، وللواقع المزري، الذي كان قائماً آنذاك.
وأيضاً.. وهو الأهم من كل ذلك ـ ابتعادهم، بسعي من الهيئات الحاكمة، عن أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة.
كل ذلك.. قد أدى بالفعل إلى انحلال الدولة داخليا، وتمزيق أوصالها.. كما وأنه قد أسهم إسهام كبيراً في إبعاد الناس عن تعاليم السماء، وشريعة الله.. الأمر الذي لم يكن يعني إلا نهاية الحكم الإسلامي، وردة الناس إلى الجاهلية الجهلاء.. الأمر الذي لم يكن يرهب الحكام كثيراً، لأن الإسلام الذي يريدون، والدين الذي ينشدون، هو ذلك الذي يستطيعون أن يتسلطوا على الأمة، ويستأثروا بقدراتها وإمكاناتها في ظله. ويمهد لهم السبيل لاستمرارهم في فرض نفوذهم وسيطرتهم، ولو كان ذلك على حساب جميع الشرائع السماوية، وكل المفاهيم الإنسانية.
إن أولئك الحكام. ما كانوا يفكرون إلا في وسائل بقائهم واستمرارهم في الحكم، وإلا في شؤونهم ومصالحهم الخاصة بهم. أما الأمة المسلمة، وأما الإسلام، فلم يكن لهما لديهم أية قيمة، أو شأن يذكر، إلا في حدود ما يستطيعون الإفادة منهما في بقائهم ووجودهم في الحكم والسلطة.
الأئمة في مواجهة مسؤولياتهم:
وفي هذا الوسط الغريب: من غفلة الناس، ومن سيرة الحكام، والمتسمين بالعلماء وسلوكهم.. كان الأئمة (عليهم السلام) يؤدون واجبهم في نشر تعاليم السماء، ويكافحون، وينافحون عنها، بقدر ما كانت تسمح لهم ظروفهم، التي كانت في ظل سلطان أولئك المنحرفين قاسية إلى حد بعيد. وأما عن الإمام الرضا بالذات:
وقد سنحت للإمام الرضا (عليه السلام) فرصة لفترة وجيزة، كان الحكام منشغلين فيها بأمور تهمهم.. للقيام بواجبه في توعية الأمة، وتعريفها بتعاليم الإسلام. وذلك في الفترة التي تلت وفاة الرشيد، وحتى قتل الأمين. بل نستطيع أن نقول: إنها امتدت ـ ولو بشكل محدود ـ حتى وفاة الإمام (عليه السلام) في سنة «203». الأمر الذي كان من نتيجته ازدياد نفوذه (عليه السلام)، واتساع قاعدته الشعبية، حتى لقد كانت كتبه تنفذ في المشرق والمغرب، وكان هو الأرضى في الخاصة والعامة، حسبما ألمحنا إليه من قبل.
الخطة الحكيمة:
وعندما أراد المأمون أن ينفذ خطته في البيعة له بولاية العهد، وعرف الرضا: أن لا مناص له من قبول ذلك، كان من الطبيعي أن يعد (عليه السلام) العدة، ويضع خطة لمواجهة خطط المأمون، وإحباط أهدافه الشريرة، والتي كان أهونها القضاء على سمعة الإمام (عليه السلام)، وتحطيمه معنوياً واجتماعياً.
ولقد كانت حطة الإمام هذه في منتهى الدقة والإحكام، وقد نجحت أيما نجاح في إفشال المؤامرة وتضييع كثير من أهدافها، وجعل الأمور في صالح الإمام (عليه السلام)، وفي ضرر المأمون.. حتى لقد ضاع رشد المأمون [بل ورشد أشياعه أيضاً]، وهو أفعى الدهاء والسياسة، ولم يعد يدري ما يصنع، ولا كيف يتصرف..
مواقف لم يكن يتوقعها المأمون:
ولعلنا نستطيع أن نسجل هنا بعض المواقف للإمام (عليه السلام)، التي لم يكن المأمون قد حسب لها حسابا، والتي كانت ضمن خطة الإمام (عليه السلام) في مواجهة مؤامرات المأمون..
الموقف الأول:
إننا نلاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد رفض دعوة المأمون، وهو في المدينة ولم يقبل إلا بعد أن علم أنه لا يكف عنه.. بل إن بعض النصوص تشير إلى أنه قد حمل إلى مرو بالرغم عنه، لا باختياره..
وما ذلك إلا ليعلم المأمون: أن حيلته لم تكن لتجوز عليه، وأنه (عليه السلام) على علم تام بأبعاد مؤامرته وأهدافها.. كما أنه بذلك يثير شكوك الناس وظنونهم حول طبيعة هذا الحدث، وسلامة النوايا فيه.
الموقف الثاني:
إنه رغم أن المأمون كان قد طلب من الإمام (عليه السلام) ـ وهو في المدينة ـ أن يصطحب معه من أحب من أهل بيته في سفره إلى مرو.
إنه رغم ذلك.. نلاحظ: أنه (عليه السلام) لم يصطحب معه حتى ولده الوحيد الإمام الجواد (عليه السلام)، مع علمه بطول المدة، التي سوف يقضيها في هذا السفر، الذي سوف يتقلد فيه زعامة الأمة الإسلامية، حسب ما يقوله المأمون.. بل مع علمه بأنه سوف لن يعود من سفره ذاك، كما تؤكد عليه كثير من النصوص التاريخية.
شكوك لها مبرراتها:
ونرى أننا مضطرون للشك في نوايا المأمون وأهدافه من وراء طلبه هذا «أن يصطحب الإمام (عليه السلام) من شاء من أهل بيته إلى مرو».
بعد أن رأينا: أنه لم يرجع أحد ممن ذهب مع محمد بن جعفر إلى مرو، ولا رجع محمد بن جعفر نفسه، ولا رجع محمد بن محمد بن زيد، ولا غير هؤلاء، كما سيأتي بيانه في الفصل التالي وغيره..
فلعل الإمام (عليه السلام) بل إن ذلك هو المؤكد، الذي تدل عليه تصريحاته وتصرفاته حيث تأهب للسفر ـ لعله ـ قد ظن لنوايا المأمون هذه، فضيع الفرصة عليه، وأعاد كيده إليه..
الموقف الثالث:
سلوكه في الطريق، كما وصفه رجاء بن أبي الضحاك(32)، حتى اضطر المأمون لأن يظهر على حقيقته، ويطلب من رجاء هذا: أن لا يذكر ما شاهده منه لأحد، بحجة أنه لا يريد أن يظهر فضله إلا على لسانه(33)، ولكننا لم نره يظهر فضله هذا، حتى ولو مرة واحدة، فلم يدع أحد أنه سمع شيئاً من المأمون عن سلوك الإمام (عليه السلام)، وهو في طريقه إلى مرو. وأما رجاء، فلعله لم يحدث بذلك إلا بعد أن لم يعد في ذلك ضرر على المأمون، وبعد أن ارتفعت الموانع، وقضي الأمر.
الموقف الرابع:
موقفه في نيشابور، الذي لم يكن أبداً من المصادفة. كما لم يكن ذكره للسلسلة التي يروي عنها من المصادفة أيضاً، حيث أبلغ الناس في ذلك الموقف، الذي كانت تزدحم فيه أقدام عشرات بل مئات الألوف(34) ـ أبلغهم ـ: «كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي»(35).
هذه الكلمة.. التي عد أهل المحابر والدوي، الذين كانوا يكتبونها، فأنافوا على العشرين ألفاً.. هذا على قلة من كانوا يعرفون القراءة والكتابة آنذاك، وعدا عمن سواهم ممن شهد ذلك الموقف العظيم..
«.. ونلاحظ: أنه (عليه السلام) ـ في هذا الظرف ـ لم يحدثهم عن مسألة فرعية، ترتبط ببعض مجالات الحياة: كالصوم، والصلاة، وما شاكل. ولم يلق عليهم موعظة تزهدهم في الدنيا، وترغبهم في الآخرة، كما كان شأن العلماء آنذاك.
كما أنه لم يحاول أن يستغل الموقف لأهداف شخصية، أو سياسية، كما جرت عادة الآخرين في مثل هذه المواقف.. مع أنه يتوجه إلى مرو، ليواجه أخطر محنة تحدد وجوده، وتهدد العلويين، ومن ثم الأمة بأسرها.
وإنما كلم الناس باعتباره القائد الحقيقي، الذي يفترض فيه: أن يوجه الناس ـ في ذلك الظرف بالذات ـ إلى أهم مسألة ترتبط بحياتهم، ووجودهم، إن حاضراً، وإن مستقبلاً، ألا وهي مسألة: التوحيد..
التوحيد: الذي هو في الواقع الأساس للحياة الفضلى، بمختلف جوانبها، وإليه تنتهي، وعلى وبه تقوم..
التوحيد: الذي ينجي كل الأمم من كل عناء وشقاء وبلاء. والذي إذا فقده الإنسان، فإنه يفقد كل شيء في الحياة حتى نفسه..
مدى ارتباط مسألة الولاية بمسألة التوحيد:
هذا.. ولأنه قد يكون الكثيرون ممن شهدوا ذلك الموقف لم يتهيأ لهم سماع كلمة الإمام (عليه السلام)، لانشغالهم مع بعضهم بأحاديث خاصة، أو لتوجههم لأمور جانبية أخرى، كما يحدث ذلك كثيراً في مناسبات كهذه..
نرى الإمام (عليه السلام) يتصرف بنحو آخر، حيث إنه عندما سارت به الناقة، وفي حين كانت أنظار الناس كلهم. وقلوبهم مشدودة إليها.. نراه يخرج رأسه من العمارية، فيسترعي ذلك انتباه الناس، الذين لم يكونوا يترقبون ذلك منه. ثم يملي عليهم ـ وهم يلتقطون أنفاسهم، ليستمعوا إلى ما يقول ـ كلمته الخالدة الأخرى: «بشروطها، وأنا من شروطها».
لقد أملى الإمام (عليه السلام) كلمته هذه عليهم، وهو مفارق لهم، لتبقى الذكرى الغالية، التي لا بد وأن يبقى لها عميق الأثر في نفوسهم(36).
لقد أبلغهم (عليه السلام) مسألة أساسية أخرى، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوحيد، ألا وهي مسألة: «الولاية».
وهي مسألة بالغة الأهمية، بالنسبة لأمة تريد أن تحيا الحياة الفضلى، وتنعم بالعيش الكريم، إذ ما دامت مسألة القيادة الحكيمة. والعادلة، والواعية لكل ظروف الحياة. وشؤونها، ومشاكلها ـ ما دامت هذه المسألة ـ لم تحل، فلسوف لا يمكن إلا أن يبقى العالم يرزح تحت حكم الظلمة والطواغيت، والذين يجعلون لأنفسهم صلاحيات التقنين والتشريع الخاصة بالله، ويحكمون بغير ما أنزل الله، وليبقى العالم ـ من ثم ـ يعني الشقاء والبلاء، ويعيش في متاهات الجهل، والحيرة، والضياع..(37).
وإننا إذا ما أدركنا بعمق مدى ارتباط مسألة: «الولاية» بمسألة «التوحيد» فلسوف نعرف: أن قوله (عليه السلام): «وأنا من شروطها» لم تمله عليه مصلحته الخاصة، ولا قضاياه الشخصية..
ولسوف ندرك أيضاً: الهدف الذي من أجله ذكر الإمام (عليه السلام) سلسلة سند الرواية، الأمر الذي ما عهدناه، ولا ألفناه منهم (عليهم السلام). إلا في حالات نادرة، فإنه (عليه السلام) قد أراد أن ينبه بذلك على مدى ارتباط مسألة القيادة للأمة بالمبدأ الأعلى..
الإمام ولي الأمر من قبل الله، لا من قبل المأمون:
وعدا عن ذلك كله.. فإننا نجد أن الإمام (عليه السلام)، حتى في هذا الموقف، قد اهتبل الفرصة، وأبلغ ذلك الحشد الذي يضم عشرات بل مئات الألوف: أنه الإمام للمسلمين جميعاً، والمفترض الطاعة عليهم، على حد تعبير القندوزي الحنفي، وغيره.. وذلك عندما قال لهم: «وأنا من شروطها».
وبذلك يكون قد ضيع على المأمون أعظم هدف كان يرمي إليه من استقدام الإمام (عليه السلام) إلى مرو. ألا وهو: الحصول على اعتراف بشرعية خلافته، وخلافة بني أبيه العباسيين.
إذ أنه قد بين للملأ بقوله: «وأنا من شروطها»: أنه هو بنفسه من شروط كلمة التوحيد، لا من جهة أنه ولي الأمر من قبل المأمون، أو سيكون ولي الأمر أو العهد من قبله، وإنما لأن الله تعالى جعله من شروطها.
وقد أكد (عليه السلام) على هذا المعنى كثيراً، وفي مناسبات مختلفة، حتى للمأمون نفسه في وثيقة العهد كما سيأتي، وأيضاً في الكتاب الجامع لأصول الإسلام والأحكام، الذي طلبه منه المأمون، حيث كتب فيه أسماء الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، مع أن عدداً منهم لم يكونوا قد ولدوا بعد، كما أنه ذكر أسماءهم في احتجاجه على العلماء والمأمون في بعض مجالسهم العلمية، وفي غير ذلك من مواقفه الكثيرة (عليه السلام).
الإمام يبلغ عقيدته لجميع الفئات:
وأخيراً.. لا بد لنا في نهاية حديثنا عن هذا الموقف التاريخي من الإشارة إلى أنه كان من الطبيعي أن يضم ذلك الحشد العظيم، الذي يقدر بعشرات. بل بمئات الألوف:
1 ـ حشداً من أهل الحديث واتباعهم، الذين جعلوا صلحاً جديداً بين الخلفاء الثلاثة، وبين علي (عليه السلام) في معتقداتهم، بشرط أن يكون هو الرابع في الخلافة والفضل. ولفقوا من الأحاديث في ذلك ما شاءت لهم قرائحهم، حتى جعلوه إذا سمع ذكراً لأبي بكر يبكي حباً، ويمسح عينيه ببرده(38).
وجعلوه أيضاً ضراباً للحدود بين يدي الثلاثة: أبي بكر، وعمر، وعثمان(39)، كما تنبأ هو نفسه (عليه السلام) بذلك(40). إلى غير ذلك مما لا يكاد يخفى على الناظر البصير، والناقد الخبير..
2 ـ وحشداً من أهل الإرجاء، الذين ما كانوا يقيمون وزناً لعلي، وعثمان. بل كانت المرجئة الأولى لا يشهدون لهما بإيمان، ولا بكفر..
3 ـ وأيضاً.. أن يضم حشداً من أهل الاعتزال، الذين أحاطوا بالمأمون، بل ويعد هو منهم، والذين تدرجوا في القول بفضل علي (عليه السلام) حسبما اقتضته مذاهبهم ومشاربهم، فقد كان مؤسسا نحلة الاعتزال: واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، لا يحكمان بتصويبه في وقعة الجمل مثلاً، ولكن أتباعهما تدرجوا على مر الزمان في القول بفضله، فقد شكك أبو الهذيل العلاف في أفضليته على أبي بكر، أو القول بتساويهما في الفضل.
ولكن رئيس معتزلة بغداد: بشر بن المعتمر، قد جزم بأفضليته على الخلفاء الثلاثة، ولكنه قال بصحة خلافتهم.. وقد تبعه جميع معتزلة بغداد، وكثير من البصريين.
وإذا كان ذلك الحشد الهائل يضم كل هؤلاء. وغيرهم ممن لم نذكرهم.. فمن الطبيعي أن تكون كلمة الإمام هذه: «وأنا من شروطها» ضربة موفقة ودامغة لكل هؤلاء، وإقامة للحجة عليهم جميعا. على اختلاف أهوائهم، ومذاهبهم..
ويكون قد بلغ بهذه الكلمة: «وأنا..» صريح عقيدته، وعقيدة آبائه الطاهرين (عليهم السلام) في أعظم مسألة دينية، تفرقت لأجلها الفرق في الإسلام، وسلت من أجلها السيوف.
بل لقد قال الشهرستاني: «.. وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل زمان.»(41).
وبعد كل ما قدمناه.. لا يبقى مجال للقول: إن قوله هذا: «وأنا..» لا ينسجم مع ما عرف عنه (عليه السلام) من التواضع البالغ، وخفض الجناح، إذ ليس ثمة من شك في أن للتواضع وخفض الجناح موضع آخر. وأنه كان لا بد للإمام في ذلك المقام، من بيان الحق الذي يصلح به الناس أولاً وآخراً، ويفتح عيونهم وقلوبهم على كل ما فيه الخير والمصلحة لهم، إن حاضرا، وإن مستقبلا، وإن جزع من ذلك قوم. وحنق آخرون.
تعقيب هام وضروري:
ومما هو جدير بالملاحظة هنا، هو أن أئمة الهدى (عليهم السلام) كانوا يستعملون التقية في كل شيء إلا في مسألة أنهم (عليهم السلام) الأحق بقيادة الأمة، وخلافة النبي (صلى الله عليه وآله). مع أنها لا شيء أخطر منها عليهم. كما تشير إليه عبارة الشهرستاني الآنفة، وغيرها.
وذلك يدل على مدى ثقتهم بأنفسهم، وبأحقيتهم بهذا الأمر.
فنرى الإمام موسى (عليه السلام) يواجه ذلك الطاغية الجبار هارون بهذه الحقيقة، ويصارحه بها، أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة(42). بل لقد رأينا الرشيد نفسه يعترف بأحقيتهم تلك في عدد من المناسبات على ما في كتب السير والتاريخ.
ولقد نقل غير واحد(43) أنه: عندما وقف الرشيد على قبر النبي (صلى الله عليه وآله)، وقال مفتخرا: السلام عليك يا ابن عم. جاء الإمام موسى (عليه السلام)، وقال: السلام عليك يا أبة. فلم يزل ذلك في نفس الرشيد إلى أن قبض عليه: وعندما قال له الرشيد: أنت الذي تبايعك الناس سراً؟!
أجابه الإمام (عليه السلام): أنا إمام القلوب، وأنت إمام الجسوم(44). وأما الحسن، والحسين، وأبوهما، فحالهما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى بيان.
بل إن أعظم شاهد على مدى ثقتهم بأحقية دعواهم الإمامة ما قاله الإمام الرضا (عليه السلام) للقائل له: إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر، وجلست مجلس أبيك، وسيف هارون يقطر الدم؟!.
فأجابه الإمام (عليه السلام): «جرأني على هذا ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة، فأشهد أني لست بنبي.. وأنا أقول لكم: إن أخذ هارون من رأسي شعرة، فاشهدوا أني لست بإمام.»(45).
وفي هذا المعنى روايات عديدة(46).
ولكنهم (عليهم السلام) قد انصرفوا بعد الحسين (عليه السلام) عن طلب هذا الأمر بالسيف. إلى تربية الأمة، وحماية الشريعة من الانحرافات التي كانت تتعرض لها باستمرار، ولأنهم كانوا يعلمون: أن طلب هذا الأمر من دون أن يكون له قاعدة شعبية قوية وثابتة، وواعية، لن يؤدي إلى نتيجة، ولن يقدر له النجاح، الذي يريدونه هم، ويريده الله. ولكنهم ـ كما قلنا ـ ظلوا (عليهم السلام) يجاهرون بأحقيتهم بهذا الأمر، حتى مع خلفاء وقتهم، كما يظهر لكل من راجع مواقفهم وأقوالهم في المناسبات المختلفة.
الموقف الخامس:
رفضه الشديد لكلا عرضي المأمون: الخلافة، وولاية العهد، وإصراره على هذا الرفض الذي استمر أشهراً، وهو في مرو نفسها، حتى لقد هدده المأمون أكثر من مرة بالقتل.
وبذلك يكون قد مهد الطريق ليواجه المأمون بالحقيقة، حيث قال له: إنه يريد أن يقول للناس: إن علي بن موسى لم يزهد بالدنيا، وإنما الدنيا هي التي زهدت فيه، وليكون بذلك قد أفهم المأمون أن حيلته لم تكن لتجوز، وأن زيفه لا ينطلي عليه، وأن عليه أن يكف في المستقبل عن كل مؤامراته ومخططاته. وليكون المأمون بعد هذا غير مطمئن لأي عمل يقدم عليه، وضعيف الثقة بكل الحيل والمؤامرات التي يحوكها. هذا بالإضافة إلى أن الناس سوف يشكون في طبيعية هذا الأمر، وسلامة نوايا المأمون فيه.
الموقف السادس:
ولم يكتف الإمام (عليه السلام) بذلك كله.. بل كان لا يدع فرصة تمر إلا يؤكد فيها على أن المأمون قد أكرهه على هذا الأمر، وأجبره عليه، وهدده بالقتل إن لم يقبل.
يضاف إلى ذلك.. أنه كان يخبر الناس في مختلف المناسبات: أن المأمون سوف ينكث العهد، ويغدر به.. حتى لقد قال في نفس مجلس البيعة للمستبشر: «لا تستبشر، فإنه شيء لا يتم» بل لقد كتب في نفس وثيقة العهد ما يدل على ذلك دلالة واضحة، كما سيأتي بيانه في الموقف الثامن.
هذا عدا عن أنه كان يصرح بأنه لا يقتله إلا المأمون، ولا يسمه إلا هو، حتى لقد واجه نفس المأمون بهذا الأمر.
بل إنه لم يكن يكتفي بمجرد القول، وإنما كانت حالته على وجه العموم في فترة ولاية العهد تشير إلى عدم رضاه بهذا الأمر، وإلى أنه مكره مجبر عليه.
حيث إنه كان على حد تعبير الرواة: «في ضيق شديد، ومحنة عظيمة» و «لم يزل مغموماً مكروباً حتى قبض»، و «قبل البيعة، وهو باك حزين» وكان كما يقول المدائني: «إذا رجع يوم الجمعة من الجامع، وقد أصابه العرق والغبار، رفع يديه وقال: «اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت، فعجل لي الساعة»(47).
إلى آخر ما هنالك، مما لا يمكن استقصاؤه في مثل هذه العجالة..
وواضح: أن كل ذلك سوف يؤدي إلى عكس النتيجة، التي كان يتوخاها المأمون من البيعة، وخصوصاً إذا ما أردنا الملائمة بين مواقفه هذه، وموقفه في نيشابور، وموقفه صلاتي العيد في مرو.
الموقف السابع:
إنه كان لا يدع فرصة تمر إلا ويؤكد فيها على أن المأمون لم يجعل له إلا ما هو حق له، وأنه لم يزد بذلك على أن أرجع الحق إلى أهله، بعد أن كانوا قد اغتصبوه منهم، بل وإثبات أن خلافة المأمون ليست صحيحة ولا هي شرعية.
أما ما يتعلق به بصحة خلافة المأمون:
فنلاحظ: أنه (عليه السلام) حتى في كيفية البيعة يشير ـ على ما صرح به كثير من المؤرخين ـ إلى أن المأمون، الذي يحتل عنوة مجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يجهل حتى كيفية ذلك العقد الذي خوله ـ بنظره ـ أن يكون في ذلك المجلس الخطير، حيث إنه (عليه السلام): «.. رفع يده، فتلقى بظهرها وجه نفسه، وبطنها وجوههم، فقال له المأمون: إبسط يدك للبيعة، فقال له: إن رسول الله هكذا كان يبايع، فبايعته الناس.»(48).
ونظير ذلك أيضاً: ما روي من أن المأمون قد أمر الناس: أن يعودوا للبيعة من جديد، عندما أعلمه الإمام (عليه السلام): بأن كل من كان قد بايعه، قد بايعه بفسخ البيعة إلا الشاب الأخير.. وهاج الناس بسبب ذلك. وعابوا المأمون على عدم معرفته بالعقد الصحيح والكيفية الصحيحة للبيعة وهذه القضية مذكورة في العديد من المصادر أيضاً(49).
وأما أن الخلافة حق للإمام (عليه السلام) دون غيره:
فلعله لا يكاد يخفى على من له أدنى اطلاع على حياة الإمام (عليه السلام) ومواقفه وقد تحدثنا آنفاً عن موقفه في نيشابور، وهو في طريقه إلى مرو، وكيف أنه (عليه السلام) جعل نفسه الشريفة والاعتراف بإمامته شرطا لكلمة التوحيد، والدخول في حصن الله الحصين..
وأشرنا أيضاً: إلى أنه قد عدد الأئمة الشرعيين، وهو أحدهم في عديد من المناسبات والمواقف حتى فيما كتبه للمأمون. بل لقد المح إلى ذلك أيضاً بل لقد ذكره صراحة فيما كتبه على حاشية وثيقة العهد بخط يده.
كما أن من الأمور الجديرة بالملاحظة هنا خطاب الإمام (عليه السلام) حينما بويع له بولاية العهد، وهو ما يلي:
«.. إن لنا عليكم حقاً برسول الله، ولكم علينا حق به، فإذا أنتم أديتم لنا ذلك وجب علينا الحق لكم..».
ولم يؤثر عنه في ذلك المجلس غير ذلك.. وهو معروف ومشهور بين أرباب السير والتاريخ..
ومن الواضح:أن اقتصاره على هذه الكلمة في ذلك المجلس الذي يقتضي إيراد خطبة طويلة، يتعرض فيها لمختلف المواضيع، وعلى الأقل لشكر المأمون على ما خصه به من ولاية العهد بعده ـ إن اقتصاره على هذا ـ يعتبر أسلوباً رائعاً لتركيز المفهوم الذي يريده الإمام (عليه السلام) في أذهان الناس، وإعطائهم الانطباع الحقيقي عن البيعة، وعن موقفه منها، ومن جهاز الحكم، في نفس مجلس البيعة، حتى لا يبقى هناك مجال للتكهن بأن: الإمام كان يرغب في هذا الأمر، ثم حدث ما أوجب غضبه وسخطه. وقد يكون له الحق في ذلك وقد لا يكون.
يضاف إلى كل ذلك:أنه (عليه السلام) قال لحميد بن مهران، حاجب المأمون: «.. وأما ذكرك صاحبك [يعني المأمون، والمأمون جالس]، الذي أجلني، فما أحلَّني إلا المحل الذي أحلَّه ملك مصر ليوسف الصديق (عليه السلام)، وكانت حالهما ما قد علمت.».
كما أنه (عليه السلام) قد قال أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة: «إن من أخذ برسول الله، لحقيق بأن يعطي به»، وذلك عندما عرض له المأمون بالمن عليه بأن جعله ولي عهده، وفي غير هذه المناسبة أيضاً.
المأمون يعترف بأحقية آل علي بالأمر:
ولعل من أعظم المواقف الجديرة بالتسجيل هنا موقفة (عليه السلام) مع المأمون، عندما حاول هذا أن يحصل منه (عليه السلام) على اعتراف بأن العباسيين والعلويين سواء بالنسبة لقرباهم من النبي (صلى الله عليه وآله)، وذلك من أجل أن يثبت ـ بزعمه ـ أن له ولبني أبيه حقاً في الخلافة.
فكانت النتيجة: أن نجح الإمام (عليه السلام) في انتزاع اعتراف من المأمون بأن العلويين هم الأقرب.. وتكون النتيجة ـ على حسب منطق المأمون، ومنطق أسلافه كما قدمنا ـ هي: أن العلويين هم الأحق بالخلافة والرياسة، وأنه هو، وآباءه غاصبون، ومعتدون..
فبينما المأمون والرضا (عليه السلام) يسيران، إذ قال المأمون:
«.. يا أبا الحسن، إني فكرت في شيء، فنتج لي الفكر الصواب فيه: فكرت في أمرنا وأمركم، ونسبنا ونسبكم، فوجدت الفضيلة فيه واحدة، ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولا على الهوى والعصبية.
فقال له أبو الحسن الرضا (عليه السلام): إن لهذا الكلام جوابا، إن شئت ذكرته لك، وإن شئت أمسكت..
فقال له المأمون: إني لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه..
قال له الرضا (عليه السلام): أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لو أن الله تعالى بعث نبيه محمداً (صلى الله عليه وآله)، فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام، يخطب إليك ابنتك، كنت مزوجه إياها؟.
فقال: يا سبحان الله، وهل أحد يرغب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟!.
فقال له الرضا (عليه السلام)، أفتراه كان يحل له أن يخطب إلي؟.
قال: فسكت المأمون هنيئة، ثم قال: «أنتم والله، أمس برسول الله رحماً»(50).
وكانت هذه ضربة قاضية وقاصمة للمأمون. لم يكن قد حسب لها أي حساب. ولم يكن ليتمكن في مقابل ذلك من أي عمل ضد الإمام (عليه السلام)، بعد أن كان هو الجاني على نفسه، ف «على نفسها جنت براقش».
وبعد كل ذلك فقد قدمنا قول ابن المعتز:
وأعطاكم المأمون حق خلافة لنا حقها، لكنه جاد بالدنيا
وخلاصة الأمر:
إنه (عليه السلام) لم يكن يدخر وسعا في إحباط مسعى المأمون، وتضييع الفرصة عليه، وإفهام الناس أنه مكره على هذا الأمر، مجبر عليه. والتأكيد على أن المأمون لم يجعل له إلا ما هو حق له، ولذا فلا يمكن أن يعتبر قبوله بولاية العهد اعترافا بشرعية الخلافة العباسية، أو بشرعية أي تصرف من تصرفاتها. كما أنه إذا كان ذلك حقاً للإمام اغتصبه الغاصبون، واعتدى عليه فيه المعتدون، فليس المأمون حق في أن يعرض له (عليه السلام) بالمن عليه، بما جعل له من ولاية العهد.
وكذلك ليس للمأمون بعد: أن يدعي العدل والإنصاف، فضلاً عن الإيثار والتضحية في سبيل الآخرين، بعد أن فضح الإمام أهدافه من لعبته تلك، وعرف كل أحد أنها لم تكن شريفة ولا سليمة.
الأكذوبة المفضوحة:
وبعد.. فقد ذكر بعض أهل الأهواء، كابن قتيبة، وابن عبد ربه، واقعة خيالية، غير تلك التي ذكرناها آنفاً وهي:
أن المأمون قال لعلي بن موسى: علام تدعون هذا الأمر؟!.
قال: «بقرابة علي وفاطمة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)..».
فقال المأمون: «إن لم تكن إلا القرابة، فقد خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هو أقرب إليه من علي، أو من هو في قعدده. وإن ذهبت إلى قرابة فاطمة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن الأمر بعدها للحسن، والحسين، فقد ابتزهما علي حقهما، وهما حيان، صحيحان، فاستولى على ما لا حق له فيه». فلم يحر علي بن موسى له جواباً(51).. انتهى.
وهي واقعة مزيفة ومجعولة من أجل التغطية على الواقعة الحقيقية، التي جرت بينهما، والتي تنسجم مع كل الأحداث والوقائع، وجميع الدلائل والشواهد متظافرة على صحتها، ألا وهي تلك التي قدمناها آنفاً..
والدليل على زيف هذه الرواية: أنها لا توافق نظرة أئمة أهل البيت ورأيهم في الخلافة ومستحقها، لأنهم يرون ـ كما تدل عليه تصريحاتهم المتكررة، وأقوالهم المتضافرة ـ: «أن منصب الإمامة لا يكون إلا بالنص.
وأما الاستدلال بالقرابة، فقد قلنا في الفصل الأول من هذا الكتاب: أن أول من التجأ إليه أبو بكر، ثم عمر. ثم الأمويون، فالعباسيون، ثم أكثر، إن لم يكن كل مطالب بالخلافة.. وأنه إذا كان في كلام الأئمة وشيعتهم ما يفهم منه ذلك، فإنما اقتضاه الحجاج مع خصومهم.
وبعد.. فهل يخفى على الإمام (عليه السلام) ضعف ووهن هذه الحجة، مع أننا نراه يصرح في أكثر من مناسبة بأن القرابة لا تجدي ولا تفيد ـ كما سنشير إليه ـ وأنه لا بد في الإمام من جدارة وأهلية في مختلف الجهات، وعلى جميع المستويات.
ولقد كان على المأمون ـ لو صحت هذه الرواية ـ أن يغتنمها فرصة، ويعلنها على الملأ، ويشهر بالإمام (عليه السلام)، ليسقطه ـ ومن ثم.. يسقط العلويين كلهم من أعين الناس.. ويسلبهم وإلى الأبد السلاح الذي كانوا يحاربونه ويحاربون آباءه به.. مع أن ذلك هو ما كان يبحث عنه المأمون ليل نهار، ويدبر المكايد، ويعمل الحيل، من أجله، وفي سبيله..
وعدا عن ذلك كله. كيف يمكن أن تنسجم هذه الرواية مع مواقف الإمام، وتصريحاته المتكررة حول مسألة الإمامة، وبأي شيء تثبت، وحول أوصاف الإمام ووظائفه، والتي لو أردنا استقصاءها لاحتجنا إلى عشرات الصفحات؟!.
وكذلك.. مع احتجاج الإمام (عليه السلام) على العلماء والمأمون في أكثر من مناسبة بالنص، وأيضاً مع موقفه (عليه السلام) في نيشابور؟!
اللهم إلا أن يكون أعلم أهل الأرض ـ باعتراف المأمون قد نسي حجته، وحجة آبائه، وكل من ينتسب إليهم، ويذهب مذهبهم..
تلك الحجة ـ التي عرفوا وكل المتشيعين لهم بها على مدى الزمان ـ نسيها ـ في تلك اللحظة فقط، لأن المأمون هو الذي يسأل، والرضا هو الذي يجيب!!.
وبعد، فهل يستطيع أن يشك في ذلك أحد.. وهو يرى رسالة الرضا، التي كتبها للمأمون تلبية لطلبه، وجمع له بها أصول الإسلام، والتي صرح فيها بالنص على علي (عليه السلام). بل وذكر فيها الأئمة الاثني عشر، الذين نص عليهم النبي (صلى الله عليه وآله) كلهم بأسمائهم، حتى من لم يكن قد ولد بعد منهم؟!. وهذه الرسالة مشهورة وقد أوردها واستشهد بها غير واحد من المؤرخين والباحثين(52).
وفيها يصف الإمام (عليه السلام) أئمة الهدى أدق وصف، وأروعه، وأوفاه.
بل إن المأمون نفسه كان يرى وجوب نصب الإمام من قبل الله كالنبي، كما يتضح من مناظرته الشهيرة لعلماء وقته، التي أوردها غير واحد من كتب التاريخ، والأدب، والرواية، وذكرها في العقد الفريد أيضاً قبل ذكره لهذه الرواية المفتعلة. وإن كان قد تصرف فيها [أي في المناظرة]، فحرف فيها، وحذف منها الكثير.. وأشار إليها أيضاً أحمد أمين في ضحى الإسلام ج 2 ص 57، وغيره..
فلماذا لا يلزمه الإمام بمقالته التي كان يلزم نفسه بها؟!. أم يمكن أن لا يكون مطلعاً على مقالة المأمون هذه، التي سار ذكرها في الآفاق؟!.
ويحسن بنا هنا أن ننبه إلى أن الاختلاف في نقل مثل هذه القضايا، حسب أهواء الناقلين لم يكن بالأمر الذي يخفى على أحد.
فقد رأينا: أن جواب أحمد بن حنبل في المحنة بخلق القرآن، يرويه كل من الشيعة، والمعتزلة، وأهل السنة بصور ثلاثة مختلفة، ومناظرة هشام لأبي الهذيل العلاف يروي المعتزلة أن الغلبة فيها كانت لأبي الهذيل، بينما يروي الشيعة، ويؤيدهم المسعودي(53) أن الغلبة فيها كانت لهشام. إلى غير ذلك من عشرات القضايا بل المئات..
ولكن الأمر هنا مختلف تماماً، إذ إن مختلق الرواية هنا قد غفل عن أن روايته المفتعلة تتنافى كلياً مع نظرة الأئمة (عليهم السلام) ورأيهم في الخلافة ومستحقها.. ويبدو أنه لم يكن مطلعا على الآراء المختلفة الشائعة آنذاك في مسألة الإمامة، ولذا نراه ينسب إلى الإمام (عليه السلام) رأياً لا يقول به، ولا يقره. وإنما هو يناسب رأي الشيعة الزيدية القائلين بإمامة ولد علي (عليه السلام) من فاطمة، بشرط أن يكون بليغاً، شجاعاً، عادلاً مجتهداً، يخرج بالسيف ضد كل ظلم وانحراف إلخ.. وبأن إمامة علي (عليه السلام) قد ثبتت بالوصف والإشارة إليه، لا بالتصريح والنص عليه(54).
كما أنه غفل عن أن الذين كانوا يحتجون بالقرابة والإرث هم العباسيون، الذين كانوا إلى عصر المهدي ـ كما قدمنا ـ يدعون انتقال الخلافة إليهم عن طريق علي (عليه السلام)، ومحمد بن الحنفية، وفي عصر المهدي عدلوا عن ذلك، لما يتضمنه من اعتراف للعلويين، ورأوا أن يجعلوا إمامتهم عن طريق العباس وأبنائه.. وحاولوا تقوية هذه النحلة بكل وسيلة، وبذلوا من أجلها الأموال الطائلة للعلماء والفقهاء، والشعراء.
ولم يكن لتخفى على أحد أبيات مروان بن أبي حفصة المتقدمة:
هل تطمسون من السماء نجومها***أو تسترون إلخ..
ولا قوله:
أنى يكون وليس ذلك بكائـــن***لبني البنات وراثة الأعمـــام
وقد أجابه جعفر بن عفان المعاصر له. على هذا البيت بقوله:
ما للطليق وللتراث وإنمــــا***صلى الطليق مخافة الصمصام(55)
وكيف يخفى كل ذلك على الإمام (عليه السلام)، خصوصاً بعد أن كان الجدل في هذا الموضوع قائماً على قدم وساق في زمن هارون، بل وفي زمن المأمون كما يظهر من قول ابن شكلة المتقدم:
فضجت أن نشد عــلى رؤوس***تطالبها بميراث النبـــــي
ومن قول القاسم بن يوسف وهي قصيدة طويلة فلتراجع(56).
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه.. وبعد كل تلك الوقائع الشهيرة التي حدثت قبل خلافة المأمون، وأثناءها بالنسبة لدعوى العباسيين هذه، فلا يمكن أبداً أن تجري المحاورة بين أعلم أهل الأرض [باعتراف المأمون] وبين المأمون أعلم خلفاء بني العباس على هذا النحو من السذاجة والبساطة. اللهم إلا إذا كان أعلم أهل الأرض، لا يرى ولا يسمع، أو أنه كان يعيش في غير هذا العالم، أو في سرداب تحت هذا الأرض. واللهم إلا إذا كان القائل: ما للطليق وللتراث إلخ.. أعلم بالحجة للدعوى التي يدعيها أعلم أهل الأرض من مدعي الدعوى نفسه.. وهل لم يكن يحسن أن يقول للمأمون ـ لو سلم أنه احتج بالقرابة ـ: إن قرابة العباس لا تفيده، بعد أن تخلى عنها يوم الانذار. وبعد أن كان من الظالمين، الذين حرمهم الله من عهده. حيث قال تعالى:(ولا ينال عهدي الظالمين). وبعد أن ترك الهجرة معه (صلى الله عليه وآله). وبعد أن حارب النبي (صلى الله عليه وآله) يوم بدر. وبعد جهله بالدين وأحكامه، ولقد قال سبحانه:(أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون..)(57). إلى آخر ما هنالك.
وأخيراً.. وبعد أن لم يبق مجال للشك في زيف هذه الرواية وافتعالها. فإننا نرى أن لنا كل الحق في أن نسجل هنا: أنه لم يخف علينا، ونأمل أن لا يخفى على أحد سر ذكر ابن عبد ربه هذه الرواية المزيفة المفتعلة، بعد ذكره لرواية احتجاج المأمون على علماء وقته في أفضلية علي (عليه السلام) على جميع الخلق، والتي تصرف فيها ما شاء له حقده ونصبه، الحذف والتحريف، فإنه ـ على ما يبدو ـ ليس إلا من أجل التشويش على تلك، وإبطال كل أثر لها، ظلماً للحقيقة، وتجنيا على التاريخ.
الموقف الثامن:
وأعتقد أنه أعظمها أثراً، وأعمها نفعاً، وهو ما كتبه (عليه السلام) على وثيقة العهد، التي كتبها المأمون بخط يده..
فإننا إذا ما رجعنا إليه نجد: أن كل سطر فيه، بل كل كلمة لها مغزى عميق، ودلالة هامة، تلقي لنا ضوءاً كاشفاً على خطته (عليه السلام) في مواجهة مؤامرات المأمون، وخططه، وأهدافه.
فلقد كان يعلم: أن هذه الوثيقة ستقرأ في مختلف الأقطار الإسلامية، ولذلك نراه (عليه السلام) قد اتخذها وسيلة لإبلاغ الأمة الحقيقة كل الحقيقة، وتعريفها بواقع نوايا وأهداف المأمون. وأيضاً تأكيد حق العلويين، وكشف المؤامرة التي تحاك ضدهم..
فبينما نراه (عليه السلام) يبدأ كلامه ـ فيما كتبه في الوثيقة المشارة إليها ـ بداية غير طبيعية، ولا مألوفة في مناسبات كهذه حيث قال: «الحمد لله الفعال لما يشاء، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه..». لا يأتي بعدها بما يناسب المقام، ويتلائم مع سياق الكلام، من تمجيد الله، والثناء عليه على أن ألهم أمير المؤمنين! هذا الأمر.. بل نراه يأتي بعبارة غريبة، وغير متوقعة، ألا وهي قوله: (يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور..).
أفلا توافقني ـ قارئي العزيز ـ على أنه (عليه السلام) يريد أن يوجه أنظار الناس إلى أن الأمر ينطوي على خيانة مبيتة، وأن هناك صدوراً تخفي غير ما تظهر؟!..
ثم.. ألا توافقني على أن هذه العبارة تعريض بالمأمون نفسه، من أجل تعريف الناس بحقيقة نواياه وأهدافه؟!. هذا مع علمه (عليه السلام) بأن هذه الوثيقة سوف ترسل إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي، لتقرأ على الملأ العام، كما حدث ذلك بالفعل.
وإذا ما وصلنا إلى فقرة أخرى، مما كتبه (عليه السلام) على وثيقة العهد، فإننا نراه يقول: «.. وصلاته على نبيه محمد خاتم النبيين، وآله الطيبين الطاهرين..» فإننا إذا لاحظنا: أنه لم تجر العادة في الوثائق الرسمية في ذلك العهد بعطف «الآل» على «محمد»، ثم توصيفهم ب «الطيبين الطاهرين» ـ نعرف أن هذا ليس إلا ضربة أخرى للخليفة المأمون، وهجوم آخر عليه، حيث إنه يتضمن التأكيد على طهارة أصل الإمام (عليه السلام)، وسنخه، ومحتده، وعلى أن الآل قد اختصوا بهذه المزية، وليس لكل من سواهم. حتى الخليفة المأمون، مثل هذا الشرف، ولا مثل تلك المزية..
ثم نراه (عليه السلام) يعقب ذلك بقوله: «.. إن أمير المؤمنين.. عرف من حقنا ما جهله غيره..».
فما هو ذلك الحق الذي جهله الذي كلهم، حتى بنو العباس، فيما عدا المأمون؟!.
فهل يمكن أن تكون الأمة الإسلامية قد أنكرت أنهم (عليهم السلام) أبناء بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟!. أليس ذلك منه (عليه السلام) إعلان للأمة بأسرها بأن المأمون لم يجعل له إلا ما هو حق له، وأنه لم يزد بذلك على أن أرجع الحق إلى أهله، بعد أن كان قد اغتصبه منهم الغاصبون، واعتدى عليهم به المعتدون؟!. بل أليس ذلك ضربة للمأمون نفسه، وأن خلافته ليست شرعية، ولا صحيحة، لأنه كآبائه مغتصب لحق غيره؟!.
نعم.. إن الحق الذي جهله الناس هو حق الطاعة. ولم يكن الإمام (عليه السلام) يتقي المأمون، ولا غيره من رجال الدولة، في إظهار هذا الحق، وبيان أن خلافة الرسول (صلى الله عليه وآله) إنما كانت في علي (عليه السلام)، وولده الطاهرين، وأنه يجب على الناس كلهم طاعتهم، والانقياد لهم. وقد أعلن (عليه السلام) ذلك في نيشابور كما قدمنا.. ورأيناه يصرح به، ويطلب من الناس أن يعلم شاهدهم غائبهم به، في محضر من رجال الدولة في خراسان.
ففي الكافي: بسنده عن محمد بن زيد الطبري قال: كنت قائماً على رأس الرضا (عليه السلام) بخراسان، وعنده عدة من بني هاشم، وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي، فقال: «يا إسحاق، بلغني أن الناس يقولون: إنا نزعم: أن الناس عبيد لنا!. لا وقرابتي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قلته قط، ولا سمعته من آبائي قاله، ولا بلغني عن أحد من آبائي قاله، ولكنني أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب»(58).
وستأتي الإشارة إلى هذه الرواية مرة أخرى في الفصل الآتي.. وليتأمل في عبارته الأخيرة، فليبلغ إلخ.. وليلاحظ أيضاً أنه اختار لتوجيه خطابه: إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي!!.
وفي الكافي أيضاً بسنده عن معمر بن خلاد قال: سأل رجل فارسي أبا الحسن (عليه السلام)، فقال: طاعتك مفترضة؟ فقال: نعم. قال: مثل طاعة علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟. قال: نعم(59).
والمراد بأبي الحسن هو الرضا (عليه السلام)، لأنه هو الذي كان في خراسان، وهو الذي يروي عنه معمر بن خلاد كثيراً.. ومثل ذلك كثير لا مجال لتتبعه.
ويقول (عليه السلام) في وثيقة العهد، بعد تلك العبارة مباشرة: «.. فوصل أرحاماً قطعت، وآمن أنفساً فزعت، بل أحياها وقد تلقت، وأغناها إذا افتقرت».
وهو كما ترى.. في حين يشكر المأمون، ويكتب تحت اسمه: «بل جعلت فداك» [حسب رواية الإربلي فقط]، لا ينسى أن يشوب ذلك بالازراء ضمناً على آبائه العباسيين. ويذكر بما اقترفوه في حق العلويين، حيث كانوا يلاحقونهم تحت كل حجر ومدر، ويطلبونهم في كل سهل وجبل، كما قدمنا.. هذا.. ولا بأس أن نقف قليلاً عند قوله: «وإنه جعل إلي عهده، والإمرة الكبرى ـ إن بقيت ـ بعده».
فإننا لا نكاد نتردد في أنه (عليه السلام) يشير بقوله: إن بقيت بعده إلى ذلك الفارق الكبير بالسن بينه (عليه السلام)، وبين المأمون، وأنه يتعمد توجيه الأنظار إلى عدم طبيعية هذا الأمر، وإلى عدم رغبته فيه.
وإنه كان يريد أن يعرف الناس بأنه يتوقع في أن لا يدخر المأمون وسعاً من أجل التخلص منه، ولو بالاعتداء على حياته (عليه السلام)، فيما لو سنحت له الفرصة لذلك، بعد أن يكون قد حقق كل ما كان يريد تحقيقه، ووصل إلى ما كان يطمح إلى الوصول إليه، حيث لا بد حينئذ أن «يحل العقدة التي أمر الله بشدها». ولا بد أيضاً أن تنكشف خيانته للملأ، ويظهر ما يخفيه في صدره، على حد تعبيره (عليه السلام).. وإلا فما هو الداعي له (عليه السلام) لإقحام هذا الشرط ـ إن بقيت ـ في أثناء مثل هذا الكلام.
وإننا إذا نظرنا بعمق إلى قوله بعد ذلك: فمن حل عقدة أمر الله بشدها، وفصم عروة أحب الله إيثاقها.. «.. وتأملنا قوله السابق:
يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور. وقوله اللاحق: لكنني امتثلت أمر أمير المؤمنين، وآثرت رضاه.. فلسوف نعرف: أنه (عليه السلام) يعرض هنا بالمأمون نفسه، ويقول الناس جميعاً: إنه لا يشك في أن المأمون سوف ينقض العهد، ويحل العقدة.
ويلاحظ هنا أيضاً: أنه وصف هذه العقدة بأنها مما أمر الله بشده، وأحب إيثاقه.. وهذا لعله لا يختلف عما كان (عليه السلام) يردده، ويؤكد عليه كثيراً، ونص عليه آنفاً، وهو أن المأمون لم يجعل له إلا الحق الذي جهله غيره، واغتصبه هو وآباؤه، منه (عليه السلام) ومن آبائه..
وإذا ما وصلنا إلى قوله (عليه السلام): «.. بذلك جرى السالف، فصبر منه على الفلتات، ولم يعترض بعدها على العزمات، خوفاً من شتات الدين، واضطراب حبل المسلمين، ولقرب أمر الجاهلية الخ..».
فإننا نراه كأنه يستشهد لإطاعته المأمون، وعدم إصراره على الرفض الموجب لتعريض نفسه، والعلويين، وشيعته لهلاك، والاضطهاد ـ يستشهد لذلك ـ بما جرى لسالفه: وهو أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، حيث صبر على الفلتات(60) التي كانت من خلفاء عصره، ولم يعترض (عليه السلام) على ما كانوا قد عقدوا العزم عليه، من المضي قدما في مخططاتهم، التي كانت تستهدف إبعاده عن مسرح السياسة، وتكريس الأمر الواقع، وتثبيته، لأنه يخدم مصالحهم، ويرضي مطامحهم.
ـ لم يعترض علي (عليه السلام) على ذلك ـ لأنه خاف من شتات الدين، واضطراب حبل المسلمين، ولقرب أمر الجاهلية.. وهذا مما قد نص عليه علي (عليه السلام) نفسه في أكثر من مورد، وأكثر من مناسبة، قال (عليه السلام): «.. وأيم الله، لولا مخافة الفرقة بين المسلمين، وأن يعود الكفر، ويبور الدين، لكنا على غير ما كنا لهم عليه..»، ويقول: «إن الله لما قبض نبيه، استأثرت علينا قريش بالأمر، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة، فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين، وسفك دمائهم، والناس حديثوا عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الوطب، يفسده أدنى وهن، ويعكسه أدنى خلف..»(61).
وهكذا تمام كان الحال بالنسبة للإمام الرضا (عليه السلام)، حفيد علي (عليه السلام)، ووارثه، الذي كان زمانه لا يبعد حال الناس فيه على حال الجاهلية، فإنه آثر أن يصبر على هذه المحنة، خوفاً من شتات الدين، واضطراب حبل المسلمين، وذلك بتعريض نفسه، وشيعته، والعلويين للهلاك، أو على الأقل للاضطهاد، الأمر الذي سوف تكون له أسوأ النتائج على الدين والأمة، كما قلنا..
وإذا ما قرأنا بعد ذلك قوله (عليه السلام): «.. وقد جعلت الله على نفسي، ـ إن استرعاني على المسلمين، وقلدني خلافته ـ العمل فيهم عامة، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصة، بطاعة الله، وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله)..».. فإن ما يسترعي انتباهنا هو تنصيصه على بني العباس خاصة وأنه سوف يعمل فيهم بطاعة الله، ورسوله.. «فلا يسفك دماً حراماً، ولا يبيح فرجاً ولا مالاً، إلا ما سفكته حدوده، وأباحته فرائضه إلخ.».
فإن هذا التنصيص إنما هو في مقابل «الأرحام التي قطعت، وفزعت،
وتلفت، وافتقرت..»، من العلويين، على يد بني العباس، الذين فعلوا بهم. أكثر من فعل بني أمية معهم، حسبما قدمنا.
وتعهده والتزامه بأن يعمل في المسلمين عامة. وفي بني العباس خاصة، بطاعة الله، وسنة ورسوله.. هو التزام بنفس الخط الذي التزم به علي (عليه السلام)، وتعهد بانتهاجه. الأمر الذي كان سبباً في إبعاده عن الخلافة في الشورى، واضطلاع عثمان بها. بل كان ذلك هو السبب في إبعاده عنها، بالنسبة لما قبل ذلك أيضاً، وما جرى بعده.
وعلي (عليه السلام) هو نفس ذلك الذي استشهد به آنفاً، وبين أنه صبر على الفلتات، ولم يعترض على العزمات خوفاً من شتات الدين إلخ.. والالتزام بخط علي (عليه السلام) لن يرضي المأمون، والعباسيين، والهيئة الحاكمة، ولن يكون في مصلحتهم، حسبما المحنا إليه في فصل: جدية عرض الخلافة..
كما أننا لا نستبعد كثيراً: أنه (عليه السلام) يريد أن ينبه على مدى التفاوت بين المنطلقات لسياسات أهل البيت، ومنطلقات سياسات خصومهم، التي عرفت جانباً منها في القسم الأول من هذا الكتاب.
ومن هنا نعرف السر في قوله (عليه السلام): «.. وأن أتخير الكفاة جهدي وطاقتي..» فإنه إشارة إلى أنه (عليه السلام) سوف ينطلق في كل نصب وعزل ـ تماماً كالإمام علي (عليه السلام) ـ من مصلحة الأمة، وعلى وفق رضا الله، وتعاليم رسوله. لا من مصالح شخصية، أو اعتبارات سياسية، أو قبلية، أو غير ذلك من الاعتبارات، التي لا يعترف بها الإسلام، ولا يقيم لها وزناً.
وإذا ما قرأنا قوله (عليه السلام): «.. وإن أحدثت، أو غيرت، أو بدلت، كنت للغير مستحقاً، وللنكال متعرضاً، وأعوذ بالله من سخطه إلخ.».
فإننا ندرك للتو أنه (عليه السلام) يريد ضرب العقيدة، التي كان قد شجعها الحكام، وروج لها علماء السوء.. من أن الخليفة، بل مطلق الحاكم في منأى ومأمن من أي مؤاخذة، أو عقاب، مهما اقترف من جرائم، وأتاه من موبقات، فهو فوق القانون، ولا يجوز لأحد الخروج، أو الاعتراض عليه، في أي ظرف من الظروف والأحوال، حتى ولو رمى القرآن بالنبل، وقتل ابن بنت رسول الله، فضلاً عما عدا ذلك من الجرائم والموبقات..
والإمام.. الذي يعرف كيف كانت سيرة المأمون، وسائر خلفاء بني العباس، ومن لف لفهم، والتي عرفت فيما تقدم طرفاً منها، والذين كانوا يتمتعون بهذه الحصانة الزائفة.. قد أراد أن يوجه ضربة قاضية لهم جميعا، حتى للمأمون. وأشياعه، وكل من كان الطواغيت والظلمة على شاكلتهم، ويبين لهم. وللملأ أجمع: أن الحاكم حارس للنظام والقانون، ولا يمكن أن يكون فوق النظام والقانون، ولذا فلا يمكن أن يكون في منأى عن العقاب والقصاص، لو ارتكب أي جريمة، أو اقترف أية عظيمة.
فالمأمون، وآباؤه، وأشياعهم، كانوا يضحون بكل شيء في سبيل أنفسهم، ومصالحهم الشخصية، ويقترفون كل عظيمة في سبيل تدعيم حكمهم، وتقوية سلطانهم.. أما الإمام (عليه السلام) فهو مستعد لأن يقدم نفسه ـ إن اقتضى الأمر ـ للعقاب والنكال، عند صدور أية مخالفة، وحصول أي تجاوز عما يرضي الله تعالى، وعن سنة رسوله.
وبعد كل ما تقدم.. نراه يعبر عن عدم رضاه بهذا الأمر، وعدم تهالكه عليه، لعلمه بعدم تماميته له، ويقول بصريح العبارة: إنه أمر لا يتم، لأن «.. الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك». كما أن في هذا تنويه مهم منه (عليه السلام) بذكر الركن الثاني من أركان إمامة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وهو أن الله تعالى اختصهم بأمور غيبية، وعلوم لدنية، منعها عن سائر الناس، وهذان الكتابان: الجفر، والجامعة، هما من الكتب التي أملاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) على علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكتبها بخط يده، وقد أظهر الأئمة (عليهم السلام) بعض هذه الكتب التي بخط علي (عليه السلام)، وبإملاء الرسول (صلى الله عليه وآله) لعدة من كبار شيعتهم، واستشهدوا بها في موارد عديدة في الأحكام(62).
وفي الحقيقة.. إن الإمام (عليه السلام)، وإن قبل ولاية العهد مكرها من المأمون.. ولكنه يريد بكلامه هذا، واستشهاده بالجفر والجامعة أن يقول له، ولكل من كان على شاكلته بصريح العبارة: «.. قد أنبأنا الله بأخباركم، وسيرى الله عملكم. ورسوله، والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون، ويجزيكم على ظلمكم وبغيكم علينا، وانتهاككم الحرمات منا، ولعبكم بدمائنا وأعراضنا، وأموالنا».
ثم نراه يترقى في صراحته، حيث يقول: «.. لكنني امتثلت أمر أمير المؤمنين، وآثرت رضاه..» أي أنه لو لم يقبل بهذا الأمر لتعرض لسخط المأمون.. والكل يعلم ماذا كان يعني سخط أولئك الحكام، الذين كانوا لا يحتاجون إلى أي مبرر لاقترافهم أي جريمة. وإقدامهم على أي عظيمة.
وأخيراً.. ورغم أن المأمون قد تقدم منه (عليه السلام) وطلب منه أن يشهد الله، والحاضرين على نفسه.. نراه يأبى أن يكون المأمون، ولا أي من الحاضرين شاهداً على نفسه، ولا جعل لهم على نفسه سبيلا، لأنه كان يعلم بما كانت تكنه صدورهم. وتضطرم به قلوبهم عليه. بل جعل الله فقط شهيداً عليه، واستعان بالآية الكريمة، التي تقطع الطريق على كل أحد، وتكتفي بالله شهيداً، حيث قال: «وأشهدت الله على نفسي(وكفى بالله شهيداً)».
وإذا كان لا بد من كلمة:
وإذا كان لا بد في نهاية المطاف من كلمة، فإننا نقول: إن أولئك الذين عاشوا في تلك الفترة، ووقفوا على الظروف والملابسات التي اكتنفت هذا الحدث التاريخي الهام ـ إن هؤلاء ولا شك ـ كانوا أقدر منا على فهم جميع ما كان يرمي إليه الإمام (عليه السلام) من كل كلمة، كلمة، مما كتبه على وثيقة العهد..
وإذا كان هناك من يرى: أن بعض الفقرات تحتمل غير ما قلناه..
فإننا نرى: أن كون بعض الفقرات الأخرى لا يحتمل غير ما قلنا، وأيضاً بما أن ما ذكرناه هو الذي يساعد على الجو العام. الذي توحي به النصوص التاريخية الكثيرة جداً، والتي قدمنا وسيأتي شطر منها ـ إن ذلك ـ وهو ما يجعلنا نجزم بأن ما فهمناه هو بعض ما كان يرمي إليه (عليه السلام) مما كتبه على وثيقة العهد.
ملاحظات هامة:
إن من الأمور الغريبة حقاً أن نرى نفس الخليفة يكتب وثيقة العهد ـ الطويلة جداً! ـ بخط يده.. وأغرب منه أنه تقدم إلى الإمام (عليه السلام)، وقال له: «اكتب خطك بقبول هذا العهد. وأشهد الله والحاضرين عليك، بما تعده في حق الله ورعاية المسلمين»(63).
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى المأمون، وأنه يريد تطويق هذا الموضوع من جميع جهاته، وإن استلزم ذلك كل تلك الأمور، وإلا.. فما هو الداعي لأن يكتب له العهد بخط يده!! ثم أن يتقدم إليه بنفسه!!. ثم ما الداعي لأن يطلب من الإمام ذلك!!.
هذا.. ولا بأس أيضاً بملاحظة تعبير المأمون ب «قبول»!!. ثم ملاحظة أنه طلب منه أن يكتب هذا القبول ب «خط يده»!!. ثم طلب منه أن يشهد الله والحاضرين على نفسه!!.
حقا.. إنها للعبقرية السياسية:
وعلى كل حال.. فلا شك أن المحاورات السياسية تعتبر من الصنايع المستظرفة،، وذلك لما تتضمنه من تعريضات، وكنايات، حسبما تفرضه الاتجاهات السياسية، التي يلتزم بها المتحاورون..
ولذا.. نلاحظ أنه (عليه السلام).. وإن كان يضمن كلامه الشكر للمأمون، بل ويكتب تحت اسمه ـ حسب رواية الإربلي فقط ـ: «بل جعلت فداك. ولكنه يبطن كلامه، ويضمنه تعريضات عميقة، بلهجة معتدلة، لا عنف فيها».
وذلك يعني: أن الإمام (عليه السلام) لم يتنازل عن مبدئه، ولا حاد عن نهجه، الذي اختطه لنفسه، بوحي من رسالة الله، وتعاليم محمد (صلى الله عليه وآله)، وخطى جده علي (عليه السلام).. لم يحد عنه قيد شعرة، ولا هاون فيه، ولا حابى أحداً، حتى في هذا الموقف.
ولعمري.. لو كان ما كتبه الإمام الرضا (عليه السلام) على وثيقة العهد من شخص عادي آخر، لكان يقال عنه الشيء الكثير تعظيماً وتبجيلاً، حيث إنه لم يضل عن خطته التي اختطها لنفسه، ولا حاد عن نهجه قيد أنملة.. مع أن المأمون كان قد فاجأه بطلب الكتابة على الوثيقة، ولم يكن هو مستعداً، ولا متوقعا لذلك، لأن العادة لم تكن قد جرت على ذلك..
وهذا ولا شك مما يزيد من عظمة الإمام، ويعلي من شأنه، ويستدعي المزيد من التعظيم والتبجيل له.
ولكن الحقيقة هي: أنه ـ وهو الإمام المعصوم ـ غني عن كل تلكم التقريظات، وعن ذلكم التعظيم والتبجيل..
الموقف التاسع:
شروطه (عليه السلام) على المأمون لقبول ولاية العهد، وهي:
«أن لا يولي أحداً، ولا يعزل أحداً، ولا ينقض رسماً، ولا يغير شيئاً مما هو قائم، ويكون في الأمر مشيراً من بعيد»(64)، فأجابه المأمون إلى ذلك كله!!!.
وفي ذلك تضييع لجملة من أهداف المأمون.. إذ إن:
1 ـ السلبية تعني الاتهام:
فإن من الطبيعي أن تثير سلبيته هذه الكثير من التساؤلات لدى الناس، ولسوف تكون سبباً في وضع علامات استفهام كبيرة، حول الحكم، والحكام. وكل أعمالهم وتصرفاتهم، إذ إن السلبية إنما تعني: أن نظام الحكم لا يصلح حتى للتعاون معه، بأي نحو من أنحاء التعاون، وإلا فلماذا يرفض ـ حتى ولي العهد ـ التعاون مع نظام هو ولي العهد فيه، ويأبى التأييد لأي من تصرفاته وأعماله؟!.
2 ـ رفض الاعتراف بشرعية ذلك النظام:
ولقد قدمنا: أن من جملة أهداف المأمون هو أن يحصل من الإمام (عليه السلام) على اعتراف ضمني بشرعية حكمه وخلافته، كما صرح هو نفسه بذلك «وليعترف بالملك، والخلافة لنا».
والإمام.. بشروطه تلك يكون قد رفض الاعتراف بشرعية النظام القائم. بأي نحو من أنحاء الاعتراف، ولم يعد قبوله بولاية العهد يمثل اعترافا بذلك، ولا يدل على أن ذلك الحكم يمثل الحكم الإسلامي الأصيل.
هذا.. وقد عضد شروطه هذه، بسلوكه السلبي مع المأمون، والهيئة الحاكمة، طيلة فترة ولاية العهد، يضاف إلى ذلك تصريحاته المتكررة، التي تحدثنا عنها فيما سبق.
3 ـ النظام القائم لا يمثل وجهة نظره في الحكم:
والأهم من كل ذلك: أن شروطه هذه كانت بمثابة الرفض القاطع لتحمل المسؤولية عن أي تصرف يصدر من الهيئة الحاكمة. وليس للناس ـ بعد هذا ـ أن ينظروا إلى تصرفات وإعمال المأمون وحزبه، على أنه تحظى برضى الإمام (عليه السلام) وموافقته. ولا يمكن لها ـ من ثم ـ أن تعكس وجهة نظره (عليه السلام) في الحكم ورأيه في أساليبه، التي هي في الحقيقة وجهة نظر الإسلام الصحيح فيه. الإسلام. الذي يعتبر الأئمة (عليه السلام) الممثلين الحقيقيين له، في سائر الظروف، ومختلف المجالات..
وانطلاقاً مما تقدم: نراه (عليه السلام) يرفض ما كان يعرضه عليه المأمون، من: كتابة بتولية أو عزل إلى أي إنسان.. ويرفض أيضاً: أن يؤم الناس في الصلاة مرتين.. إلى آخر ما سيأتي بيانه.
وفي كل مرة كان يرفض فيها مطالب المأمون هذه نراه يحتج عليه بشروطه تلك، فلا يجد المأمون الحيلة لما يريده، وتضيع الفرصة من يده، ولا بد من ملاحظة: أنه عندما أصر عليه المأمون بأن يؤم الناس في الصلاة، ورأي (عليه السلام): أنه لا بد له من قبول ذلك ـ نلاحظ ـ: أنه اشترط عليه أن يخرج كما كان يخرج جده رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا كما يخرج الآخرون..
ولم يكن المأمون يدرك مدى أهمية هذا الشرط، ولا عرف أهداف الإمام من وراء اشتراطه هذا، فقال له ولعله بدون اكتراث: أخرج كيف شئت.. وكانت نتيجة ذلك.. أنه (عليه السلام) قد أفهم الناس جميعاً:
أن سلوكه وأسلوبه، وحتى مفاهيمه، تختلف عن كل أساليب ومفاهيم وسلوك الآخرين. وأن خطه هو خط محمد (صلى الله عليه وآله)، ومنهاجه هو منهاج علي (عليه السلام)، ربيب الوحي، وغذي النبوة، وليس هو خط المأمون وسواه من الحكام، الذين اعتاد الناس عليهم، وعلى تصرفاتهم وأعمالهم.
ولم يعد يستطيع المأمون، أن يفهم الناس: أن الحاكم: من كان، ومهما كان، هذا هو سلوكه، وهذه هي تصرفاته. وأن كل شخصية: من ومهما كانت، وإن كانت قبل أن تصل إلى الحكم تتخذ العدل، والحرية: والمساواة، وغير ذلك شعارات لها، إلا أنها عندما تصل إلى الحكم، لا يمكن إلا أن تكون قاسية ظالمة، مستأثرة بكل شيء، ومستهترة بكل شيء، ولذا فليس من مصلحة الناس أن يتطلعوا إلى حكم أفضل مما هو قائم، حتى ولو كان ذلك هو حكم الإمام (عليه السلام) المعروف بعلمه وتقواه وفضله الخ.. فضلاً عن غيره من العلويين أو من غيرهم ـ لم يعد يستطيع أن يقول ذلك ـ لأن الواقع الخارجي قد أثبت عكس ذلك تماماً، إذ قد رأينا: كيف أن الإمام (عليه السلام) بشروطه تلك، وبسائر مواقفه من المأمون ونظام حكمه.. يضيع على المأمون هذه الفرصة، ولم تجده محاولاته فيما بعد شيئاً، بل إن كثيراً منها كان سوءا ووبالاً عليه، كما سيأتي.
4 ـ لا مجال بعد للمأمون لتنفيذ مخططاته:
ولعل من الواضح: أن شروطه تلك قد مكنته من أن يقطع الطريق على المأمون، ولا يمكنه من استغلال الظروف لتنفيذ بقية حلقات مؤامرته، إذ لم يعد بإمكانه أن يصر على الإمام أن يقوم بأعمال تنافي وتضر بقضيته هو، وقضية العلويين، ومن ثم تؤثر على الأمة بأسرها.. وعدا عن ذلك فإن هذه الشروط، قد حفظت له (عليه السلام) حياته في حمام سرخس، حيث كان المأمون قد حاك مؤامرته للتخلص من وزيره وولي عهده مرة واحدة، كما سيأتي بيانه.. مما يعني أن سلبيته (عليه السلام) مع النظام كانت أمراً لابد منه، إذا أراد أن لا يعرض نفسه إلى مشاكل، وأخطار هو في غنى عنها.. والذي أمن له هذه السلبية ليس إلا شروطه تلك، التي جعلت من لعبة ولاية العهد لعبة باهتة مملة لا حياة فيها، ولا رجاء..
ولعل الأهم من كل ذلك.. أنها ضيعت على المأمون الكثير من أهدافه من البيعة، التي صرح الإمام (عليه السلام) أنه كان عارفاً بها، ولم يكن له خيار في تحملها، والصبر عليها، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
وعدا عن ذلك كله أن تعاونه مع النظام إنما يعني أن يحاول تصحيح السلوك، وتلافي الأخطاء، التي كان يقع فيها الحكم، والهيئة الحاكمة. وذلك معناه أن ينقلب جهاز الحكم كله ضد الإمام، ويجد المأمون ـ من ثم ـ العذر، والفرصة لتصفيته (عليه السلام) من أهون سبيل، فشروطه تلك أبعدت عنه الخطر ـ إلى حد ما ـ الذي كان يتهدده من قبل المأمون وأشياعه، وجعلته ـ كما قلنا ـ في منأى ومأمن من كل مؤامراتهم ومخططاتهم.
5 ـ الإمام.. لا ينفذ إرادات الحكم:
ولعل من الأهمية بمكان.. أن نشير إلى أنه (عليه السلام) كان يريد بشروطه تلك أن يفهم المأمون: أنه ليس على استعداد لتنفيذ إرادات الحكم، والحاكم، ولا على استعداد لأن يقتنع بالتشريفات، والأمور الشكلية، فإنه.. بصفته القائد والمنقذ الحقيقي للأمة، لا يمكن أن يرضى بديلاً عن أن ينقذ الأمة، ويرتفع بها من مستواها الذي أوصلها إليه الطواغيت والظلمة، الذين جلسوا في مكان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأوصيائه (عليهم السلام)، وحكموا بغير ما أنزل الله.
إنه يريد أن يخدم الأمة، ويحقق لها مكاسب تضمن لها الحياة الفضلى، والعيش الكريم، ولا يريد أن يخدم نفسه، ويحقق مكاسب شخصيته على حساب الآخرين، ولذلك فهو لا يستطيع أن يقتنع بالسطحيات والشكليات التي لا تسمن، ولا تغني من جوع..
6 ـ لا زهد أكثر من هذا:
إنه مضافاً إلى أن مجرد رفض الإمام كلا عرضي المأمون: الخلافة، وولاية العهد، دليل قاطع على زهده فيه. فإن هذه الشروط كان لها عظيم الفائدة، وجليل الأثر في الإظهار لكل أحد أن الإمام ليس رجل دنيا، ولا طالب جاه ومقام. وما أراده المأمون من إظهار الإمام على أنه لم يزهد بالدنيا، وإنما الدنيا هي التي زهدت فيه.. لم يكن إلا هباء اشتدت به الريح في يوم عاصف.. ولم تفلح بعد محاولات المأمون وعمله الدائب، من أجل تشويه الإمام والنيل من كرامته.
ولقد قدمنا: أن الإمام (عليه السلام) قد واجه نفس المأمون بحقيقة نواياه، وأفهمه أن خداعه لن ينطلي عليه، ولن تخفى عليه مقاصده، ولذا فإن من الأفضل والأسلم له أن يكف عن كل مؤامراته ومخططاته.. وإلا فإنه إذا ما أراد إجبار الإمام على التعاون معه، فلسوف يجد أنه (عليه السلام) على استعداد لفضحه، وكشف حقيقته وواقعه أمام الملأ، وإفهام الناس السبب الذي من أجله يجهد المأمون ليزج بالإمام (عليه السلام) في مجالات لا يرغب، بل واشترط عليه أن لا يزج فيها ـ كما فعل في مناسبات عديدة ـ الأمر الذي لن يكون أبداً في صالح المأمون، ونظام حكمه..
ومن هنا رأيناه (عليه السلام) يجيب الريان عندما سأله عن سر قبوله بولاية العهد، وإظهاره الزهد بالدنيا ـ يجيبه ـ: ببيان أنه مجبر على هذا الأمر، ويذكره بالشروط هذه، التي يعني أنه قد دخل فيه دخول خارج منه، كما تقدم..
وهكذا.. وبعد أن كان (عليه السلام) سلبياً مع النظام، وبعد رفضه لكلا عرضي المأمون، وبعد أن اشترط هذه الشروط للدخول في ولاية العهد، فليس من السهل على المأمون، ولا على أي إنسان آخر أن ينسب إليه (عليه السلام): أنه رجل دنيا فقط، وأنه ليس زاهدا في الدنيا، وإنما هي التي زهدت فيه.
وعلى كل حال: ورغم كل محاولات المأمون تلك.. فقد استطاع الإمام (عليه السلام)، بفضل وعيه، ويقظته، وإحكام خطته: أن يبقى القمة الشامخة للزهد، والورع، والنزاهة، والطهر، وكل الفضائل الإنسانية، وإلى الأبد.
الموقف العاشر:
موقفه (عليه السلام) في صلاتي العيد.. ففي إحداهما:
«بعث المأمون له يسأله: أن يصلي بالناس صلاة العيد، ويخطب، لتطمئن قلوب الناس، ويعرفوا فضله، وتقر قلوبهم على هذه الدولة المباركة، فبعث إليه الرضا (صلى الله عليه وآله)، وقال: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشرط في دخولي في هذا الأمر، فاعفني من الصلاة بالناس، فقال المأمون: إنما أريد بهذا أن يرسخ في قلوب العامة، والجند، والشاكرية هذا الأمر، فتطمئن قلوبهم، ويقروا بما فضلك الله تعالى به..
ولم يزل يراده الكلام في ذلك. فلما ألح عليه قال: يا أمير المؤمنين، إن أعفيتني من ذلك، فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال المأمون: أخرج كيف شئت..
وأمر المأمون القواد، والحجاب، والناس: أن يبكروا إلى باب أبي الحسن (عليه السلام)، فقعد الناس لأبي الحسن في الطرقات، والسطوح: من الرجال، والنساء، والصبيان، وصار جميع القواد، والجند إلى بابه (عليه السلام)، فوقفوا على دوابهم حتى طلعت الشمس.
فلما طلعت الشمس قام الرضا (عليه السلام) فاغتسل، وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، وألقى طرفاً منها على صدره، وطرفاً بين كتفيه، ومس شيئاً من الطيب، وتشمر. ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت.
ثم أخذ بيده عكازة، وخرج، ونحن بين يديه، وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب مشمرة..
فلما قام، ومشيناً بين يديه، رفع رأسه إلى السماء، وكبر أربع تكبيرات، فخيل إلينا: أن الهواء والحيطان تجاوبه، والقواد والناس على الباب، قد تزينوا، ولبسوا السلاح، وتهيأوا بأحسن هيئة..
فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة: حفاة، قد تشمرنا. وطلع الرضا وقف وقفة على الباب، وقال: «.. الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا». ورفع بذلك صوته، ورفعنا أصواتنا.
فتزعزعت مرو بالبكاء، فقالها: ثلاث مرات، فلما رآه القواد والجند على تلك الصورة، وسمعوا تكبيره سقطوا كلهم من الدواب إلى الأرض، ورموا بخفافهم، وكان أحسنهم حالاً من كان معه سكين قطع بها شرابة جاجيلته ونزعها، وتحفى.. وصارت مرو ضجة واحدة، ولم يتمالك الناس من البكاء والضجة.
فكان أبو الحسن يمشي، ويقف في كل عشر خطوات وقفة يكبر الله أربع مرات: فيتخيل إلينا: أن السماء، والأرض، والحيطان تجاوبه.
وبلغ المأمون ذلك، فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستين: يا أمير المؤمنين: إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس، وخفنا كلنا على دمائنا، فالرأي أن تسأله أن يرجع..
فبعث المأمون إلى الإمام يقول له: إنه قد كلفه شططا، وأنه ما كان يحب أن يتعبه، ويطلب منه: أن يصلي بالناس من كان يصلي بهم..
فدعا أبو الحسن بخفه، فلبسه، ورجع.
واختلف أمر الناس في ذلك اليوم، ولم ينتظم في صلاتهم إلخ..»(65).
ولقد قال البحري يصف هذه الحادثة والظاهر أنه يمين بن معاوية العائشي الشاعر على ما في تاج العروس:
ذكروا بطلعتك النبي، فهللــوا***لما طلعت من الصفوف وكبروا
حتى انتهيت إلى المصلى لابساً***نور الهدى يبدو عليك فيظهـر
ومشيت مشية خاشع متواضـع***لله، ولا يزهى، ولا يتكبـــر
ولوان مشتاقا تكلف غير مــا***في وسعه لمشى إليك المنبر(66)
ومما يلاحظ هنا: أنه في هذه المرة أرسل إليه من يطلب منه أن يرجع. ولكننا في مرة أخرى نراه يسارع بنفسه، ويصلي بالناس، رغم تظاهره بالمرض..
وعلى كل حال.. فإننا وإن كنا قد تحدثنا في هذا الفصل، وفي فصل: ظروف البيعة وسنتحدث فيما يأتي عن بعض ما يتعلق بهذه الرواية، إلا أننا سوف نشير هنا إلى نقطتين فقط.. وهما:
1 ـ الأثر العاطفي، والقاعدة الشعبية:
فنلاحظ: أننا حتى بعد مرور اثني عشر قرنا على هذه الواقعة، لا نملك أنفسنا ونحن نقرأ وقائعها، من الانفعال والتأثر بها، فكيف إذن كانت حال أولئك الذين قدر لهم أن يشهدوا ذلك الموقف العظيم؟!.
وغني عن البيان هنا: أن شأن هذه الواقعة هو شأن واقعة نيشابور، من حيث دلالتها دلالة قاطعة على كل ما كان للرضا من عظمة وتقدير في نفوس الناس وقلوبهم، وعلى مدى اتساع القاعدة الشعبية له (عليه السلام)..
2 ـ لماذا يجازف المأمون بإرجاعه (عليه السلام):
وإذا كان هدف المأمون من الاصرار على الإمام بأن يصلي بالناس هو أن يخدع الخراسانيين والجند والشاكرية، ويجعلهم يطمئنون على دولته المباركة فإنه من الواضح أيضاً أن إرجاع المأمون للإمام (عليه السلام) في مثل تلك الحالة، وذلك التجمع الهائل، وتلك الثورة العاطفية في النفوس، كان ينطوي على مجازفة ومخاطرة لم تكن لتخفى على المأمون، وأشياعه، حيث لا بد وأن يثير تصرفه هذا حنق تلك الجماهير التي كانت في قمة الهيجان العاطفي، ويؤكد كراهيتها له.. وعلى الأقل لن تكون مرتاحة لتصرفه هذا على كل حال.
وبعد هذا.. فإنه إذا كان المأمون يخشى من مجرد إقامة الإمام للصلاة.. فلا معنى لأن يلح عليه هو بقبولها.. وكذلك لا معنى لأن يخشى ذلك الهيجان العاطفي، وتلك الحالة الروحية، التي أثارها فعل الإمام (عليه السلام) وتصرفه في هذا الموقف.. فذلك إذن ما لم يكن يخافه ويخشاه.. فمن أي شيء خاف المأمون إذن؟! إنه كان يخشى ما هو أعظم وأبعد أثراً، وأشد خطراً.. إنه خشي من أن الرضا إذا ما صعد المنبر، وخطب الناس، بعد أن هيأهم نفسيا، وأثارهم عاطفيا إلى هذا الحد ـ خشي ـ أن يأتي بمتمم لكلامه الذي أورده في نيشابور: «وأنا من شروطها..» وأنه ظهر إليهم على الهيئة التي كان يخرج عليها النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، ووصيه علي (عليه السلام) وهو أمر جديد عليهم.. ما من شأنه أن يجعل المأمون وأشياعه لا يأمنون بعد على أنفسهم، كما ذكر الفضل بن سهل.. ولسوف يحول الإمام مرواً من معقل للعباسيين والمأمون، وعاصمة، وحصن قوي لهم ضد أعدائهم ـ من العرب وغيرهم ـ سوف يحولها إلى حصن لأعداء العباسيين والمأمون، حصن لأئمة أهل البيت. ففضل المأمون: أن يختار إرجاعه (عليه السلام) عن الصلاة، لأنه رأى أن ذلك هو أهون الشرين، وأقل الضررين..
ولقد جرب المأمون الرضا أكثر من مرة، وأصبح يعرف أنه مستعد لأن يعلن رأيه صراحة في أي موقف تؤاتيه فيه الفرصة، ويقتضي الأمر فيه ذلك. ولم ينس بعد موقفه في نيشابور، ولا ما كتبه في وثيقة العهد، ولا غير ذلك من مواقفه (عليه السلام) وتصريحاته في مختلف الأحوال والظروف..
الموقف الحادي عشر:
وأخيراً.. فقد كان سلوك الإمام (عليه السلام) العام، سواء بعد عقد ولاية العهد له، أو قبلها. يمثل ضربة لكل خطط المأمون ومؤامراته، ذلك السلوك المثالي، الذي لم يتأثر بزبارج الحكم وبهارجه..
ويكفي أن نذكر هنا ما وضعه به إبراهيم بن العباس، كاتب القوم وعاملهم، حيث قال: «ما رأيت أبا الحسن جفا أحداً بكلامه قط، وما رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه. وما رد أحداً عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط. ولا اتكأ بن يدي جليس له قط، ولا شتم أحداً من مواليه ومماليكه قط، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسم. وكان إذا خلا، ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه، حتى البواب والسائس.
وكان قليل النوم بالليل، يحيى أكثر لياليه من أولها إلى الصبح. وكان كثير الصيام، فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر، ويقول: ذلك صوم الدهر. وكان كثير المعروف والصدقة في السر، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله، فلا تصدقوه..»(67).
وهذه الصفات بلا شك قد أسهمت إسهاماً كبيراً في أن يكون الإمام (عليه السلام) هو الأرضى في الخاصة والعامة، وأن تنفذ كتبه في المشرق والمغرب، إلى غير ذلك مما تقدم..
الحكم ليس امتيازاً وإنما هو مسؤولية:
وقد اعترض عليه بعض أصحابه، عندما رآه يأكل مع خدمه وغلمانه، حتى البواب والسائس، فأجابه (عليه السلام): «مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال..»(68).
وقال له أحدهم: أنت والله خير الناس، فقال له الإمام: «لا تحلف يا هذا، خير مني من كان أتقى لله تعالى. وأطوع له، والله ما نسخت هذه الآية:(وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم..)(69).
وقال لإبراهيم العباسي: إنه لا يرى أن قرابته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) تجعله خيراً من عبد أسود، إلا أن يكون له عمل صالح فيفضله به(70).
وقال رجل له: ما على وجه الأرض أشرف منك آباء. فقال: التقوى شرفهم، وطاعة الله أحظتهم(71).
وما نريد أن نشير إليه ونؤكد عليه هنا، هو أنه (عليه السلام) يريد بذلك أن يفهم الملأ: أن الحكم لا يعطي للشخص ـ من كان، ومهما كان ـ امتيازاً، ولا يجعل له من الحقوق ما ليس لغيره، وإنما الامتياز ـ فقط ـ بالتقوى والفضائل الأخلاقية.. وكل شخص حتى الحاكم سوف يلقى جزاء أعماله: إن خيراً فخير، وإن شرا فشر، وعليه فما يراه الناس من سلوك الحكام، ليس هو السلوك الذي يريده الله، وتحكم به النواميس الأخلاقية، والإنسانية. والامتيازات التي يجعلونها لأنفسهم، ويستبيحون بها ما ليس من حقهم لا يقرها شرع، ولا يحكم بها قانون..
وبكلمة مختصرة: إن الإمام (عليه السلام) يرى: أن الحكم ليس امتيازاً، وإنما هو مسؤولية.
وعلى كل حال.. فإن سلوك الإمام (عليه السلام)، لخير دليل على ما كان يتمتع به من المزايا الأخلاقية، والفضائل النفسية.. ويكفي أنه لم يظهر منه (عليه السلام) طيلة الفترة التي عاشها في الحكم إلا ما ازداد به فضلاً بينهم، ومحلاً في نفوسهم، على حد تعبير أبي الصلت. وعلى حد تعبير شخص آخر: أقام بينهم لا يشركهم في مأثم من مآثم الحكم.. بل لقد كان لوجوده أثر كبير في تصحيح جملة من الأخطاء والانحرافات التي اعتادها الحكام آنئذٍ.. حتى لقد استطاع أن يؤثر على نفس المأمون، ويمنعه من الشراب والغناء، طيلة الفترة التي عاشها معه، إلى آخر ما هنالك، مما لسنا هنا في صدد تتبعه واستقصائه.
وفي نهاية المطاف نقول:
وحسبنا هنا ما ذكرنا من الأمثلة، التي نحسب أنها تكفي لأن تلقي ضوءاً كاشفاً على الخطة التي اتبعها الإمام (عليه السلام) في مواجهة خطط المأمون ومؤامراته.. تلك الخطة التي كانت تكفي لأن لا تبقى الصورة التي أرادها المأمون في أذهان الناس، ولا مبرر للشكوك لأن تبقى تراود نفوسهم.
ولقد نجحت تلك الخطة نجاحا أذهل المأمون، وأعوانه، وجعلهم يتصرفون بلا روية، ويقعون بالمتناقضات.. حتى لقد أشرف المأمون منه على الهلاك. حسبما صرح به المأمون نفسه. وكانت النتيجة أن دبر فيه المأمون بما يحسم عنه مواد بلائه، كما وعد حميد بن مهران، وجماعة من العباسيين.
_______________________________________________________
(29) راجع: مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 364، ومعادن الحكمة ص 192، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 140، والبحار ج 49 ص 140 141.
(30) راجع: نظرية الإمامة، للدكتور أحمد محمود صبحي وغيره.
وفي تاريخ بغداد ج 5 ص 274،: أنه قيل لأبي مسهر: كيف لم تكتب عن محمد بن راشد؟! قال: «كان يرى الخروج على الأئمة».. وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى ج 3 ص 58، في مقام ترجيح سفيان على حسن بن حي، كان من جملة ما جرحه به أنه: «كان يرى السيف» ومثل ذلك كثير لا نرى حاجة لاستقصائه.
(31) حسبما صرح به أحمد بن حنبل في رسالة «السنة» وهي عقايد أهل الحديث، والسنة. وقد أوردها أبو يعلى في طبقات الحنابلة ج 1 ص 26. وصرح بذلك أيضاً الأشعري في مقالات الإسلاميين ج 1 ص 323، وفي الإبانة ص 9. وقد علل ذلك في نظرية الإمامة ص 417 بقوله: «.. ذلك أنها: إن كانت بلوى من الله عقابا لهم، فما ثورتهم برادة عقاب الله. وإن كانت محنة للمسلمين، فما هم برادي قضاء الله»!. وفي كتاب السنة قبل التدوين ص 467، نقل عن ابن خزيمة، في وصفه الطاعنين على أبي هريرة، قوله: إنهم إما معطل جهمي.. «وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد، أو قدري، اعتزل الإسلام، وأهله الخ.».
(32) راجع: البحار ج 49 من ص 91 حتى 95، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 181 فما بعدها: وهو كلام معروف لا نرى أننا بحاجة لتكثير مصادره هنا.
(33) البحار ج 49 ص 95، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 183.
(34) وذلك يدل على مدى تعاطف الناس مع أهل البيت، ومحبتهم لهم. الأمر الذي كان يرعب المأمون ويخيفه. حتى لقد كان يحاول كبت عواطف الناس هذه، وهذا هو السبب في منع الإمام من المرور عن طريق الكوفة وقم، كما سيأتي.
(35) قد ذكرنا بعض مصادر هذه القضية في فصل: «شخصية الإمام الرضا» فمن أراد فليراجع.
(36) ويلاحظ: أن هذه الكلمة قد صيغت بنحو لا بد معه من الرجوع إلى الكلمة الأولى، ومعرفتها.
وبعد.. فما أشبه موقفه (عليه السلام) هنا بموقف النبي (صلى الله عليه وآله) في غدير خم، حيث إنه (صلى الله عليه وآله) كان أيضاً قد أبلغ المسلمين مسألة الولاية، في ذلك الموقف الحاشد، وفي المكان الذي لا بد فيه من تفرق الناس عنه (صلى الله عليه وآله)، وذهاب كل منهم إلى بلده، ولعل إرجاع المتقدمين، وحبس المتأخرين يشبهها إخراج الإمام (عليه السلام) رأسه من العمارية..
يضاف إلى ذلك: أن موقفه (صلى الله عليه وآله) كان آخر مواقفه العامة في حياته إلى آخر ما هنالك من وجوه الشبه بين الواقعتين.
ولعلنا نجد تشابهاً بين هذه الواقعة، وبين قضية إرجاع أبي بكر عن تبليغ آيات سورة براءة، ثم إرسال علي مكانه..
(37) قد استرشدنا في بعض ما ذكرناه بما ذكره الأستاذ علي غفوري، في كتابه: «ياد بود هشتمين امام» [فارسي].
(38) تاريخ الخلفاء ص 120، وغيره.
(39) تاريخ الخلفاء ص 119، 120، والمحاسن والمساوي ج 1 ص 79 طبع مصر. والفتوحات الإسلامية لدحلان ط مصطفى محمد ج 2 ص 368.
(40) فقد قال بعد أن ضرب الوليد بن عقبة الحد، لشربه الخمر: «لتدعوني قريش بعد هذا جلادها». الغدير ج 8 ص 121. وقد صدقت نبوءته، صلوات الله وسلامه عليه، فقد جعلوه ـ كما ترى ـ ضرابا للحدود بين يدي الثلاثة!!.
(41) الملل والنحل، ج 1 ص 24، وقال الخضري في محاضراته ج 1 ص 167: «.. والخلاصة: أن مسألة الخلافة الإسلامية والاستخلاف، لم تسر مع الزمن في طريق يؤمن فيه العثار. بل كان تركها على ما هي عليه، من غير محل محدد ترضاه الأمة، وتدفع عنه سبباً لأكثر الحوادث التي أصابت المسلمين، وأوجدت ما سيرد عليكم من أنواع الشقاق والحروب المتواصلة، التي قلما يخلو منها زمن، سواء كان ذلك بين بيتين، أو بين شخصين.» انتهى.
وأقول: إذن. كيف جاز للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يترك الأمة هكذا هملا، ثم لا يضع حلاً لأعظم مشكلة تواجهه، مع أن شريعته كاملة وشاملة، وقد بين فيها كل ما تحتاجه الأمة، حتى أرش الخدش.
(42) راجع: الصواعق المحرقة، وينابيع المودة، ووفيات الأعيان، والبحار، وقاموس الرجال، وغير ذلك.
(43) البداية والنهاية ج 10 ص 183، والكامل لابن الأثير ج 6، ص 164 ط صادر، والصواعق المحرقة ص 122، والإتحاف بحب الأشراف ص 55، ومرآة الجنان ج 1 وأعيان الشيعة، وينابيع المودة، وغير ذلك.
(44) الإتحاف بحب الأشراف ص 55، والصواعق المحرقة ص 122.
(45) المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 339، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 213.
(46) راجع: البحار ج 49، وروضة الكافي: وعيون أخبار الرضا، وإرشاد المفيد، وغير ذلك.
(47) البحار ج 49 ص 140، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 15.
(48) راجع: المناقب ج 4 ص 369، 364 والبحار ج 49 ص 14 4. وعلل الشرايع، ومقاتل الطالبيين، ونور الأبصار، ونزهة الجليس، وعيون أخبار الرضا.
(49) راجع: على سبيل المثال: شرح ميمية أبي فراس ص 204.
(50) كنز الفوائد للكراجكي ص 166، والفصول المختارة من العيون والمحاسن ص 15، 16، والبحار ج 49 ص 188، ومسند الإمام الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 100.
(51) راجع: عيون الأخبار ج 2 ص 140، 141، طبع مصر سنة 1346، والعقد الفريد ج 5 ص 102، و ج 2 ص 386، طبع دار الكتاب العربي..
(52) وكان آخرهم الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه: نظرية الإمامة ص 388، وقال: إنها من المخطوطات الموجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم 1258.
(53) مروج الذهب ج 4 ص 21.
(54) مقدمة ابن خلدون ص 197 ر 198.
(55) مقتل الحسين للمقرم ص 119، والأغاني ج 9 ص 45، طبع ساسي، والأدب في ظل التشيع ص 201، وضحى الإسلام ج 3 ص 313، وقاموس الرجال ج 2 ص 393، وغير ذلك.
(56) الأوراق للصولي ص 180، وقد تقدم شطر منها في بعض فصول هذا الكتاب.
(57) يونس آية 35.
(58) الكافي ص 187، وأمالي المفيد ص 148 ط النجف وأمالي الطوسي ج 1 ص 21، ومسند الإمام الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 96.
(59) الكافي: ج 1 ص 187، والاختصاص 278، ومسند الإمام الرضا ج 1 ص 103 عنه.
(60) ومن المحتمل جداً أنه (عليه السلام): يشير إلى تعبير عمر ـ كانت بيعة أبي بكر فلتة إلخ ـ ولكنه عمم الكلام بحيث يشمل غير بيعة أبي بكر أيضاً، باعتبار أن بيعة عمر وعثمان، ومعاوية وغيرها، كانت أيضاً من الفلتات، أو باعتبار تفرعها على بيعة أبي بكر التي كانت فلتة..
(61) راجع شرح النهج للمعتزلي ج 1 ص 307، 308 وغير ذلك.
(62) راجع: كتاب مكاتيب الرسول ج 1 من ص 59 حتى ص 89، فقد أسهب القول حول هذه الكتب، واستشهادات الأئمة بها، وغير ذلك.
(63) مآثر الإنافة ج 2 ص 332.
(64) الفصول المهمة، لابن الصباغ المالكي ص 241، ونور الأبصار من ص 143، وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 20، و ج 2 ص 183، ومواضع أخرى، ومناقب آل أبي طالب ج 4 ص 363، وعلل الشرايع ج 1، ص 238، وإعلام الورى ص 320، والبحار ج 49 ص 34 و 35، وغيرها، وكشف الغمة ج 3 ص 69، وإرشاد المفيد ص 310، وأمالي الصدوق ص 43، وأصول الكافي ص 489، وروضة الواعظين ج 1 ص 268، 269، ومعادن الحكمة ص 180، وشرح ميمية أبي فراس ص 165.
(65) قد ذكرنا بعض مصادر هذه الرواية في فصل: ظروف البيعة.. فراجع..
(66) مناقب آل أبي طالب. لابن شهرآشوب ج 4 ص 372، ولكن هذا الشعر ينسب أيضاً للبحتري في المتوكل عندما خرج لصلاة العيد.. وانتحال الشعر، وكذلك الاستشهاد بشعر الآخرين، في المواضع المناسبة ظاهرة شائعة في تلك الفترة ومن يدري فلعل الشعر للبحتري ونسب للبحري أو لعله للبحري وانتحله أو نسب للبحتري، ولعل البحتري قد صحف وصار: البحري.. ولعل العكس.
(67) كلام إبراهيم بن العباس هذا معروف ومشهور، تجده في كثير من كتب التاريخ والرواية، ولذا فلا نرى أننا بحاجة إلى تعداد مصادره.
(68) البحار ج 49 ص 101، والكافي الكليني، ومسند الإمام الرضا ج 1 قسم 1 ص 46.
(69) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 236، ومسند الإمام الرضا ج 1 قسم 1 ص 46.
(70) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 237.
(71) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 236. ومسند الإمام الرضا ج 1 قسم 1 ص 46.