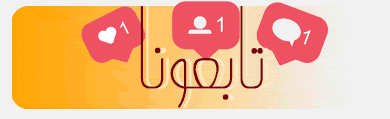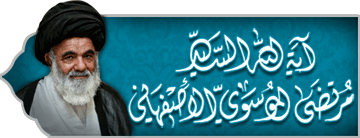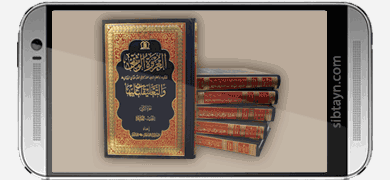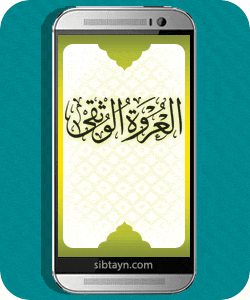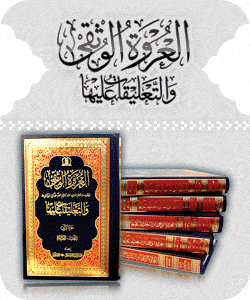عمر النبي صلى الله عليه وآله حين البعثة:
لقد بعث الله تعالى محمداً >صلى الله عليه وآله< رسولاً للناس أجمعين بعد عام الفيل بأربعين عاماً، أي حينما بلغ الأربعين من عمره الشريف، على قول أكثر أهل السير، والعلم بالأثر، وكان قبل ذلك يسمع الصوت ولا يرى الشخص حتى تراءى له جبرائيل وهو في سن الأربعين.
وقيل: بل كان عمره >صلى الله عليه وآله< حين بعثته اثنين، وقيل: ثلاثاً، وقيل: خمساً وأربعين سنة([1]).
وربما لا يكون بين هذه الأقوال منافاة إذا كان القائلون بها يأخذ بعضهم، وبعضهم الآخـر لا يأخذ السنوات الأولى، وهي فترة الـدعوة الاختيارية، أو فقل: السرية بنظر الاعتبار والتي قد اختلف في مقدارها من ثلاث إلى خمس سنوات([2]).
أو لعل بعضهم لم يكن يرى أن النبي >صلى الله عليه وآله< مرسل في تلك الفترة إلى الناس كافة، أو أنه كان مكلفاً بدعوة الأقربين فقط.
كما أن ذلك لعله هو سبب الاختلاف الظاهري في مدة بقاء النبي >صلى الله عليه وآله< في مكة داعياً إلى الله فيها قبل الهجرة، حيث قال بعضهم إنه: >صلى الله عليه وآله< بقي عشر سنين، وقال آخرون: ثلاث عشرة سنة.
تاريخ البعثة، وكيفية نزول القرآن:
والمروي عن أهل البيت >عليهم السلام< ـ وأهل البيت أدرى بما فيه وأقرب إلى معرفة شؤون النبي >صلى الله عليه وآله< الخاصة ـ: أن بعثة النبي >صلى الله عليه وآله< كانت في السابع والعشرين من شهر رجب وهذا هو المشهور، بل ادعى المجلسي الإجماع عليه عند الشيعة، وروي عن غيرهم أيضاً([3]).
وقيل: إنه >صلى الله عليه وآله< بعث في شهر رمضان المبارك، واختلفوا في أي يوم منه([4]) وقيل في شهر ربيع الأول، واختلف أيضاً في أي يوم منه([5]).
واستدل القائلون: بأنه >صلى الله عليه وآله< قد بعث في شهر رمضان المبارك، وليس في رجب بأن النبي >صلى الله عليه وآله< إنما بعث بالقرآن، والقرآن قد أنزل في شهر رمضان، قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}([6])، وقال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}([7]).
ثم إن هنا إشكالاً آخر لا بد من الإشارة إليه، وحاصله:
أن الآيتين المتقدمتين، وإن كانتا تدلان على نزول القرآن دفعة واحدة على أحد الاحتمالين في معنى الآيتين، إلا أن قوله تعالى: {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً}([8]) يدل على نزول القرآن متفرقاً، لأنه عبَّر فيها بـ (نزل)، الدال على النزول التدريجي، وفيما تقدم عبر بأنزل، الدال على النزول الدفعي ثم هو يقول فيها: {فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ}([9]).
يضاف إلى ذلك قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً}([10]) حيث دلت الآية على نزول القرآن تدريجاً.
وأيضاً، يجب أن لا ننسى هنا: أن بعض الآيات مرتبط بحوادث آنية، مقيدة بالزمان، كقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}([11]) وكاعتراض الكفار الآنف على رسول الله >صلى الله عليه وآله< وغير ذلك.
هذا كله عدا عن أن التاريخ المتواتر يشهد بأن نزول القرآن كان تدريجاً، في مدة ثلاث وعشرين سنة، وهي مدة الدعوة.
وقد أجيب عن إشكال التنافي بين ما دل على النزول الدفعي والنزول التدريجي؛ بأن النزول الدفعي كان إلى البيت المعمور؛ حسبما نطقت به الروايات الكثيرة، ثم صار ينزل تدريجاً على الرسول الأعظم >صلى الله عليه وآله<([12]).
وإذن، فليكن نزوله الدفعي كان في ليلة القدر ونزوله التدريجي قد بدأ في السابع والعشرين من شهر رجب، ويرتفع الإشكال بذلك.
وجواب آخر، يعتمد على القول بأن القرآن قد نزل أولاً دفعة واحدة على قلب النبي الأعظم >صلى الله عليه وآله<، لكنه لم يؤمر بتبليغه، ثم صار ينزل تدريجاً بحسب المناسبات.
وربما يستأنس لهذا الرأي ببعض الشواهد التي لا مجال لها([13]).
ورأي ثالث يقول: إن بدء نزول القرآن كان بعد البعثة بثلاث سنوات، أي بعد انتهاء الفترة السرية للدعوة، كما ورد في عدد من الروايات، ونص عليه بعضهم([14])، وعلى هذا فلا يبقى تناف بين بعثته >صلى الله عليه وآله< في شهر رجب، وبين نزول القرآن في شهر رمضان المبارك([15]).
أما نحن فنقول:
أولاً: قال الله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً}([16]) فاستعمل التنزيل وأريد بـه النزول جملة واحدة؛ فقولهم: >تستعمل نزل في خصوص التدريجي< لا يصح.
إلا أن يقال: إن المراد التنزيل التدريجي للقرآن كله، من سماء إلى سماء، أو من مرتبة إلى مرتبة، حتى وصل إلى رسول الله >صلى الله عليه وآله<.
ولكن هذا خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا بدليل.
وقد يقال: إن الدليل موجود، وهو الروايات التي تقول:
نزل إلى البيت المعمور، ثم إلى السماء الدنيا، ثم على قلب رسول الله >صلى الله عليه وآله< كما في قوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ}([17]).
ثانياً: إن تتبع الآيات القرآنية يعطي عدم ثبوت الفرق المذكور بين: >الإنزال< و >التنزيل< مثلاً قد ورد في القرآن قوله تعالى: {وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ}([18]) مع أن الكتاب المقروء إنما ينزل دفعة واحدة، ويمكن أن يجاب عنه بما قدمناه آنفاً.
كما ويلاحظ: أنه يستعمل كلمة >نَزَّلَ< تارة، وكلمة >أَنزَلَ< {مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُوراً}([19]).
ومثل ذلك كثير، لا مجال لنا لتتبعه فعلاً، وكله يدل على عدم صحة هذا الفرق بين هاتين الصيغتين وقد أشار إلى هذا الجواب بعض المحققين أيضاً([20]).
غير أننا نقول في جوابه: إن هناك حيثيتين لنزول الماء من السماء.
فإذا لوحظت حيثية نزوله متفرقاً على شكل مطر فإنه يعبر بكلمة نزل، الدالة على التدرج.
وإذا لوحظ مجموع ما نزل من ماء طاهر عبر بأنزل، حيث لا يريد الإلماح إلى طريقة النزول، بل المراد الحديث عن النازل..
ثالثاً: قولهم: إن النبي >صلى الله عليه وآله< قد بعث بالقرآن غير مسلم، ولتكن الروايات الواردة عن أهل البيت، والقائلة بأنه >صلى الله عليه وآله< قد بعث في شهر رجب موجبة لوهن قولهم هذا.
فإن البعثة تتحقق بنزول جبرئيل ببلاغ عن الله تعالى، سواء أكان البلاغ آية، أم كان أوامر من أي نوع كانت.
رابعاً: يقول الشيخ المفيد >رحمه الله<: إن روايات نزول القرآن إلى البيت المعمور لا مجال لإثباتها من طريق أهل البيت >عليهم السلام<، ولا إلى الاطمينان إلى صحتها([21]).
وأما نزول القرآن أولاً دفعة واحدة على قلبه >صلى الله عليه وآله<، فإن إثباته مشكل، ولا يمكن المصير إليه إلا بحجة.
ولكن عدم القدرة على إثبات ذلك بصورة قاطعة لا يعني أنه غير واقع أصلاً، وهذا كاف في زوال الإشكال، ولزوم القبول بما ورد عن أهل البيت >عليهم السلام< من أن البعثة كانت في شهر رجب، فلعل للقرآن نزولات متعددة، باختلاف ما يقتضي ذلك.
خامساً: حديث نزول القرآن بعد البعثة بثلاث سنوات، استناداً إلى ما ورد من أن القرآن قد نزل خلال عشرين سنة، لا يمكن الاطمينان إليه، إذ يمكن أن يكون ذلك قد جاء على نحو التقريب والتسامح، ولم يرد في مقام التحديد الدقيق ـ ومن عادة الناس:
أن يسقطوا الزائد القليل، أو أن يضيفوه في إخباراتهم، وليس في ذلك أخبار بخلاف الواقع؛ لأن المقصود هو الإخبار بما هو قريب من الحد، لا بالحد نفسه، مع إدارك السامع لذلك، والتفاته إليه.
نعم، يمكن أن تكون معاني القرآن وحقائقه قد نزلت على قلبه الشريف لكي يستفيد منها الرسول >صلى الله عليه وآله< في نيل مقامات القرب منه تعالى.
والنتيجة هي: أنه لا مانع من أن يكون >صلى الله عليه وآله< قد بعث وصار رسولاً في شهر رجب، كما أخبر به أهل البيت >عليهم السلام< وهيئ ليتلقى الوحي القرآني.
{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً}([22])، ثم بدأ نزول القرآن عليه تدريجاً في شهر رمضان المبارك.
كما أنه لا مانع من أن تكون حقائق القرآن ومعانيه قد نزلت عليه >صلى الله عليه وآله< دفعة واحدة، ثم صار ينزل عليه تدريجاً.
ويؤيد هذا الاحتمال الأخير رواية رواها المفضل عن الإمام الصادق >عليه السلام< تفيد ذلك فلتراجع([23]) ويؤيده أيضاً:
ما ورد من أنه كان له ملك يسدده، ويأمره بمحاسن الأخلاق، وأن الملك كان يتراءى له، قبل أن ينزل عليه القرآن([24]) وأن جبرئيل قد لقيه إلخ..
ويرى بعض المحققين([25]): أنه يمكن الجمع بين الآيات، بأن يقال:
إن شروع نزول القرآن كان في ليلة مباركة، هي ليلة القدر من شهر رمضان، {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}([26])، {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}([27]). وكان أول ما نزل حسب روايات أهل البيت >عليهم السلام<، {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}([28]).
لا يصح الاستدلال بهذه الآيات: على أن القرآن نزل أولاً دفعة إلى البيت المعمور أو على قلب النبي، ثم صار ينزل تدريجاً طيلة أيام البعثة، وذلك إعتماداً على قرينة الحال، وهي رؤية الناس نزوله تدريجاً.
نعم، لا يصح هذا الاستدلال، لإمكان أن يكون المراد بالإنـزال والتنزيل واحد، وهو بدء النزول، فإنه إذا شرع نزول المطر في اليوم الفلاني، واستمر لعدة أيام، فيصح أن يقال مثلاً:
سافـرت يوم أمطرت السماء، أي في اليوم الأول من بدء نزوله، وكذلك الحال بالنسبة للقرآن، فإنه إذا بدأ نزوله في شهر رمضان، في ليلة القدر، فيصح أن يقال مجازاً مع وجود القرينة، وهي النزول التدريجي: نزل القرآن في شهر رمضان، ويكون المراد أنه قد بدأ نزوله التدريجي فيه.
وقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} محتف بقرينة حالية؛ يعلمها كل أحد، وهي نزول خصوص أول سورة >إقرأ<، واستمر ينزل تدريجاً بعد ذلك، وكل حادث خطير له امتداد زمني إنما يسجل يوم شروعه.
وأما حديث البخاري في بدء الوحي والدال على اقتران نزول القرآن بالنبوة فسيأتي أنه باطل لا يصح.
ثم إنه يمكن تقريب كلام هذا المحقق بأن يقال: إن قوله تعالى: {أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إنما هو حكاية عن أمر سابق، ولا يشمل هذا الكلام الحاكي له إلا بضرب من العناية والتجوز، ولا الذي يأتي بعده، وإلا لجاء التعبير بصيغة المضارع، أو الوصف فإنه يكون حينئذٍ هو الأوفق([29]).
ولعل ابن شهر آشوب كان ينظر إلى هذا حين قال في متشابهات القرآن:
>والصحيح: أن القرآن في هذا الوضع لا يفيد العموم، وإنما يفيد الجنس، فأي شيء نزل فيه؛ فقد طابق الظاهر<([30]).
هذا.. ولكن ما قدمناه يوضح: أن الالتزام بهذا التوجيه ليس ضرورياً، ونعود فنذكر القارئ الكريم بأنه قد ورد ما يؤيد نزول القرآن دفعة واحدة أولاً، ثم صار ينزل تدريجاً بعد ذلك؛ فقد روي عن الإمام الصادق >عليه السلام< قوله: >يا مفضل، إن القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة، والله يقول: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}.
وقال: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ}([31]).
وقال: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ}([32]).
قال المفضل: يا مولاي فهذا تنزيله الذي ذكره الله في كتابه، وكيف ظهر الوحي في ثلاث وعشرين سنة؟
قال: نعم يا مفضل، أعطاه الله القرآن في شهر رمضان وكان لا يبلغه إلا في وقت استحقاق الخطاب، ولا يؤديه إلا في وقت أمر ونهي، فيهبط جبرائيل بالوحي، فيبلغ ما يؤمر به وقوله: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}([33])<([34]).
وقد قلنا فيما سبق: إن للقرآن عدة نزولات، نزول إلى البيت المعمور، ونزول إلى السماء الدنيا، ثم نزول على قلب رسول الله >صلى الله عليه وآله< في رمضان.. ثم صار ينزل سورة سورة، ثم صارت تنزل الآيات في المناسبات المختلفة، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا مختصر مفيد حين الكلام حول نزول آية بلغ ما أنزل إليك من ربك، وآية اليوم أكملت([35])..
بدء الوحي وأول ما أنزل:
لقد كان بدء الوحي في غار حراء، وهو جبل على ثلاثة أميال من مكة ويقال:
هو جبل فاران، الذي ورد ذكره في التوراة إلا إن الظاهر هو أن فاران اسم لجبال مكة، كما صرح به ياقوت الحموي، حسبما تقدم، لا لخصوص حراء.
وكان >صلى الله عليه وآله< يتعبد في حراء هذا، على النحو الذي ثبتت له مشروعيته، وكان قبل ذلك يتعبد فيه عبد المطلب.
وأول ما نزل عليه >صلى الله عليه وآله< هو قوله تعالى: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}([36]).
وهذا هو المروي عن أهل البيت >عليهم السلام<([37])، وروي أيضاً عن غيرهم بكثرة، ويدل عليه أيضاً سياق الآيات المذكورة.([38])
وربما يقال: إن أول ما نزل عليه >صلى الله عليه وآله< هو فاتحة الكتاب([39])، ولا سيما بملاحظة:
أنه قد صلى في اليوم الثاني هو >صلى الله عليه وآله< وعلي >عليه السلام<، وخديجة >عليها السلام<، حسبما ورد في الروايات.
ولكن من الواضح: أن ذلك لا يثبت شيئاً؛ إذ يمكن أن تنزل الفاتحة بعد سورة إقرأ، بلا فصل، ثم يصلي ويقرؤها في صلاته، كما أن من الممكن أن تكون صلاتهم آنئذٍ غير مشتملة على فاتحة الكتاب، ثم وجبت بعد ذلك وإن كان لم يذكر أحد ذلك.
أما قوله: عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب: لا صلاة له([40]) وقوله >صلى الله عليه وآله<: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج([41]).
فهو لا ينافي ذلك إذ يمكن أن يكون ذلك تشريعاً حادثاً بعد ذلك.
هذا كله عدا عن أنهم يروون: أن سورة الفاتحة قد نزلت بعد المدثر([42]) أي بعد عدة سنوات من البعثة.
هذا، وثمة قول آخر، وهو أن أول ما نزل عليه >صلى الله عليه وآله< هو سورة المدثر([43])، وستأتي الإشارة إلى أنها قد نزلت بعد المرحلة الاختيارية أو فقل: السرية، كما أنهم يروون روايات عديدة تنافي قولهم هذا([44]).
وعلى كل حال، فإن تحقيق هذا الأمر لا يهمنا كثيراً، فلا بد من توفير الفرصة للحديث عن الأهم فالأهم.
ولا بأس بأن نعطف الكلام هنا إلى الحديث عن معجزته >صلى الله عليه وآله<، وهي:
القرآن، وسر إعجازه، فإن ذلك ربما تكون له أهميته البالغة لمن يريد أن يقرأ سيرة النبي >صلى الله عليه وآله<، ويستفيد منها: عقيدة، وشريعة، وأدباً، وسلوكاً.
مع العلم بأن كثيراً من الأحداث قد جاءت مرتبطة بالقرآن، وكانت سبباً في نزول طائفة من آياته ولا بد من الاستدلال به عليها، فنقول:
إعجاز القرآن:
لقد تحدى الله أعداء الإسلام بأن يأتوا بمثل القرآن، فلما عجزوا تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن، فعجزوا عن ذلك أيضاً، ثم صعَّد تحديه لهم، وطلب منهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فلو أنهم استطاعوا أن يأتوا ولو بقدر سورة الكوثر، التي هي سطر واحد، لثبت بطلان هذا الدين الجديد من أساسه، ما دام أنه هو قد قبل بهذا التحدي مسبقاً، ولكانوا قد وفروا على أنفسهم الكثير من الويلات، التي أقدموا عليها بإعلانهم الحرب على النبي الأعظم >صلى الله عليه وآله<، والتي أدت إلى إزهاق النفوس الكثيرة، وهدر الطاقات العظيمة، وغير ذلك من مصائب وكوارث، انتهت بهزيمتهم، وانتصار الإسلام وقائده الأعظم >صلى الله عليه وآله<.
فما هي تلك الخصيصة التي في القرآن، والتي جعلتهم يعجزون عن مجاراته، وحتى عن أن يأتوا ب {بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ}؟!([45]).
بل ما هي تلك الخصيصة التي سوغت التحدي بالقرآن للإنس والجن معاً دون اختصاص بزمان دون زمان، قال تعالى:
{قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً}([46]).
ربما يقال: إنها إخباراته الغيبية الصادقة، سواء بالنسبة إلى الماضين كقوله تعالى:
{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا}([47]).
أو بالنسبة لتنبؤاته المستقبلية، كقوله تعالى:
{الم، غُلِبَتِ الرُّومُ، فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ}([48]). وكإخباره بنتائج حرب بدر العظمى، وغير ذلك([49]).
وربما يقال: إنه لتضمن القرآن للمعارف العلمية، التي تنسجم مع العقل والبرهان، وإخباراته عن سنن الكون وأسرار الخليقة، وأحوال النظام الكوني، وغير ذلك من أمور لا يمكن الوصول إليها إلا بالعلم والمعرفة الشاملة والواسعة، الأمر الذي لم يكن متوفراً في البيئة التي عاش فيها النبي >صلى الله عليه وآله< كقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ}([50]) وغير ذلك من الآيـات التي تشير إلى دقائق وحقائق علمية في مختلف العلوم والفنون.
وربما يقال: إن إعجازه إنما هو في نظامه التشريعي الذي جاء به، والذي لا يمكن لرجل عاش في بيئة كالبيئة التي عاش فيها الرسول الأعظم >صلى الله عليه وآله< وعانى من الظروف والأحوال الاجتماعية، ومستوى الثقافة في ذلك العصر، أن يأتي بمثل ذلك مهما كان عظيماً في فكره، وذكائه، وسعة أفقه.
ولربما نجد الإشارة إلى هذين الرأيين في قوله تعالى:
{قُل لَّوْ شَاء اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}([51]).
وأخيراً، فلربما يقال: إن إعجاز القرآن هو في عدم وجود الاختلاف فيه، ولذلك ترى أنه قد تحداهم بذلك فقال:
{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}([52]).
وثمة إشارات أخرى لجزئيات ربما يدخل أكثرها فيما قدمناه.. ولعل فيما ذكرناه كفاية.
وثمة قول آخر، أكثر شيوعاً ومعروفية ولا سيما بين القدماء، وهو إعجاز القرآن في الفصاحة والبلاغة، وقد كتبوا في هذا الموضوع الشيء الكثير قديماً وحديثاً.
أما نحن فنقول: إن هذا الأخير هو السر الأعظم في إعجاز القرآن الكريم حقاً، وهو يستبطن سائر الجوانب الإعجازية المذكورة آنفاً وغيرها مما لم نذكره([53]).
لماذا الأخير فقط؟!
وأما لماذا هذا الأخير فقط دون سواه؟! فإن ذلك واضح، حيث إننا نقصد ب >البلاغة< معنى أوسع مما يقصده علماء المعاني والبيان، وهذا المعنى يستبطن جميع وجوه الإعجاز وينطبق عليها، وبيان ذلك يحتاج إلى شيء من البسط في البيان فنقول:
إنه إذا كان الرسول >صلى الله عليه وآله< قد أرسل للناس كافة فلا بد أن تكون معجزته بحيث يستطيع كل من واجهها:
أن يدرك إعجازها، وأنها أمر خارق للعادة وأنها صادرة عن قدرة عليا، وقوة قاهرة، تهيمن على النواميس الطبيعية، وتقهرها، وإلا فإنه إذا جاء شخص مثلاً إلى بلد، وادَّعى أنه يعرف اللغة الفلانية، ولم يكن أحد في البلد يعرف شيئاً من تلك اللغة، ولا سمع بها، فإنهم لا يستطيعون أن يحكموا بصدقه ولا بكذبه، إذ ليس لهم طريق لإثبات هذا الصدق أو الكذب.
وأما إذا ادَّعى أمراً لهم خبرة فيه، واستطاعوا أن يتلمسوا فيه مواقع خرقه للنواميس الطبيعية فلا بد لهم من التسليم له والقبول بدعوته؛ لأن ذلك يكون قاطعاً لعذرهم، وموجباً لخضوع عقولهم لما يأتي به.
وبكلمة موجزة نقول: لا بد أن تكون معجزة النبي في كل عصر متناسبة مع خبرات ذلك العصر، ولكل من أرسل إليهم؛ ليمكن إثبات إعجازها لهم، وإقامة الحجة عليهم.
وإذا كان القرآن قد تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فلا بد أن يكون وجه الإعجاز فيه سارياً ليصل حتى إلى أصغر سورة فيه.
وإذا نظرنا إلى ما ذكروه آنفاً، فإننا نجد أن بعض السور لا تشتمل على شيء مما ذكروه، مع أن التحدي به وارد.
أضف إلى ذلك: أن الإخبار بالغيب مثلاً لا يمكن أن يكون قاطعاً لعذر من ألقي إليهم إلا بعد تحقق المخبر عنه، وقد يطول ذلك إلى سنوات عديدة، أما من يأتون بعد ذلك فلربما يصعب عليهم الجزم بتحقق ما أخبر به.
أما القضايا العلمية، فلربما لا يكون من بينهم من له الخبرات اللازمة في تلك العلوم؛ ليمكن إدراك الإعجاز فيها؛ فإن ذلك رهن بتقدم العلم، وتمكن العلماء من استجلاء تلك الحقائق من القرآن.
وحتى لو أدرك ذلك بعضهم، فلربما يحمله اللجاج، أو غير ذلك من مصالحه الشخصية (بنظره) على إنكار ذلك وإخفائه.
كما كان الحال بالنسبة إلى أهل الكتاب، الذين كانوا يعرفون النبي >صلى الله عليه وآله< كما يعرفون أبناءهم، ويجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، ولكن الأحبار والرهبان أخفوا ذلك وأنكروه لمصالح شخصية، أو لغير ذلك، مما وجدوا فيه مبرراً للإقدام على خداع أنفسهم، وخداع غيرهم، وهكذا يقال بالنسبة للإعجاز التشريعي، وغير ذلك من أمور.
ويبقى سؤال:
ما هو وجه الإعجاز في القرآن إذاً؟
وفي مقام الإجابة على هذا السؤال نقول:
بلاغة القرآن:
قبل كل شيء ينبغي التذكير بأن ما ذكرناه آنفاً، لا يعني أن الإخبار بالغيب، وغير ذلك مما ذكرناه، ومما لم نذكره، غير موجود في القرآن، بل هو موجود فيه بأجلى مظاهره وأعظمها، وهي معجزات أيضاً لكل أحد، ولكننا نقول:
إن ذلك ليس هو الملاك الأول والأخير لإعجاز القرآن، وإنما ملاك الإعجاز فيه هو أمر يستطيع كل أحد أن يدركه، وأن يفهمه، وهو أمر تشتمل عليه حتى السورة التي لا تزيد على السطر الواحد، كسورة الكوثر مثلاً. وهو أيضاً أمر يجده كل أحد، مهما كان تخصصه، ومهما كـان مستواه الفكري، وأياً كان نوع ثقافته، وفي أي عصر، وفي أي ظرف، وهو كذلك أمر يشمل كل ما تقدم وسواه مما لم نذكره، ويضمه تحت جناحيه؛ وذلك الأمر هو:
البلاغة:
فأما أن ما تقدم يرجع: إلى البلاغة؛ فلأن حقيقة البلاغة ـ كما عرفوها ـ هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أو للاعتبار المناسب، والقرآن مطابق لمقتضى الحال دائماً وفي كل زمان، وإلى الا بد ومع كل شخص؛ لأنه خطاب لهم جميعاً، ومعجز لهم جميعاً؛ فحين يخبر عن الغيب، فإنما اقتضى الحال ذلك. وكذلك حين يكشف عن أسرار الكون، وخفايا الطبيعة، ويشير إلى بعض الحقائق العلمية، وكذلك أيضاً حين يضع أعظم تشريع، وأروع نظام عرفته الإنسانية، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره وما لم نذكره.
بل أن تكون ظروف نشأة الرسول الأعظم هي تلك، فإن ذلك له أهمية كبرى في قبول الدعوة، والإذعان لها، وكذلك فإن الكلام الذي يختلف صدره وذيـلـه، أو يختلف من وقت لآخر، مع كون الهدف واحداً، والمخاطب والمتكلم واحداً، لا يمكن أن يكون بليغاً، ولا مطابقاً لمقتضى الحال، كما يقولون.
الإعجاز بالبلاغة كيف؟ ولماذا؟!
وأما كيف عجزت الإنس والجن عن مجاراة هذا القرآن؟ وكيف أمكن اعتبار البلاغة القرآنية هي سر الإعجاز فيه؟ فإن ذلك يحتاج إلى توسع في القول، وبسط في البيان، فنقول:
إن لدلالة الكلام على المعنى في مقام التفهم والتفهيم شروطاً:
منها: أن يكون اللفظ الذي يلقيه المتكلم قادراً على تحمل المعنى المطلوب، بأي نحو من أنحاء التحمل، سواء من حيث مفردات الجملة، أو من حيث نوعية تركيبها، أو من جهة المقايسة بينها وبين غيرها.
ومنها: أن يكون المستوى الفكري والثقافي للمتكلم بحيث يستطيع أن يقصد تلك المعاني التي يقدر اللفظ على تحملها.
ومنها: أن يكون ذلك المعنى منسجماً أيضاً مع نوعية اختصاص ذلك المتكلم، ومع مراميه وأهدافه.
ومنها: قدرة المخاطب أو المخاطبين على استيعاب مقصود المتكلم، ولو على امتداد الزمن.
هذه هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في عملية التفهم والتفهيم بين كل متكلم ومخاطب.
ولكن ذلك يحتاج إلى توضيح وتطبيق بالنسبة لما نحن بصدده، فنقول:
التوضيح والتطبيق:
وفي مجال التوضيح والتطبيق نقول:
إن اللغة العربية بما لها من خصائص ومميزات أقدر اللغات إطلاقاً على تحمل المعاني، فنجد أنهم يذكرون للجملة المؤلفة من كلمتين فقط عشرات الخصائص والمميزات التي تشير كل منها إلى العديد من الآثار المحتملة، التي يمكن للفظ أن يتحملها بالنسبة للمعنى المدلول، فالمسند إليه مثلاً تارة يكون اسماً جامداً وأخرى مشتقاً، وتارة يكون ظاهراً، وأخرى مضمراً، مقدماً أو مؤخراً، محذوفاً أو مذكوراً، منكراً أو معرفاً، والتعريف لكل واحد منها له أنحاء، لكل منها آثار وإشارات لخصوصيات في المعنى.
وكذا الحال في جانب المسند، الذي تارة يكون فعلاً ـ بأقسامه الثلاثة ـ وأخرى اسماً، جامداً، أو مشتقاً، معرفاً أو منكراً، مقدماً أو مؤخراً، مذكوراً أو محذوفاً، إلى آخر ما هنالك، وكل واحدة من هذه لها آثار مختلفة ومتعددة يحتمل إرادتها أيضاً.
فمثلاً قد يكون ذكره للتحقير أو عكسه، أو للتبرك به، أو إيهام استلذاذه، أو للتنبيه على غباوة السامع، أو للتقرير، أو للإيضاح، إلى غير ذلك.
وقد يحذف للتعظيم، أو للتحقير، أو للاستغناء عنه، أو لإيقاع السامع في حيرة، إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله.
وكذا سائر الخصوصيات التي ذكرناها، وما لم نذكره أكثر بكثير.
هذا بالإضافة: إلى الاستـعارات، والكنايات، والتعريضات، والإشارات، وغير ذلك مما تكفل لبيانه علم المعاني والبيان والبديع.
حتى إنهم ليذكرون العديد من الامتيازات لقوله تعالى: {فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}([54]) على ما كان أبلغ كلام عند العرب، وهو قولهم: >القتل أنفى للقتل<.
ويكفي أن نشير: إلى أن جملة زيد قائم، إذا لوحظ المسند إليه فيها فإنه ظاهر، ومقدم، ومعرف بالعلمية، وكل من هذه الثلاثة يقع على حالات كثيرة، وكذا الحال بالنسبة للمسند وهو كلمة: قائم.
ثم لا بد من ملاحظة الهيئة التركيبية، وموقعها من غيرها، ومع ما لها من متعلقات.
وهكذا يتضح: أن الجملة الواحدة ربما تفيد معنى له العديد من الخصوصيات الهامة، فكيف إذا لوحظت تلك الجملة مع غيرها من الهيئات التركيبية الأخرى، ثم أريد استخلاص المعاني من المجموع؟
هذا كله، بالإضـافـة إلى لزوم معرفة أساليب العرب، وطرائق استعمالاتهم للكلام ومقاماتها، فإن ذلك يفيد كثيراً في الوقوف على معاني القرآن، وفهم مراميه.
وقد روي: أن بعضهم كان في مجلس الإمام السجاد >عليه السلام<؛ فقال له: يا ابن رسول الله، كيف يعاتب الله، ويوبخ هؤلاء الأخلاف على قبائح أتاها أسلافهم، وهو يقول: {لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟!([55]).
فقال زين العابدين >عليه السلام<: >إن القرآن نزل بلغة العرب، فهو يخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم؛ يقول الرجل التميمي، قد أغار قومه على بلد، وقتلوا من فيه: أغرتم على بلد كذا، وفعلتم كذا؟!
ويقول العربي: نحن فعلنا ببني فلان، ونحن سبينا آل فلان، ونحن خربنا بلد كذا، لا يريد أنهم باشروا ذلك، ولكن يريد هؤلاء بالعذل، وأولئك بالافتخار: أن قومهم فعلوا كذا.
وقول الله عز وجل هذه الآيات إنما هو توبيخ لأسلافهم، وتوبيخ العذل على هؤلاء الموجودين؛ لأن ذلك هو اللغة التي نزل بها القرآن؛ ولأن هؤلاء الأخلاف أيضاً راضون بما فعل أسلافهم، مصوبون لهم؛ فجاز أن يقال: أنتم فعلتم؛ إذ رضيتم قبح فعلهم<([56]).
ولا بد أيضاً من معرفة خصوصيات الألفاظ وأسرار اختياراتها لمواقعها، وقد روي: أنه لما نزل قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}([57]).
قال ابن الزبعرى: فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيراً، والنصارى تعبد عيسى >عليه السلام< فأخبر النبي >صلى الله عليه وآله< فقال: يا ويل أمه، أما علم إن >ما< لما لا يعقل و >من< لمن يعقل إلخ([58]).
هذا، ولقدرة اللغة العربية على تحمل المعاني الدقيقة والعميقة، نجد أن الله تعالى قد اختارها لتكون لغة القرآن، وقد نوه بذلك، ووجه إليه الأنظار والأفكار، ودعا إلى استخلاص المعاني الدقيقة من كتابه الكريم فقال: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}([59]) وقال: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيَّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}([60]) وقال: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ}([61]) إلى غير ذلك من الآيات، فلننظر بدقة إلى قوله: {لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} وإلى قوله: {لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} وإلى قوله: {مُّبِينٍ} فإنه كله يشير إلى ما ذكرنا.
وبالنسبة للمستوى الفكري، وهو الشرط الثاني نقول:
لو قال شخص عادي لا اطلاع له على شيء من العلوم: >كل شيء يحتاج إلى علة<، فإننا لا نفكر في مقصوده كثيراً، بل ينتقل ذهننا مباشرة إلى أن مراده هو المؤثر الظاهري في وجود الشيء؛ فإذا أراد شخص أن يقول:
لعله أراد العلة الغائية أو المادية، أو الصورية، أو قصد بالعلة السبب، أو العلة التامة ونحو ذلك.
فإننا نقول له فوراً: لا، إن كلامه لا يدل على ذلك ولا ينظر إليه، ولكن لو قال نفس هذه الكلمة ابن سينا مثلاً؛ فإننا لا بد أن نفكر لنعرف: هل أراد بالعلة واحداً مما تقدم أم لا؟.
وهل أراد بالشيء البسيط أم المركب؟!
وهل؟ وهل؟ إلى آخر ما هنالك من احتمالات يمكن لابن سينا أن يقصدها من كلمة كهذه.
وإذا كان القائل طبيباً مثلاً فإننا لا بد أن نفتش عن معان تتناسب مع اختصاصه ونوع ثقافته، وحتى أهدافه، فإن كل ذلك يؤثر تأثيراً كبيراً في تفهيم المعنى، ومعرفة نوعه ومستواه، حيث لا بد أن ينسجم مع تلك الأهداف، ويتلاءم مع المستوى الثقافي والفكري للمتكلم.
وأما إذا كان القائل يمتاز بسعة الأفق والشمولية، كأمير المؤمنين >عليه السلام<؛ فإننا لا بد أن نُعِد أنفسنا لطرح أي احتمال يتناسب مع شخصية ومستوى وثقافة وأهداف أمير المؤمنين >عليه السلام<، ولا بد أن نبحث الأعوام والسنين لنتمكن من التقرب ـ ولو بشكل محدود ـ إلى مراميه وأهدافه؛ لأن فهم جميع الخصوصيات التي يرمي إليها المتكلم لا يمكن إلا من قبل من يداني ذلك المتكلم في سعة الأفق، والشمولية، وعمق الفكر، والغوص في لجج الحقائق، وأين يمكن أن يوجد من هو مثل علي >عليه السلام< في مستواه العلمي الشامخ، سوى معلمه وأستاذه، النبي الأعظم >صلى الله عليه وآله<، ثم الأئمة >عليهم السلام< من ولده؟
ولعل إلى هذا يشير ما روي عنه >صلى الله عليه وآله<: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، ولا عرفني إلا الله وأنت، ولا عرفك إلا الله وأنا([62]).
وبعد هذا فقد أصبح من الواضح: أن الله سبحانه وتعالى، وهو محيط بالكائنات، ومهيمن على كل الموجودات، وليس لعلمه حد محدود، ولا لصفته نعت موجود، إذا اختار اللغـة العربية ليحملها بعض مراميه وأهدافه ـ وهي اللغة القادرة على التحمل بشكل مذهل وهائل، ولا تضارعها في ذلك أية لغة أخرى ـ فإن هذا الإنسان المحدود في ملكاته، وقدراته، وطاقاته النفسية، والفكرية، وغيرها، لا يمكنه حتى ولو بقي أبد الدهر، وحتى لو استعان بكل مخلوق وموجود، وسخر كل ما لديه من طاقات وإمكانات ـ لا يمكنه ـ أن يكتشف إلا القليل القليل من المعارف القرآنية، ولن يكون بإمكانه أن يأتي هو وكل من معه بمثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.
إذن، فلا بد أن نبقى ننتظر ـ باستمرار ـ أن يكتشف الإنسان كل جديد في هذا القرآن، تبعاً لتقدم معارفه، ونمو قدراته الفكرية والثقافية.
وهذا تاريخ القرآن عبر القرون والأجيال، خير شاهد ودليل على ما نقول؛ حيث إننا نلاحظ:
أن كل عصر يمتاز بتقدم علم أو علوم، ويتألق فيه نجمها، ويقوى سلطانها، ثم تعود تدريجاً لتتراجع أمام زحف علم أو علوم أخرى لتحتل هي بدورها أيضاً مكان الصدارة في البحث والعمق والتحقيق وهكذا، ولكن هذا القرآن العظيم يبقى هو المهيمن في العصور كلها على العلوم والعلماء جميعاً، ويدرك الكل أنه فوق مستواهم، ولا تبلغه عقولهم، ولا تناله قدراتهم، ويجدون فيه ما يوجب خضوعهم لعظمته، ويدركون أنه لا يزال فيه ما يعجزون عن إداركه، والإحاطة به، فضلاً عن مجاراته.
كما أنه مع اختلاف الثقافات، والاتجاهات، والمستويات على مر العصور؛ فإن الكل يجدون هذا القرآن مطابقا لمقتضى الحال دائماً ومنسجماً معه، وهذا هو الإعجاز حقاً!!
وخلاصة الأمر: هذه المئات من السنين تمر، والأجيال تأتي وتذهب، والإنسان لا يزال يكتشف المزيد من معارف القرآن، وأسراره، ومراميه، وكلما توصل إلى شيء، فإنه يجد أن هذا القرآن ليس فقط قد جاء بمعارف ومرام لا تتناسب مع عقلية وثقافة عصر نزوله ـ الأمر الذي يؤكد على أنه من عند الله تعالى ـ وإنما يتجاوز ذلك كله، ليثبت لكل أحد: أن أغواره لا تزال تحتضن المزيد من المعاني والأسرار، التي يرى هذا الإنسان نفسه عاجزاً عن الوصول إليها والحصول عليها.
وأكثر من ذلك، فلقد أصبح معروفاً: أن الإنسان كلما أعاد قراءة هذا القرآن؛ فإنه يجده جديداً عليه في معانيه ومراميه، وذلك بسبب اختلاف حالات وتوجهات الإنسان، ونوعية الصور الحاضرة آنياً لديه، والأجواء والحالات النفسية المهيمنة عليه.
وهذه خصوصية ثابتة في القرآن لا تتغير ولا تتبدل على مر الدهور والعصور، وسيأتي أنه كلما ذهب قرن يأتي قرن آخر؛ فيطلعون على معنى جديد للآيات القرآنية ولا يزال الناس على ذلك إلى يوم القيامة، على اعتبار أنه كلما ترقت البشرية في مداركها ومعارفها، كلما كانت أقدر على اكتشاف معارف القرآن، واستكناه أسراره.
وعن أمير المؤمنين >عليه السلام< حول القرآن: >فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون<([63]).
وعنه >عليه السلام<: >لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب<([64]).
وعنهم >عليهم السلام<: >ظاهره أنيق، وباطنه عميق<.
وعنهم >عليهم السلام<: >ظاهره حكم، وباطنه علم<([65])، وما يشير إلى هذا المعنى كثير جداً لا مجال لاستقصائه.
ولعل إلى جميع ذلك يشير ما ورد عن الإمام الصادق وعن الإمام الحسين >عليهما السلام<:
>كتاب الله على أربعة أشياء، على العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق؛ فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء<([66]).
ترجمة القرآن وتفسيره:
ومما تقدم نعرف: أن ترجمة القرآن وتفسيره غير ممكنين لهذا الإنسان المحدود بحدود الزمان والمكان، وغير المحيط بكل العلاقات الكونية، ولا المطَّلع على النواميس الطبيعية، في مختلف المجالات.
نعم، يمكن لمن يتصدى لترجمة القرآن أو لتفسيره أن يقول: هذا ما فهمته من القرآن، بحسب ما توفر لدي من أدوات تساعد على اكتشاف المعاني، من المفردات والهيئات التركيبية، وبحسب مستوى ثقافتي ومعارفي وقدراتي المحدودة بالنسبة إلى الله الذي ليس لعلمه حد.
للقرآن ظهر وبطن:
قد تقدم آنفاً عن أمير المؤمنين >عليه السلام<: لو أردت أن أوقر على الفاتحة سبعين بعيراً لفعلت أو بما معناه، ويظهر صدق قوله هذا مما ذكرناه.
ويمكن بعد هذا: أن نفهم معنى قولهم >عليهم السلام<: إن للقرآن ظهراً وبطناً، أو أكثر، وقد روي هذا المعنى من طرق غير الشيعة أيضاً، وفسر بما يشير إلى ما ذكرناه.
ففي خطبة منسوبة له >صلى الله عليه وآله<: >له ظهر وبطن، فظاهره حكم، وباطنه علم، لا تحصى عجائبه، ولا يشبع منه علماؤه<([67]).
وعنه >صلى الله عليه وآله<: >ما في كتاب الله آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع<([68]).
قال ابن المبارك: >سمعت غير واحد في هذا الحديث:
ما في كتاب الله آية إلا ولها ظهر وبطن، يقول: لها تفسير ظاهر، وتفسير خفي، ولكل حد مطلع، يقول:
يطلع عليه قوم فيستعملونه على تلك المعاني، ثم يذهب ذلك القرن، فيجيء قرن آخر، فيطلعون منها على معنى آخر، فيذهب عليه ما كان عليه من كان قبلهم؛ فلا يزال الناس على ذلك إلى يوم القيامة<([69]).
وعن ابن عباس قال: >إن القرآن ذو شجون، وفنون، وبطون، ومحكم، ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل<([70]).
وعن الحسن البصري: ما أنزل الله عز وجل آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، وكل حد مطلع([71]).
وعن ابن مسعود: >إن القرآن نزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن<([72]).
وأوضح من ذلك في الدلالة على ما ذكرناه، ما نقل عن أبي الدرداء: >لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً كثيرة<([73]).
وقال علي >عليه السلام< لابن عباس، حينما أرسله لحجاج الخوارج: >القرآن حمال ذو وجوه<([74]). وراجع ما يروى عن الإمام أبي جعفر >عليه السلام< حول أن للقرآن ظهراً وبطناً في المصادر المعدة لذلك([75]).
بل قال بعضهم: إن الأخبار تدل على أن >للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين<([76]).
وقد ألفوا كتباً فيما تضمنه القرآن من علم الباطن([77]).
وإذن فلماذا ينسب القول بأن للقرآن بطناً وظهراً إلى الشيعة فقط؟!
ولماذا أيضاً يشنعون على الشيعة إذا تفوهوا بهذا الأمر، أو كتبوه، إذا كانت الروايات الدالة عليه موجودة عند غيرهم، كما هي موجودة عندهم؟!
وإذا كان معنى الظهر والبطن: هو أن يكون ذلك المعنى الذي يزاح عنه الستار مما يمكن للفظ أن يتحمله، وللمتكلم أن يقصده ليكون بالنسبة للبعض بمنزلة البطن لهذا المعنى المكشوف؛ فأي محذور عقلي أو شرعي يحصل من الالتزام بهذا؟!
وليكن للقرآن بطون سبعة أو سبعون، أو أكثر، يكتشفها هذا الإنسان كلما ترقى في مدارج المعرفة، أو يكشفها له الأئمة الراسخون في العلم، الذين أشار إليهم القرآن الكريم.
التقوى تعين على فهم القرآن:
وبعد، فإن من الواضح: أن الطهارة من الذنوب تعين على فهم القرآن، ففي دعاء ختم القرآن عن زين العابدين >عليه السلام< قال: >واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنساً، ومن نزغات الشيطان، وخطرات الوساوس حارساً، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابساً، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرساً، ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجراً، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشراً، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه، وزواجر أمثاله إلخ<([78]).
المحكم والمتشابه:
هذا وقد أشير إلى وجود المحكم والمتشابه في القرآن في قوله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ}([79]).
هذا، مع العلم بأن الله تعالى لا يريد أن ينزل لعباده كتاباً فيه الألغاز والأحاجي، بل هو كما قال تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ}([80]). وقال: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}([81]).
إذن، فلا بد أن يراد بالمتشابه معنى ينسجم مع واقع القرآن وأهدافه، ولعل التأمل فيما قدمناه يسهل علينا فهم المراد منه، ولأجل إيضاح ذلك نقول:
إن المتشابه هو الكلام الذي لا ينبئ ظاهره عن المراد، بل يحتمل من لم يكن راسخاً في العلم فيه وجوهاً من المعاني، التي لا يكون بعضها منسجماً مع أهداف ومبادئ المتكلم، ولكن لو دقق في اللفظ وفي خصوصياته، وجمع بين بعضها البعض لأمكنه إدراك عدم إمكان تحملها لذلك المعنى الفاسد.
ولأجل ذلك، نجد الذين في قلوبهم زيغ يحاولون انتهاز الفرصة للتشبث بهذا النوع من الآيات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وعطف اتجاهه؛ ليلائم أهواءهم، ومن أجل الطعن في القرآن والإسلام {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ}([82])، لأنهم يردون المتشابه إلى المحكم الذي يبين أهداف ومرامي الله تعالى، ويوجه التعبير في المتشابهات ليفيد المعنى المقصود، ويبين بعض ما خفي من وجوهه وخصوصياته.
لا بد من وجود المتشابه في القرآن:
وينقل الرازي: أن من الملاحدة من طعن في القرآن لاشتماله على المتشابه، إذ كيف يكون مرجعاً للناس في كل عصر، مع وفرة دواعي الاختلاف فيه؛ حيث يجد كل صاحب مذهب فيه مأربه؛ فإن هذا لا يصدر عن الحكيم([83]).
ولعل ما ذكرناه فيما تقدم يكفي في الإجابة عن هذه الترهات. ونزيد هنا ما ذكره العلامة الطباطبائي، فإنه قال ما حاصله:
إنه كان لا محيص عن وقوع التشابه في القرآن، لأنه كان يجري في تعابيره الرقيقة مع أساليب القوم، مع سمو معناه، وعمق مغزاه، في مقابل انحطاطهم في المستوى الفكري والثقافي.
وقد جاء القرآن بمفاهيم جديدة، كانت غريبة عن نوعية أفكار ومفاهيم المجتمع البشري آنذاك، ولا سيما في جزيرة العرب، البعيدة عن الثقافة والمعرفة، في حين التزامه في التعبير عن تلك المقاصد العالية بنفس الأساليب التي كانت معروفة في ذلك العهد، الأمر الذي ضاق بتلك الألفاظ التي كانت موضوعة للتعبير عن معانٍ محسوسة، أو قريبة من الحس، ومحدودة في نطاق ضيق، تتناسب مع ذهنية العربي وثقافته والتعبير عن معانٍ مبتذلة ـ لقد ضاق الأمر بتلك الألفاظ ـ عن أن تحيط بتلك المفاهيم الرحبة الآفاق، البعيدة الأغوار، وجاء استعمال تلك الألفاظ للتعبير عن هذه المقاصد العالية غريباً عن المألوف العام، وعن ذهنية الإنسان العادي.
ومن ثم، فقد قصرت أفهامهم عن إدراك حقائقها ودقائقها، ولا سيما حين رأوا:
أن القرآن يستعمل في التعبير عن مقاصده صنوف المجاز، والاستعارات، والتشبيهات، والكنايات، ودقائق الإشارات، واستعمل مختلف خصائص اللغة العربية، سواء منها ما يتعلق بالمفردات، أو بالهيئات التركيبية؛ ليمكن إخضاع تلك المعاني السامية للقوالب اللفظية المحدودة والمألوفة.
وكان ذلك سبباً في تقريب تلك المعاني إلى أفهام العامة، من حيث أنه أخضعها للقوالب اللفظية، المأنوسة والمألوفة لديهم، وسبباً في بعدها، من حيث عدم قدرة تلك القوالب اللفظية على استيعاب معانٍ لم تكن هي مستعدة للتعبير عن مثلها([84])، إلا بالتوسل بلطائف الإشارات والكنايات، ودقائق الخصائص اللفظية للتعبير عنها، حسبما أشرنا إليه من قبل، فصعب على الإنسان العادي إدراك تلك المقاصد العالية، واشتبه عليه الأمر؛ فكان لا بد له من الاستعانة بالراسخين في العلم، الذين اختصهم الله بفضله وكرمه لإيضاح مقاصده وأهدافه ومراميه، ممن كانوا على مستوى رفيع من عمق الفهم، وسلامة التفكير، ونفذت بصيرتهم إلى الحقائق الراهنة، فنالوها، وهم أئمة أهل البيت الأطهار >عليهم السلام<.
الـتـأويـل:
لقد أشير إلى التأويل في القرآن الكريم، وأن ثمة من يعرف هذا التأويل، وهم الراسخون في العلم، وإن كانوا يعترفون بعجزهم عن إدراك كل الملابسات التي يمكن أن تكتنف هذا المعنى المقصود، إلا إذا أوقفهم الله تعالى على ذلك.
قال تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا}([85]).
وقد رأينا: أن بعض الفئات الضالة تحاول الاستفادة من موضوع التأويل بما يخدم أهدافها الهدامة، ومذاهبها الضالة، فجاؤوا بالتأويلات التي تضحك الثكلى، حتى إنك لتجد بعض الأحزاب المنحرفة من الذين يعتنقون الماركسية، ويتظاهرون بالإسلام، يحاولون تفسير الإسلام والقرآن بحيث ينسجم مع الماركسية التي تناقضه أساساً، فيقولون ـ مثلاً ـ في قوله تعالى: {قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّاً وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ}([86]).
ـ يقولون ـ : إن المراد بهذا اليوم ليس هو يوم القيامة، وإنما المراد به اليوم الذي تتحقق فيه الاشتراكية، ويزول النظام الطبقي، وتنتفي فيه الملكية الشخصية([87]).
بل قالوا: إن المقصود بالمعاد في الإسلام والقرآن، هو القضاء على النظام الطبقي في المجتمع ليس إلا، إلى غير ذلك من ترهاتٍ بعيدة عن روح الإسلام والقرآن، جاء بها هؤلاء وغيرهم من الفئات الضالة.
والحقيقة هي: أن هذا ليس هو التأويل الذي أشار إليه القرآن، وإنما هو التفسير بالرأي الذي ورد النهي عنه بشدة من قبل المعصومين >عليهم السلام<، وهذا بعينه هو اتباع ما تشابه من القرآن، ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله.
أما التأويل الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، الذين هم أهل البيت >عليهم السلام<، حسب نص الروايات([88])، فهو معرفة ما يؤول إليه الأمر، بحسب ما تضمنه الكلام من إشارات ودلالات؛ كقوله: {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ}([89]).
وبعبارة أخرى: التأويل هو الكشف عن المرامي والمعاني التي يشير إليها اللفظ، بما له من خصوصيات في مفرداته، وهيئاته التركيبية، وبعد مقايسته بغيره وملاحظة مدى انسجام ذلك المعنى مع مبادئ وأهداف المتكلم نفسه.
وإذا ما أريد الوصول إلى واقع المعنى من الآيات القرآنية بما له من خصوصيات وأحوال؛ فلا بد من الرجوع إلى من يتمكن بما أوتي من معارف وعلوم، حتى أصبح من الراسخين في العلم، للكشف عن المعاني القرآنية الدقيقة، التي يخفى على غير الراسخين كيفية تحمل اللفظ لها، وإن كان بالنسبة إليهم ربما يكون من البديهات، فيرجعون ذلك المتشابه إلى ذلك المحكم.
ومن هنا تبرز الحاجة المستمرة إلى هؤلاء الراسخين في العلم، الذين ورد في الروايات أنهم ـ بالذات ـ أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالتأويل هو الكشف عما تؤول إليه المعاني، بواسطة معرفة سائر خصوصياتها ومراميها.
الحروف المقطعة في القرآن:
وقد كثر الحديث عن الحروف المقطعة الواردة في فواتح السور القرآنية، وتعددت وتشعبت الأقوال في ذلك، حتى عد المفسرون ما يقرب من عشرين قولاً حول المراد منها، نذكر منها ما يلي:
1 ـ هي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه.
2 ـ هي أسماء للسور التي وقعت في أوائلها.
3 ـ إنها أسماء لمجموع القرآن.
4 ـ إنها أسماء لله سبحانه ف >ألم< معناها: أنا الله العالم و >ألمر< معناها: أنا الله أعلم وأرى. وهكذا.
5 ـ إنهـا أسـماء لله مقطعة لـو أحسن تأليفهـا لعلم اسم الله الأعظم، ف (ألر، وحم، ون). تصير: الرحمن. وهكذا.
6 ـ إن هذه الحروف شريفة لكونها مباني كتبه المنزلة وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأصول لغات الأمم.. وقد أقسم الله تعالى بهذه الحروف.
7 ـ إنها إشارات إلى آلائه سبحانه، وبلائه، ومدة الأقوام وأعمارهم وآجالهم! ([90]).
8 ـ إنها إشارة إلى بقاء هذه الأمة بحسب حساب الجمل.
9 ـ إنها تسكيت للكفار الذين تواصوا فيما بينهم أن: {لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيه}([91])؛ فكانوا إذا سمعوا هذه الحروف استغربوها، وتفكروا فيها، فيقرع القرآن مسامعهم.
10 ـ إنها للإشارة إلى معانٍ في السورة؛ فكلمة >ن< إشارة إلى ما تشتمل عليه السورة من النصر المـوعود وكلمة >ق< إشارة إلى القرآن، أو إلى القهر([92]).
إلى غير ذلك من أقوال لا مجال لتتبعها.
ولعل آخر ما يمكن أن يعتبر رأياً في هذا المجال.. هو ما ذكره بعض المتأخرين، واعتبر بمثابة >إعجاز مدهش جديد للقرآن الكريم يكتشفه عالم مصري<، وهو: أن هذه الحروف المقطعة تدخل كعنصر هام وحاسم في موضوع الإعجاز العددي للقرآن..
ونحن لا نريد أن نسيء الظن فيما يتعلق بهذا الرأي، على اعتبار أنه يعتمد الرقم (19)، ويتخذه محوراً في مجمل استنتاجاته، وهو الرقم المقدس عند طائفة البهائية الضالة..
كما أننا لا نريد المبالغة في التشاؤم إلى حد أن نعتبر أن ذلك يهدف إلى صرف الأنظار عن دقائق المعاني القرآنية الباهرة إلى الاهتمام بالظواهر والقوالب اللفظية.
لا.. لا نريد ذلك.. فإننا نأمل أن يكون ثمة قدر كبير من حسن النية، وسمو الهدف.
وإنما نريد أن نؤكد على أن بعض الباحثين([93]) قد تتبع هذه النظرية بالبحث والتمحيص، حتى خرج بنتيجة حاسمة، مفادها: الجزم بخطأ هذه النظرية، وذلك لعدم صحة الأرقام التي قدمتها، واعتبرتها أساساً صالحاً للتدليل على قيمتها العلمية، فقد قال هذا المحقق الذي رمز لنفسه ب >أبو محمد<: قولهم: كلمة >اسم< تتكرر 19 مرة بالضبط.
أقول: ذكر في المعجم المفهرس عدد 19 تحت كلمة اسم وذكر أن كلمة >بسم< تكررت ثلاث مرات في قوله تعالى: {بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا}([94])، {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}([95]). و {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ}([96]).
وذكر كلمة >اسمه<.
وقال: إنها تكررت خمس مرات.
وقولهم: إن كلمة >الرحيم< تتكرر 114 مرة نقول: بل تتكرر 115 مرة بالضبط.
وقالوا: إن حرف >ن< قد تكرر في سورة القلم 133 أي أنه حاصل 19 ضرب 7.
ونقول: بل يتكرر 129 مرة فقط، ولو كررنا المشددات مثل أن فإن المجموع يصير أكثر من ذلك بكثير.
وقالوا: إن حرف >ص< يتكرر في كل من: سورة الأعراف التي أولها >ألمص< وسورة >ص<، وسورة >مريم< التي أولها >كهيعص< 153 أي أنه حاصل 19 ضرب 8.
ونقول: إن عدد الصادات في سورة الأعراف هو 90 صاداً، ولعله قد اشتبه علي واحد أو اثنان، وفي سورة >مريم< 24 >كذلك< وفي سورة >ص< 27 مرة فليس المجموع153 ولا في كل واحدة منها 153 أيضاً([97]).
أما العلامة الطباطبائي قدس سره، فقد أورد على الأقوال التي سلفت باستثناء هذا الأخير، حيث لم يذكره >قدس سره< .. بأن:
دعوى كون الحروف المقطعة من المتشابهات لا يصح، وذلك لأن التشابه من صفات الآيات التي لها دلالة لفظية على مداليلها، وليست الحروف المقطعة من هذا القبيل.
وأما سائر الأقوال، فإنما هي تصويرات لا تتعدى الاحتمال، ولا دليل يدل على شيء منها، وأما الروايات التي ربما يستظهر منها بعض التأييد لبعض تلك الأقوال، فقد ردها >رحمه الله< بضعف السند تارة ولضعف الدلالة أخرى، حيث لا يوجد فيها تقرير من النبي >صلى الله عليه وآله< لما فهمه الآخرون منها أو لأن مفاد الرواية أن هذه الحروف من قبيل الرمز لمعانٍ تكرر بيانها، ولا حاجة لاستعمال الرمز في التعبير عنها.
ثم استظهر >رحمه الله<: أن هذه الحروف هي رمز بين الله سبحانه وبين رسوله، خفي عنا، لا سبيل لأفهامنا العادية إليها إلا بمقدار أن نستشعر أن بينها وبين المضامين المودعة في السور ارتباطاً خاصاً، حيث وجد >رحمه الله< تشابهاً في سياق وفي مضامين السور التي اشتركت حروف معينة في فواتحها، كالطواسين والحواميم، والميمات والراءات ونحو ذلك.
ونقول:
إننا لا نستطيع الموافقة على ما ذكره رحمه الله تعالى، فإن القرآن ليس كتاب ألغاز، أو أحاجٍ، وإنما أنزله الله تعالى:
{هُدىً لِّلنَّاسِ}([98]).
{لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ}([99]).
{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ}([100]).
{قُرْآناً عَرَبِيَّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}([101]).
{كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيَّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}([102]).
وقد لاحظ بعض المحققين: أن تعقيب هذه الأحرف بأن هذا الكتاب >مبين< وواضح، و >أنه قرآن عربي لقوم يعلمون<، أو >لعلكم تعقلون< لا يناسب كون تلك الألفاظ رموزاً، أو من قبيل الألغاز والأحاجي، قال تعالى في سورة يوسف:
{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}([103]).
ومهما يكن من أمر، فإن لدينا من الشواهد والدلائل ما يكفي لإعطاء فكرة عن المراد من هذه الحروف، ونستطيع بيان ذلك في ضمن النقاط التالية:
1 ـ إننا في نفس الوقت الذي نعتبر فيه أن ما سنذهب إليه ليس هو المقصود النهائي من هذه الأحرف، فإننا نؤكد على أننا لا نستبعد إرادة سائر المعاني، مما ذكر أو لم يذكر منها، إذا دلَّ الدليل على إرادتها أيضاً، فإن للقرآن ظهراً وبطناً، ولعل لاختلاف الأزمنة، وتقدم الفكر والعلم، تأثيراً في فهم الكثير من المعاني الأخرى، التي يمكن أن تكون هذه الأحرف مشيرة إليها، أو دالة عليها، بنحو من أنحاء الإشارة والدلالة.
2 ـ إننا نلاحظ: أننا لم نجد في التاريخ ما يشير إلى أن أياً من الصحابة أو من غيرهم من المشركين أو من أعداء الإسلام قد تصدى للسؤال أو الاستفهام عن معاني هذه الأحرف، وعما ترمي إليه..
ولو سلمنا جدلاً أن سكوت الصحابة يمكن أن يكون ناشئاً عن إيمانهم العميق، وعن وصولهم إلى درجة التسليم والخضوع لكل ما يأتي به النبي >صلى الله عليه وآله< نتيجة لما رأوه من الآيات الباهرة، والمعجزات القاهرة ـ رغم أن ذلك لا ينطبق على كثيرين غيرهم.. ورغم عدم منافاة ذلك للسؤال الاستفهامي عن أمر كهذا ـ فإننا لا نستطيع أن نفسر سكوت المشركين وغيرهم من أعداء الإسلام عن أمر كهذا، وهم في موقع التحدي والمجابهة، ويحاولون التشبث ولو بالطحلب للطعن في الإسلام والنبوة والقرآن، فسكوتهم هذا ـ والحالة هذه ـ لا يعني إلا أنهم قد فهموا منها معنى قريباً إلى أذهانهم، وأن ذلك المعنى الذي فهموه كان يكفي للإجابة عما يمكن أن يراود أذهانهم من تساؤلات..
3 ـ إننا نجد: أن هذه الحروف قد وردت في تسع وعشرين سورة، ستة وعشرون منها نزلت في مكة، وثلاث منها نزلت في المدينة.
وحتى هذه السور التي نزلت في المدينة يلاحظ: أن اثنتين منها قد نزلتا في أوائل الهجرة، حيث كان الوضع الديني والإيماني فيها لا يختلف كثيراً عنه في مكة، ولا سيما مع وجود اليهود وشبهاتهم ومؤامراتهم إلى جانب المشركين فيها.
وواحدة منها وهي سورة الرعد قد نزلت بعد أن كثر الداخلون في الإسلام رغباً أو رهباً، وكثر المنافقون حتى ليرجع ابن أبي بثلث الجيش في غزوة أحد..
وأصبح اليهود وغيرهم ممن وترهم الإسلام يهتمون بالكيد للإسلام من الداخل، بعد أن عجزوا عن مقاومته عسكرياً وفكرياً، وعقائدياً بشكل سافر..
فجاءت سورة الرعد لتكرر التحدي بهذه المعجزة: القرآن، كأسلوب أمثل لبعث عمق عقيدي وإيماني جديد في المسلمين، ومواجهة غيرهم بالواقع الذي لا يجدون لمواجهته سبيلاً إلا بالتسليم والبخوع والانقياد له.
وهذا ما يفسر لنا السر في أننا نجد أسلوب وأجواء سورة الرعد لا تختلف كثيراً عن أجواء وأسلوب غيرها من السور المكية، وأن هنالك توافقاً فيما بينها في إدانة وضرب كل أساليب التضليل أو التزوير، والصدود عن الحق..
ونستطيع بعد كل ما تقدم أن نصل إلى النتيجة التالية، وهي:
أن ورود هذه الحروف في خصوص السور المكية، وفي ثلاث سور نزلت في أجواء لا تخلتف كثيراً عن أجواء مكة ليدل دلالة قاطعة على أنها إنما جاءت في مقام التحدي للمشركين، ولأعداء الإسلام.. وأن عدم اعتراض هؤلاء، أو حتى عدم سؤالهم، وكذلك عدم سؤال أي من الصحابة المؤمنين عن معاني هذه الحروف إنما يشير إلى أنهم إنما فهموا منها معانيَ قريبة إلى أذهانهم، كافية للإجابة على ما ربما يختلج في نفوسهم من أسئلة حولها.
وليس ذلك إلا ما ذكرنا من التحدي بهذا القرآن، المركب من أمثال هذه الحروف التي هي تحت اختيار الجميع، مع أنه يعجز عن مجاراته والإتيان بمثله وحتى بسورة من مثله.
4 ـ إننا إذا راجعنا الآيات التي وقعت بعد هذه الحروف، فإننا نجد:
ألف: أن جميع السور التي وقعت الحروف المقطعة في فواتحها باستثناء سورتين أو ثلاث نجد الآيات التي وقعت بعد هذه الحروف تتحدث عن الكتاب وآياته، أو القلم أو القرآن، ونحو ذلك كقوله تعالى:
{المص، كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ} [الأعراف].
{الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم].
{حم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الزخرف].
{الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود].
{حم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ} [الدخان].
{ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} [ص].
{ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [القلم].
وحتى تلك السور الاثنتان أو الثلاث فإنه يمكن أن يكون في تلك القصة، أو الإخبارات الغيبية أو الحِكم التي تذكر بعد هذه الحروف، من الإعجاز ما يكفي لأن يجعل تركيبها من أمثال تلك الحروف المذكورة، وعجز الالجن والإنس عن الإتيان بمثلها كافياً عن التصريح في ذلك..
ب: إننا نجد أن الآيات التي وقعت بعد الأحرف المقطعة قد صُدّرت باسم الإشارة ليكون خبراً عن الحروف المقطعة، لأنه إشارة لما قبله.
ولا يصح أن يكون إشارة لما بعده لأن ما بعده ليس الألف ليكون بدلاً أو عطف بيان له.. وذلك مثل قوله تعالى:
{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [يوسف].
{الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ} [الحجر].
{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الحَكِيمِ} [يونس].
وكذلك الحال بالنسبة لسورة الرعد، والحجر وغيرهما من السور.
أما مثل قوله تعالى: {الم ذَلِكَ الْكِتَابُ} [البقرة] فالكتاب بدل أو عطف بيان.
ج: ما هو من قبيل قوله تعالى:
{حم، تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [فصلت]. فإن قوله تنزيل خبر لقوله: {حم} كما قاله الفراء، وكما هو الظاهر..
وجعل كتاب خبراً لتنزيل، لا يستسيغه الذوق السليم، ولا ينسجم مع المعنى المقصود، ولاسيما مع تنوين كلمة تنزيل وتنكيرها، وكذلك الحال في قوله تعالى:
{الم، تَنزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} [السجدة].
{حم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [المؤمن/ غافر].
وكذا الحال فيما ورد في أول سورة الجاثية والأحقاف..
وقد أعرب المفسرون وغيرهم هذه الموارد على أن كلمة >تَنزِيلُ< خبر لمبتدأ محذوف، أو نحو ذلك مع أن إعرابها على النحو الذي ذكرناه هو الأنسب والأظهر، وإن كان إعرابهم لا ينافي ما ذكرناه أيضاً، فإن تقدير كلمة >هو<، أو كلمة: >هذا< المقدرة مبتدأ ظاهرها الإشارة إلى ما قبلها أيضاً..
د: قوله تعالى:
{حم، عسق، كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الشورى].
فإن قوله: >كَذَلِكَ< يشار بها في القرآن عادة إلى ما قبلها، أي كتلك الحروف التي سبقت يوحي إليك الله تعالى، أي إن آيات الله هي من جنس هذه الأحرف.
هـ: وبعد، فلقد جاء في رواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: كذبت قريش واليهود بالقرآن، وقالوا: سحر مبين تَقَوَّلَه.
فقال الله: {الم ذَلِكَ الْكِتَابُ} أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو الحروف المقطعة التي منها >ألف، لام، ميم< وهو بلغتكم وحروف هجائكم، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم.
ثم بين أنهم لا يقدرون عليه بقوله:
{قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً}([104])<([105]).
وضعف هذه الرواية لا يضر ما دامت مؤيدة بما قدمناه من الشواهد والدلائل..
هذا على الرغم من أننا نجد في كلام المجلسي ما يشير إلى إمكان الاعتماد على روايات تفسير العسكري.. مع أننا لا نجد ما يبرر الوضع والجعل في أمر كهذا..
آخر ما نقوله حول الحروف المقطعة:
وأخيراً.. فإنه يمكن أن تكون في القصة التي تذكر بعد هذه الحروف المقطعة، أو في الحِكم، أو التنبؤات من الإعجاز ما يكفي لأن يجعل تركبها من الحروف المذكورة في بداية السورة، وعجز الغير عن الإتيان بمثلها كافياً في ذلك.
ومع كل ما قدمناه، فإننا نعود ونؤكد على أن ما ذكرناه ليس هو كل المراد من هذه الحروف، فقد تكون لها إشارات ومرامٍ أخرى تضاف إلى ما ذكرناه، ولا مانع من صحة كثير من الاحتمالات التي ذكرت في معانيها، ولربما يكون لاختلاف الأزمنة تأثير في فهم هذه المعاني، كما أشرنا إليه حين الكلام حول أن للقرآن ظهراً وبطناً.
([1]) راجع في ذلك كلاً أو بعضاً: سيرة مغلطاي ص14، والسيرة الحلبية ج1 ص224، وتاريخ الطبري ج2 ص42 و 43، والبداية والنهاية ج3 ص4، وفي الطبري ج2 ص42 رواية تفيد: أن عمره >صلى الله عليه وآله< كان حينئذٍ عشرين سنة، وهي رواية لا يرتاب أحد في بطلانها وراجع مشاهير علماء الأمصار ص3.
([2]) البحار ج18 ص177 و194 عن إكمال الـديـن ص197 والتمهيد في علـوم = = القرآن ج1 ص81 ـ 82 وراجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص19 وسيرة ابن هشام ج1 ص280، والمناقب لابن شهر آشوب ج1 ص43.
([3]) راجع السيرة الحلبية ج1 ص238 عن أبي هريرة، وسيرة مغلطاي ص14 عن كتاب العتقي عن الحسين، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج3 ص362، ومناقب ابن شهر آشوب ج1 ص173 والبحار ج18 ص204 و190.
([4]) راجع: تاريخ الطبري ج2 ص44 وسيرة ابن هشام ج1 ص256، وتاريخ اليعقوبي ج2 ص22 ـ 23 ط صادر والبداية والنهاية ج3 ص6.
([5]) المواهب اللدنية ج1 ص39، وسيرة مغلطاي ص14، وتاريخ اليعقوبي ج2 ص22 والتنبيه والإشراف ص198، ومروج الذهب ج2 ص287، والسيرة الحلبية ج1 ص238.
([6]) الآية الأولى من سورة القدر.
([7]) الآية 185 من سورة البقرة.
([8]) الآية 106 من سورة الإسراء.
([9]) الآية 106 من سورة الإسراء.
([10]) الآية 32 من سورة الفرقان.
([11]) الآية الأولى من سورة المجادلة.
([12]) راجع: تفسير الميزان ج2 ص15.
([13]) راجع: تفسير الميزان ج2 ص18 وتفسير الصافي ج1 المقدمة التاسعة، وتاريخ القرآن للزنجاني ص10.
([14]) راجع: التمهيد في علوم القرآن ج1 ص82 ـ 83 عن الكافي ج2 ص460، وتفسير العياشي ج1 ص80 والاعتقادات للصدوق ص101، والبحار ج18 ص253، = = ومستدرك الحاكم ج2 ص610 والإتقان ج1 ص39 وتفسير شبر ص350، والبداية والنهاية ج3 ص4 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص34.
([15]) التمهيد ج1 ص81 و 83.
([16]) الآية 32 من سورة الفرقان.
([17])الآية 193 من سورة الشعراء.
([18]) الآية 93 من سورة الإسراء.
([19]) الآية 48 من سورة الفرقان.
([20]) هو العلامة السيد مهدي الروحاني رحمه الله.
([21]) تصحيح الإعتقاد ص58.
([22]) الآية 5 من سورة المزمل.
([23]) البحار ج92 ص38.
([24]) التمهيد في علوم القرآن ج1 ص83 ويحتمل أيضاً: أن يكون القرآن قد نزل في شهر رمضان في ليلة القدر دفعة، لكنه لم يؤمر بتبليغه، ثم صار ينزل عليه تدريجاً لأجل التبليغ في المناسبات المقتضية لذلك.
([25]) هو العلامة السيد مهدي الروحاني (رحمه الله)..
([26]) الآية 1 من سورة القدر.
([27]) الآية 185 من سورة البقرة.
([28]) الآيتان 1 و 2 من سورة العلق.
([29]) قد أشار إلى ذلك في: التمهيد في علوم القرآن ج1 ص84.
([30]) التمهيد في علوم القرآن ج1 ص85.
([31]) الآيات 3 ـ 5 من سورة الدخان.
([32]) الآية 32 من سورة الفرقان.
([33]) الآية 16 من سورة القيامة.
([34]) البحار ج89 ص38.
([35]) مختصر مفيد ج4 ص45.
([36]) الآيتان 1 و 2 من سورة العلق، وراجع تفسير البرهان.
([37]) تفسير البرهان ج1 ص29.
([38]) الدر المنثور ج6 ص368 والإتقان ج1 ص23.
([39]) الدر المنثور ج1 ص24.
([40]) الوسائل ج4 ص732.
([41]) الوسائل ج4 ص733.
([42]) الإتقان ج1 ص24.
([43]) الإتقان ج1 ص23، والبخاري، وغيره والأوائل للطبراني ص43 وستأتي الرواية.
([44]) راجع تفسير الميزان ج2 ص22.
([45]) الآية 23 من سورة البقرة.
([46]) الآية 88 من سورة الإسراء.
([47]) الآية 49 من سورة هود. وليراجع أيضاً الآية 102 من سورة يوسف، والآية 44 من سورة آل عمران وغير ذلك.
([48]) الآيات الأول من سورة الروم.
([49]) راجع: البيان للسيد الخوئي ص81 ـ 84.
([50]) الآية 22 من سورة الحجر.
([51]) الآية 16 من سورة يونس.
([52]) الآية 82 من سورة النساء.
([53]) حيث يجد كل فريق في هذا القرآن ما يناسب فكره وعقليته ويراه معجزاً حقاً، فالإخبارات الغيبية والنظام الكامل الذي أتى به وغير ذلك من أمور لا تخفى مما يمكن لأهل كل لغة أن يدركوها هي من مصاديق البلاغة لهم، وحتى الفصاحة والبلاغة فإن بالإمكان لغير العربي أن يدركها أيضاً بتعلم اللغة العربية ومعرفة سر القرآن أو الاعتماد على النقل القطعي ممن قد اطلع على بعض جوانب إعجاز القرآن.
([54]) الآية 179 من سورة البقرة.
([55]) الآية 15 من سورة الإسراء.
([56]) الإحتجاج ج2 ص41 والبحار ج45 ص296.
([57]) الآية98 من سورة الأنبياء.
([58]) راجع: الكنى والألقاب ج1 ص294.
([59]) الآية 2 من سورة يوسف.
([60]) الآية 3 من سورة فصلت.
([61]) الآيات 193ـ 195 من سورة الشعراء.
([62]) مدينة المعاجز ص116 عن تأويل الآيات الباهرة في الأئمة الطاهرة ومستدرك البحار ج7 ص181 و 180 والبحار ج39 ص84.
([63]) البحار ج92 ص82 عن تفسير القمي ج1 ص4.
([64]) البحار ج92 ص103 عن أسرار الصلاة وص 104 عن الغزالي: أنه >عليه السلام< لو أذن له الله ورسوله لشرح معاني ألف الفاتحة حتى يبلغ أربعين وقراً أو جملاً.
([65]) أصول الكافي ج2 ص438.
([66]) البحار ج92 ص103 و 20 وج 78 ص278 عن كتاب الأربعين، وعن الدرة الباهرة، وجامع الأخبار ص48 ـ 49.
([67]) كنز العمال ج2 ص186، وليراجع ج1 ص337، وحياة الصحابة ج3 ص456 عنه وعن العسكري، وراجع: نور القبس ص268 ـ 269.
([68]) الزهد والرقائق، قسم ما رواه نعيم بن حماد ص23 وفي الهامش عن المشكاة ص27، وراجع: الإتقان ج2 ص184 و 128، والموافقات للشاطبي ج3 ص382 وفي الهامش عن روح المعاني وعن المصابيح. وراجع غرائب القرآن (مطبوع بهامش جامع البيان) ج1 ص23 و21 ولباب التأويل للخازن ج1 ص10 والفائق ج2 ص381 وراجع التراتيب الإدارية ج2 ص176.
([69]) الزهد والرقائق، قسم ما رواه نعيم بن حماد ص23.
([70]) الإتقان ج2 ص185 عن ابن أبي حاتم.
([71]) كنز العمال ج1 ص488 عن أبي عبيد في فضائله، وعن أبي نصر السجزي في الإبانة.
([72]) حلية الأولياء ج1 ص65 والإتقان ج2 ص187، وهامش الموافقات ج3 ص382 عن كتاب المصابيح، ومصابيح السنة ج1 ص176 وفي هامشه عن موارد الظمآن ص440 ـ 441 وعن غيره وجامع البيان ج1 ص9 وكشف الأستار ج3 ص90 ونزل الأبرار ص73 وأسمى المناقب ص82، ومجمع الزوائد ج7 ص152 عن البزار، وأبي يعلى، والطبراني في الأوسط ولم يذكر الهيثمي قول ابن مسعود في علي >عليه السلام< وراجع: الغدير ج7 ص108 عن الحلية ومشكل الآثار ج4 ص172 و182، وترجمة الإمام علي >عليه السلام< من تاريخ ابن عساكر تحقيق المحمودي ج3 ص25 وفي الهامش عن الحلية وفرائد السمطين، والغدير ج7 ص107 ـ 108 وج 2 ص45 عن الحلية وج 3 ص99 و224 عن مفتاح السعادة ج1 ص400.
([73]) المصنف للصنعاني ج11 ص255، والإتقان ج2 ص185 عن ابن سبع في شفاء الصدور، وحلية الأولياء ج1 ص211 والطبقات الكبرى ج2 قسم 2 ص114 والغدير ج3 ص99 وج 2 ص45 عن أبي نعيم وعن مفتاح السعادة ج1 ص100.
([74]) نهج البلاغة ج2 ص150 بشرح عبده قسم الكتب والوصايا رقم 77.
([75]) المحاسن للبرقي ص270 والبحار ج92 ص78 ـ 106 وتفسير العياشي ج1 ص11 وتفسير البرهان ج1 ص19 ـ 21 وتفسير الصافي ج1 ص29 و 31 ومعاني الأخبار ص259 والغدير ج7 ص108 عن ابن مسعود، وميزان الحكمة ج1 ص95.
([76]) كفاية الأصول آخر مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى ووسائل الشيعة للكاظمي ص13.
([77]) التراتيب الإدارية ج2 ص179.
([78]) الصحيفة السجادية ص136 الدعاء عند ختم القرآن.
([79]) الآية 7 من سورة آل عمران.
([80]) الآية 29 من سورة ص.
([81]) الآية 2 من سورة يوسف.
([82]) الآية 83 من سورة النساء.
([83]) تفسير الرازي ج7 ص171.
([84]) راجع: التمهيد في علوم القرآن ج3 ص19 ـ 22 والميزان للعلامة الطباطبائي ج3 ص58 ـ 62 وعن تفسير المنار ج3 ص170 وقد نقلنا كلامهم بتصرف، فليلاحظ ذلك.
([85]) الآية 7 من سورة آل عمران.
([86]) الآية 31 من سورة إبراهيم.
([87) راجع كتاب: توحيد عاشوري(فارسي).
([88]) راجع تفسير نور الثقلين: ج1 ص260 ـ 262، وتفسير البرهان: ج1 ص270.
([89]) الآية 100 من سورة.
([90]) هناك رواية تشير إلى شيء من ذلك أيضاً، فراجع: المحاسن للبرقي ص270 والبحار ج92 ص90.
([91]) الآية 26 من سورة فصلت.
([92]) تفسير الميزان ج18 ص6، 7.
([93]) هو العلامة المحقق السيد مهدي الروحاني.
([94]) الآية 41 من سورة هود.
([95]) الآية 1 من سورة الحمد.
([96]) الآية 30 من سورة النمل.
([97]) راجع مجلة المنطلق اللبنانية سنة 1399 ه العدد الخامس ص82.
([98]) الآية 185 من سورة البقرة.
([99]) الآية 38 من سورة ص.
([100]) الآية 199 من سورة الشعراء.
([101]) الآية 2 من سورة يوسف.
([102]) الآية 3 من سورة فصلت.
([103]) الآيتان 1 و2 من سورة يوسف.
([104]) الآية 88 من سورة الإسراء.
([105]) معاني الأخبار ص22، وتفسير البرهان ج1 ص54 وتفسير نور الثقلين ج1 ص43 والبحار ج92 ص377 وتفسير الميزان ج18 ص16.